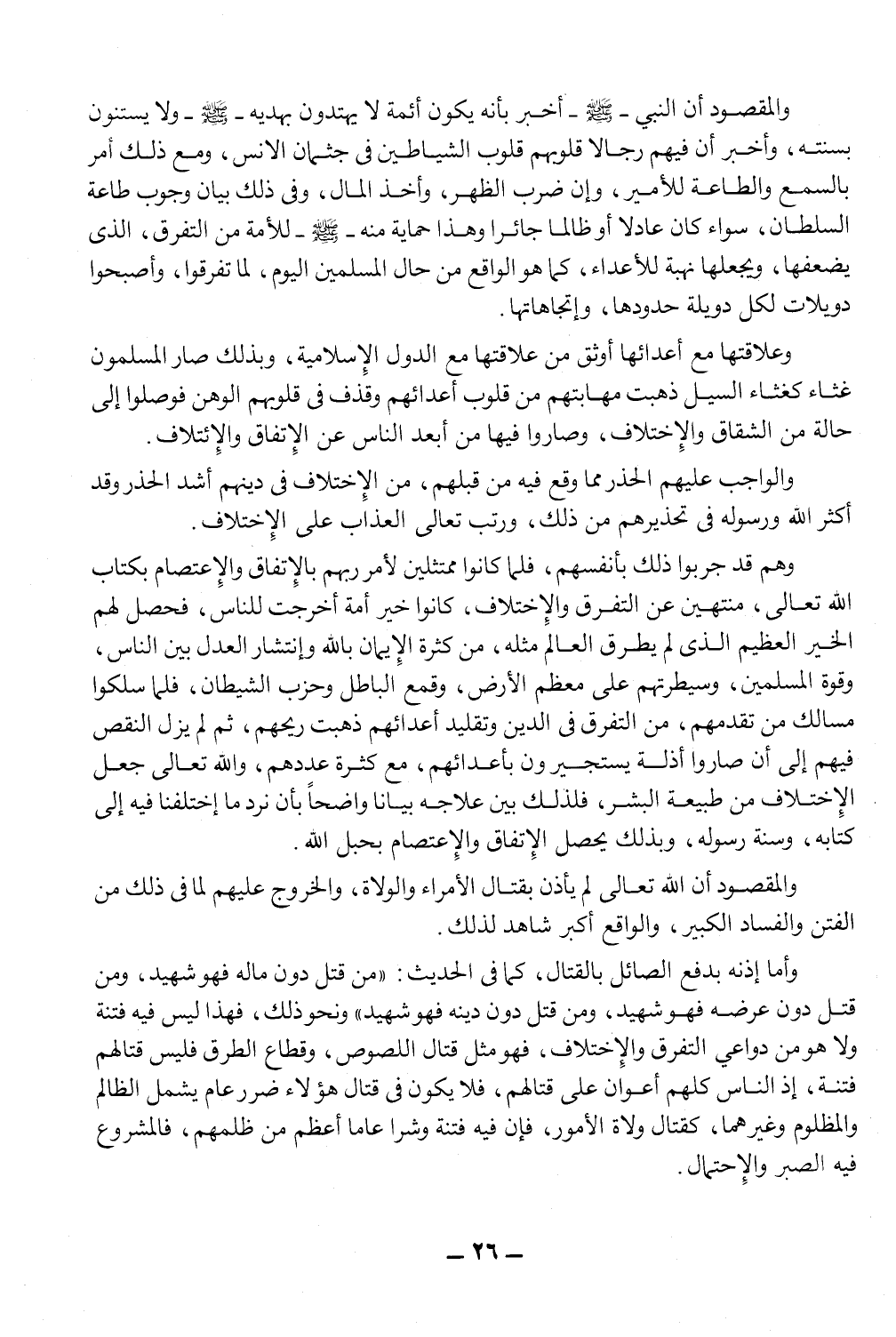
كتاب ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة
والمقصود أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنه يكون أئمة لا يهتدون بهديه- صلى الله عليه وسلم - ولا يستنون بسنته وأخبر أن فيهم رجالا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب الظهر وأخذ المال وفي ذلك بيان وجوب طاعة السلطان، سواء كان عادلا أو ظالما جائرا وهذا حماية منه- صلى الله عليه وسلم - للأمة من التفرق، الذي يضعفها ويجعلها نهبة للأعداء، كما هو الواقع من حال المسلمين اليوم لما تفرقوا وأصبحوا دويلات لكل دويلة حدودها واتجاهاتها.وعلاقتها مع أعدائها أوثق من علاقتها مع الدول الإسلامية، وبذلك صار المسلمون غثاء كغثاء السيل ذهبت مهابتهم من قلوب أعدائهم وقذف في قلوبهم الوهن فوصلوا إلى حالة من الشقاق والاختلاف وصاروا فيها من أبعد الناس عن الاتفاق الائتلاف. والواجب عليهم الحذر مما وقع فيه من قبلهم من الاختلاف في دينهم أشد الحذر وقد أكثر الله ورسوله في تحذيرهم من ذلك ورتب تعالى العذاب على الاختلاف.
وهم قد جربوا ذلك بأنفسهم فلما كانوا ممتثلين لأمر ربهم بالاتفاق والاعتصام بكتاب الله تعالى، منتهين عن التفرق والاختلاف، كانوا خير أمة أخرجت للناس، فحصل لهم الخير العظيم الذي لم يطرق العالم مثله، من كثرة الإيمان بالله وانتشار العدل بين الناس وقوة المسلمين وسيطرتهم على معظم الأرض وقمع الباطل وحزب الشيطان، فلما سلكوا مسالك من تقدمهم من التفرق في الدين وتقليد أعدائهم ذهبت ريحهم، ثم لم يزل النقص فيهم إلى أن صاروا أذلة يستجيرون بأعدائهم، مع كثرة عددهم، والله تعالى جعل الاختلاف من طبيعة البشر فلذلك بين علاجه بيانا واضحاً بأن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتَابه، وسنة رسوله، وبذلك يحصل الاتفاق والاعتصام بحبل الله.
والمقصود أن الله تعالى لم يأذن بقتال الأمراء والولاة، والخروج عليهم لما في ذلك من الفتن والفساد الكبير، والواقع أكبر شاهد لذلك.
وأما إذنه بدفع الصائل بالقتال كما في الحديث: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد" ونحو ذلك، فهذا ليس فيه فتنة ولا هو من دواعي التفرق والاختلاف، فهو مثل قتال اللصوص وقطاع الطرق فليس قتالهم فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على قتالهم، فلا يكون في قتال هؤلاء ضرر عام يشمل الظالم والمظلوم وغيرهما، كقتال ولاة الأمور، فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر والاحتمال.