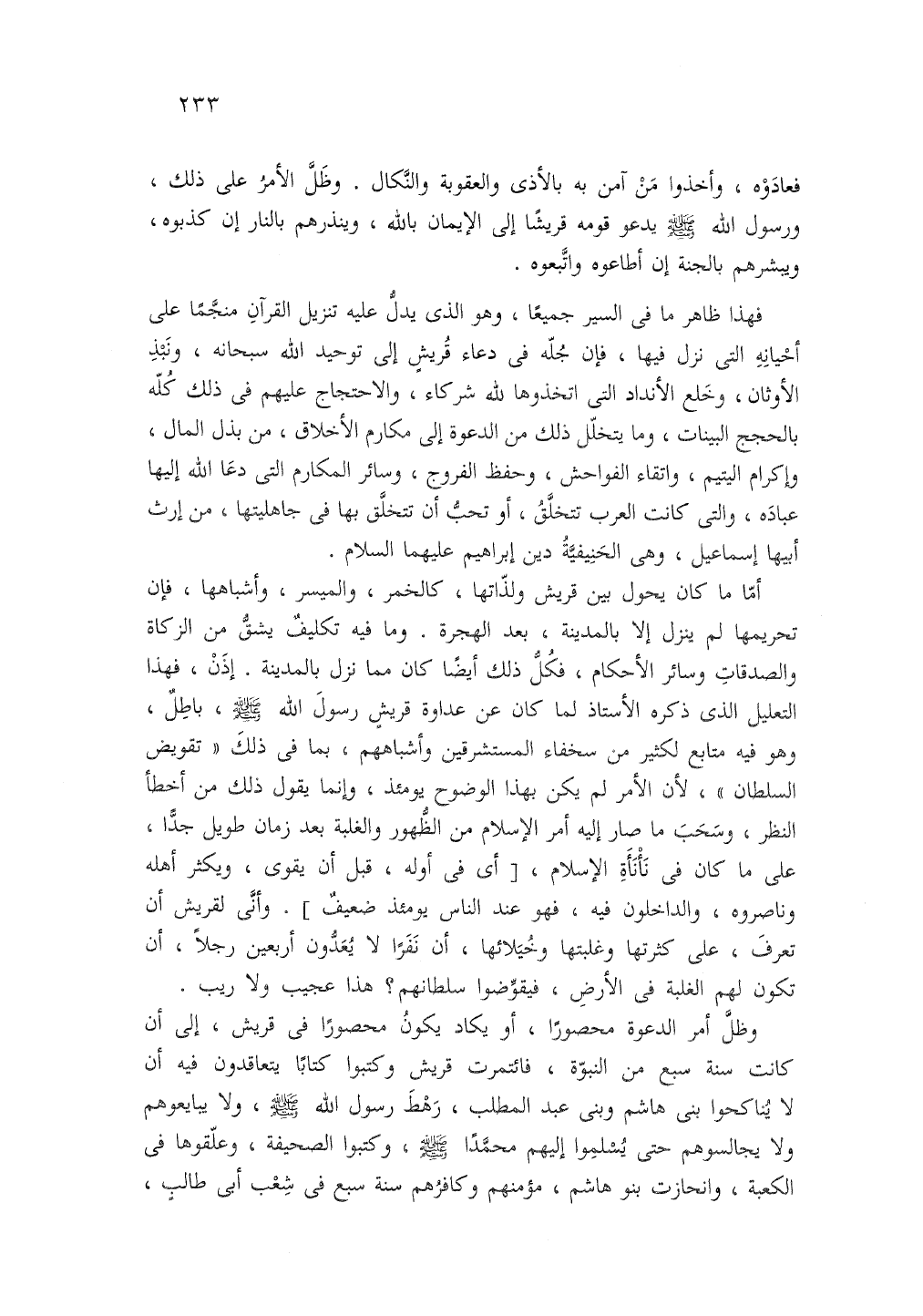
كتاب أباطيل وأسمار (اسم الجزء: 1)
فعادوه وأخذوا من آمن به بالأذى والعقوبة والنكال وظل الأمر على ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه قريشا إلى الإيمان بالله وينذرهم بالنار إن كذبوه ويبشرهم بالجنة إن أطاعوه واتبعوه.فهذا ظاهر ما في السير جميعا وهو الذي يدل عليه تنزيل القرآن منجما على أحيانه التي نزل فيها فإن جله في دعاء قريش إلى توحيد الله سبحانه ونبذ الآوثان وخلع الأنداد التي اتخذوها لله شركاء والاحتجاج عليهم في ذلك كله بالحجج والبينات وما يتخلل ذلك من الدعوة إلى مكارم الاخلاق من بذل المال وإكرام اليتيم واتقاء الفواحش وحفظ الفروج وسائر المكارم التي دعا الله إليها عباده والتى كانت العرب تتخلق أو تحب أن تتخلق بها في جاهليتها من إرث أبيها إسماعيل وهى الحنفية دين إبراهيم عليه السلام.
أما ما كان يحول بين قريش ولذاتها كالخمر والميسر وأشباهها فإن تحريمها لم ينزل إلا بالمدينة بعد الهجرة. وما فيه تكليف يشق من الزكاة والصدقات وسائر الأحكام فكل ذلك أيضا كان مما نزل بالمدينة. إذن فهذا التعليل الذى ذكره الأستاذ لما كان من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل وهو فيه متابع لكثير من سخفاء المستشرقين وأشباههم بما في ذلك تقويض السلطان لأن الأمر لم يكن بهذا الوضوح يومئذ وإنما يقول ذلك من أخطأ النظر وسحب ما صار إليه أمر الإسلام من الظهور والغلبة بعد زمان طويل جدا على ما كان في نأنأة الإسلام أي في أوله قبل أن يقوى ويكثر أهله وناصروه والداخلون فيه فهو عند الناس يومئذ ضعيف وأنى لقريش أن تعرف على كثرتها وغلبتها وخيلائها أن نفرا لا يعدون أربعين رجلا أن تكون لهم الغلبة في الأرض فيقوضوا سلطانهم هذا عجيب ولا ريب.
وظل أمر الدعوة محصورا أو يكاد يكون محصورا في قريش إلى أن كانت سنة سبع من النبوة فائتمرت قريش وكتبوا كتابا يتعاهدون فيه أن لا يناكحوا بنى هاشم وبنى عبد المطلب رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وكتبوا الصحيفة وعلقوها في الكعبة وانحازت بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم سنة سبع في شعب أبى طالب