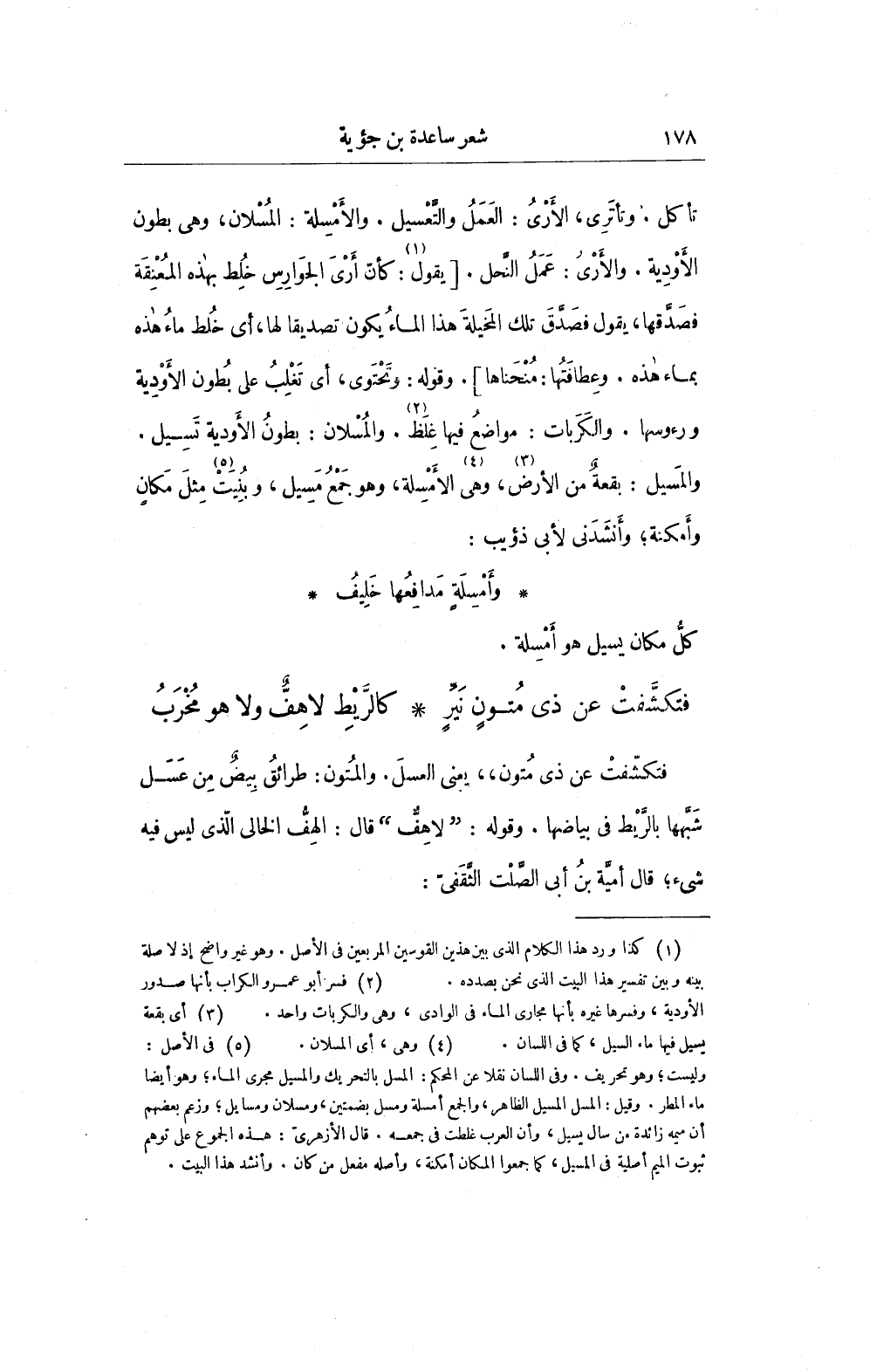
كتاب ديوان الهذليين (اسم الجزء: 1)
تأكل. وتأتَرِي، الأَرْيُ: العَمَلُ والتَّعْسيل. والأَمْسِلة: المُسْلان، وهي بطون الأَوْدِية. والأَرْيُ: عَمَلُ النَّحل. [يقول (¬1): كأنّ أَرْيَ الجوَارِسِ خُلِط بهذه المُعْنِقَة فصَدَّقها، يقول فصَدَّقَ تلك المَخيلةَ هذا الماءُ يكون تصديقا لها، أي خُلط ماءُ هذه بماء هذه. وعِطافَتُها: مُنْحَناها]. وقوله: وتَحْتَوى، أي تَغْلِبُ على بُطون الأَوْدِية ورءوسها. والكَرَبات: مواضعُ فيها غِلَظ (¬2). والمُسْلان: بطونُ الأِودية تَسِيل. والمسَيل: بقعةٌ من الأرض (¬3) , وهي (¬4) الأَمْسِلة، وهو جَمْعُ مَسِيل، وبُنِيتْ (¬5) مثلَ مَكانٍ وأَمكنة؛ وأَنشَدَني لأبي ذؤيب:* وأَمْسِلَةٍ مَدافِعُها خَليفُ *
كلُّ مكان يسيل هو أَمْسِلة.
فتكشَّفتْ عن ذي مُتونٍ نَيِّرٍ ... كالرَّيْطِ لاهِفُّ ولا هو مُخْرَبُ
فكشّفتْ عن ذي مُتون، يعني العسلَ. والمُتون: طرائقُ بِيضٌ مِن عَسَل شَبَّهها بالرَّيط في بياضها. وقوله: "لاهِفٌّ" قال: الهِفُّ الخالي الّذي ليس فيه شيء؛ قال أميَّة بنُ أبي الصَّلْت الثَّقَفىّ:
¬__________
(¬1) كذا ورد هذا الكلام الذي بين هذين القوسين المربعين في الأصل. وهو غير واضح إذ لا صلة بينة وبين تفسير هذا البيت الذي نحن بصدده.
(¬2) فسر أبو عمرو الكراب بأنها صدور الأودية، وفسرها غيره بأنها مجارى الماء في الوادى، وهي والكربات واحد.
(¬3) أي بقعة يسيل فيها ماء السيل، كما في اللسان.
(¬4) وهي، أي المسلان.
(¬5) في الأصل: وليست؛ وهو تحريف. وفي اللسان نقلا عن المحكم: المسل بالتحريك والمسيل مجرى الماء؛ وهو أيضًا ماء المطر. وقيل: المسل المسيل الظاهر، والجمع أمسلة ومسل بضمتين، ومسلان ومسايل؛ وزعم بعضهم أن ميمه زائدة من سال يسيل، وأن العرب غلطت في جمعه. قال الأزهريّ: هذه المجموع على توهم ثبوت الميم أصلية في المسيل، كما جمعوا المكان أمكنة، وأصله مفعل من كان. وأنشد هذا البيت.