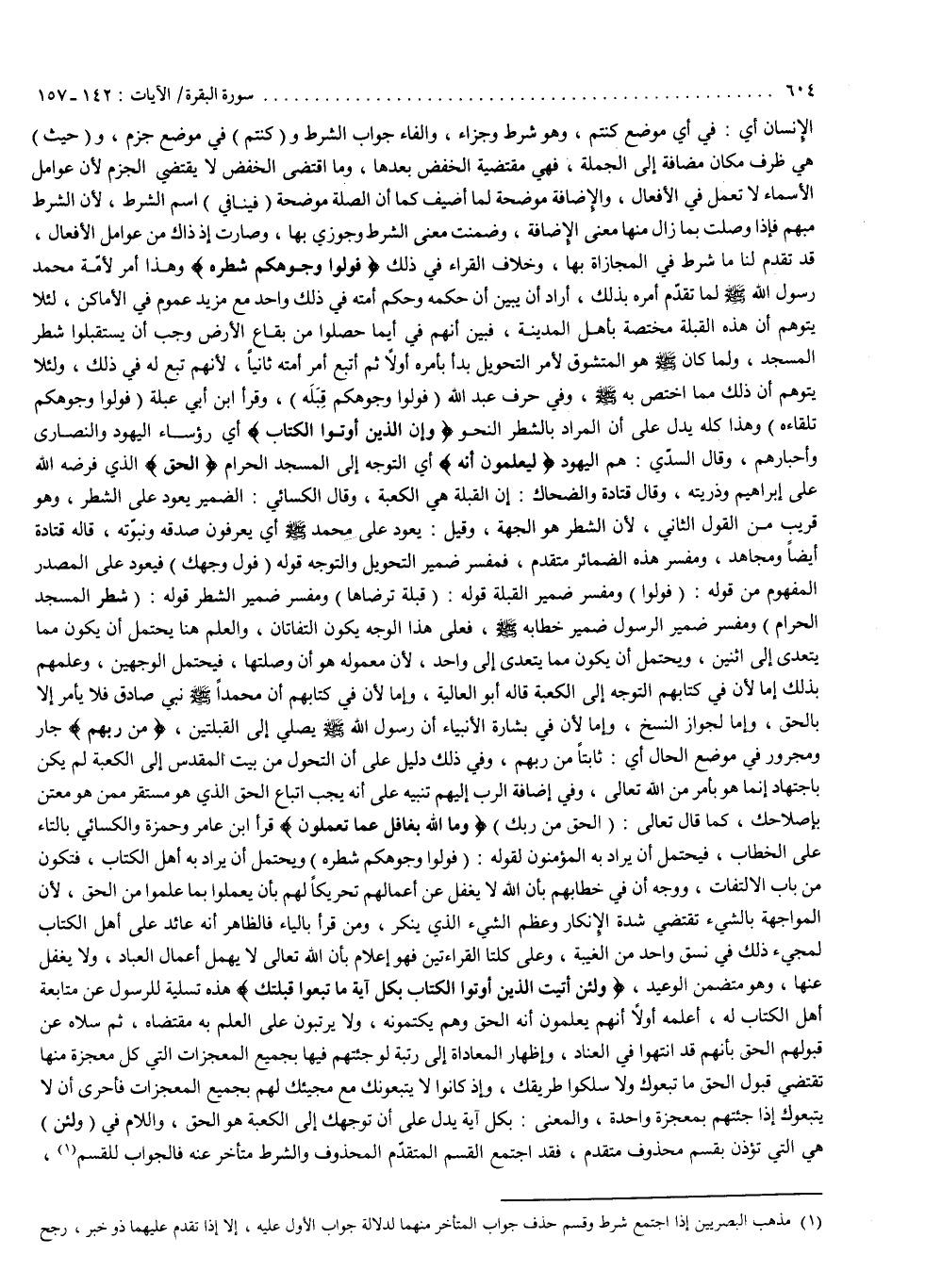
كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 1)
" صفحة رقم 604 "الإنسان ، أي في موضع كنتم ، وهو شرط وجراء ، والفاء جواب الشرط ، وكنتم في موضع جزم . وحيث : هي ظرف مكان مضافة إلى الجملة ، فهي مقتضية ، الخفض بعدها ، وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم ، لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال ، والإضافة موضحة لما أضيف ، كما أن الصلة موضحة فينافي اسم الشرط ، لأن الشرط مبهم . فإذا وصلت بما زال منها معنى الإضافة ، وضمنت معنى الشرط ، وجوزي بها ، وصارت إذ ذاك من عوامل الأفعال . وقد تقدم لنا ما شرط في المجازاة بها ، وخلاف الفراء في ذلك . ) فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ( : وهذا أمر لأمّة محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) ، لما تقدّم أمره بذلك ، أراد أن يبين أن حكمه وحكم أمته في ذلك واحد ، مع مزيد عموم في الأماكن ، لئلا يتوهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة ، فبين أنهم في أيما حصلوا من بقاع الأرض ، وجب أن يستقبلوا شطر المسجد . ولما كان ( صلى الله عليه وسلم ) ) هو المتشوق لأمر التحويل ، بدأ بأمره أولاً ثم أتبع أمر أمته ثانياً لأنهم تبع له في ذلك ، ولئلا يتوهم أن ذلك مما اختص به ( صلى الله عليه وسلم ) ) . وفي حرف عبد الله : فولوا وجوهكم قبله . وقرأ ابن أبي عبلة : فولوا وجوهكم تلقاءه ، وهذا كله يدل على أن المراد بالشطر : النحو . .
( وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ( : أي رؤساء اليهود والنصارى وأحبارهم . وقال السدّي : هم اليهود . ) لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ( : أي التوجه إلى المسجد الحرام ، ( الْحَقّ ( : الذي فرضه الله على إبراهيم وذريته . وقال قتادة والضحاك : إن القبلة هي الكعبة . وقال الكسائي : الضمير يعود على الشطر ، وهو قريب من القول الثاني ، لأن الشطر هو الجهة . وقيل : يعود على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ) ، أي يعرفون صدقه ونبوّته ، قاله قتادة أيضاً ومجاهد . ومفسر هذه الضمائر متقدم . فمفسر ضمير التحويل والتوجه قوله : ) فَوَلّ وَجْهَكَ ( ، فيعود على المصدر المفهوم من قوله : ) فَوَلُّواْ ( ، ومفسر ضمير القبلة قوله : ) قِبْلَةً تَرْضَاهَا ( ، ومفسر ضمير الشطر قوله : ) شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( ، ومفسر ضمير الرسول ضمير خطابه ( صلى الله عليه وسلم ) ) . فعلى هذا الوجه يكون التفاتان . والعلم هنا يحتمل أن يكون مما يتعدى إلى اثنين ، ويحتمل أن يكون مما يتعدى إلى واحد ، لأن معموله هو أن وصلتها ، فيحتمل الوجهين ، وعلمهم بذلك ، إما لأن في كتابهم التوجه إلى الكعبة ، قاله أبو العالية ، وإما لأن في كتابهم أن محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) ) نبي صادق ، فلا يأمر إلا بالحق ، وإما لجواز النسخ ، وإما لأن في بشارة الأنبياء أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) يصلي إلى القبلتين . ) مّن رَّبّهِمُ ( : جار ومجرور في موضع الحال ، أي ثابتاً من ربهم . وفي ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن باجتهاد ، إنما هو بأمر من الله تعالى . وفي إضافة الرب إليهم تنبيه على أنه يجب اتباع الحق الذي هو مستقر ممن هو معتن بإصلاحك ، كما قال تعالى : ) الْحَقُّ مِن رَّبّكَ ).
) وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ( : قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب . فيحتمل أن يراد به المؤمنون لقوله : ) فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ( ، ويحتمل أن يراد به أهل الكتاب ، فتكون من باب الالتفات . ووجهه أن في خطابهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهم ، تحريكاً لهم بأن يعملوا بما علموا من الحق ، لأن المواجهة بالشيء تقتضي شدة الإنكار وعظم الشيء الذي ينكر . ومن قرأ بالياء ، فالظاهر أنه عائد على أهل الكتاب لمجيء ذلك في نسق واحد من الغيبة . وعلى كلتا القراءتين ، فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد ، ولا يغفل عنها ، وهو متضمن الوعيد .
البقرة : ( 145 ) ولئن أتيت الذين . . . . .
( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ بِكُلّ ءايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ( هذه تسلية للرسول عن متابعة أهل الكتاب له . أعلمه أولاً أنهم يعلمون أنه الحق ، وهم يكتمونه ، ولا يرتبون على العلم به مقتضاه . ثم سلاه عن قبولهم الحق ، بأنهم قد انتهوا في العناد وإظهار المعاداة إلى رتبة ، لو جئتهم فيها بجميع المعجزات التي كل معجزة منها تقتضي قبول الحق ، ما تبعوك ولا سلكوا طريقك . وإذا كانوا لا يتبعونك ، مع مجيئك لهم بجميع المعجزات ، فأحرى أن لا يتبعوك إذا جئتهم بمعجزة واحدة . والمعنى : بكل آية يدل على أن توجهك إلى الكعبة هو الحق . واللام في : ولئن ، هي التي تؤذن بقسم محذوف متقدم . فقد اجتمع القسم المتقدّم المحذوف ، والشرط متأخر عنه ، فالجواب للقسم