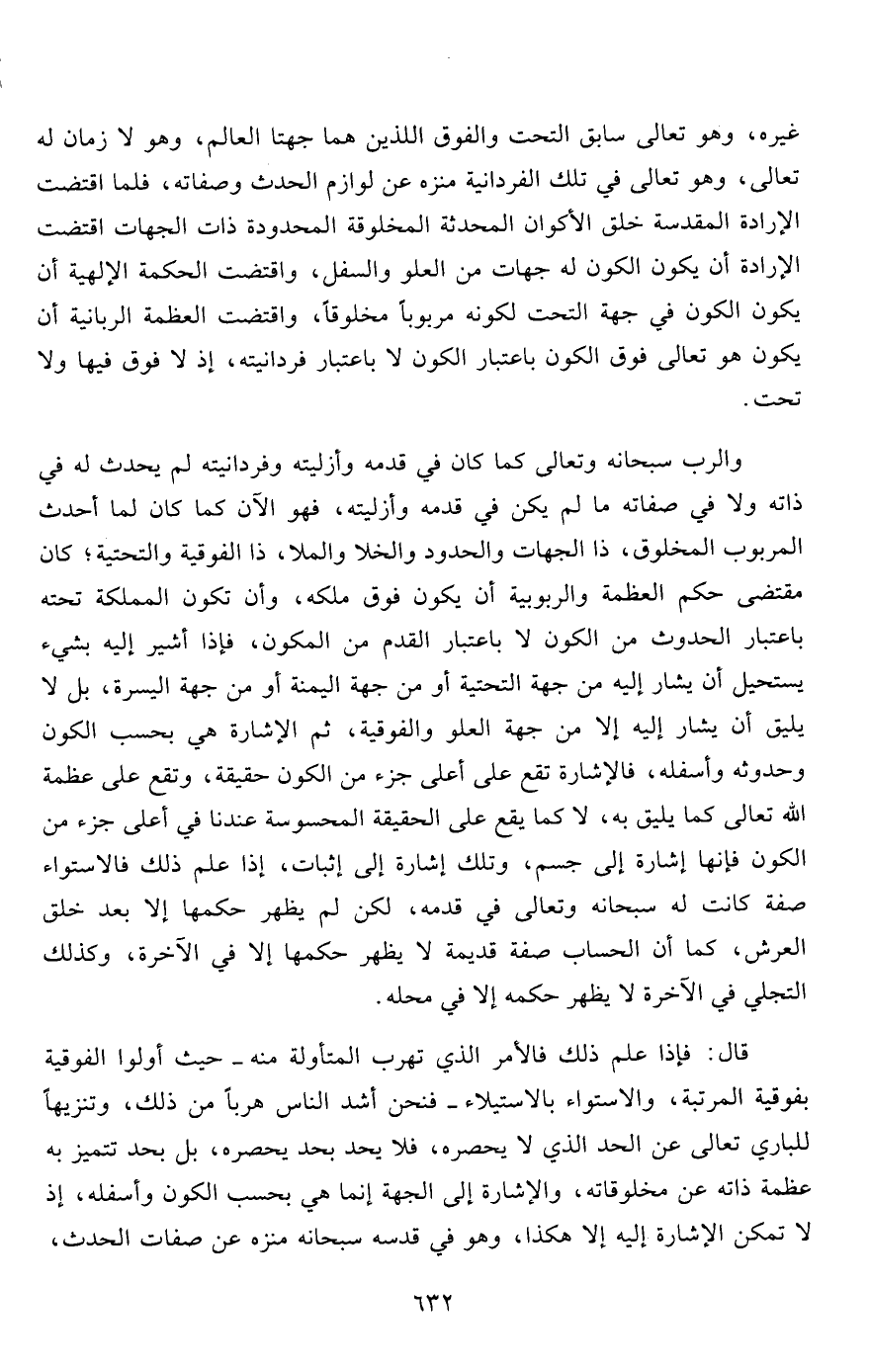
كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني (اسم الجزء: 1)
غيره، وهو تعالى سابق التحت والفوق اللذين هما جهتا العالم، وهو لا زمان له تعالى، وهو تعالى في تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدث وصفاته، فلما اقتضت الإرادة المقدسة خلق الأكوان المحدثة المخلوقة المحدودة ذات الجهات اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل، واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون في جهة التحت لكونه مربوباً مخلوقاً، واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو تعالى فوق الكون باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته، إذ لا فوق فيها ولا والرب سبحانه وتعالى كما كان في قدمه وأزليته وفردانيته لم يحدث له في ذاته ولا في صفاته ما لم يكن في قدمه وأزليته، فهو الآن كما كان لما أحدث المربوب المخلوق، ذا الجهات والحدود والخلا والملا، ذا الفوقية والتحتية؛ كان مقتضى حكم العظمة والربوبية أن يكون فوق ملكه، وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكون لا باعتبار القدم من المكون، فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه من جهة التحتية أو من جهة اليمنة أو من جهة اليسرة، بل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة العلو والفوقية، ثم الإشارة هي بحسب الكون وحدوثه وأسفله، فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة، وتقع على عظمة الله تعالى كما يليق به، لا كما يقع على الحقيقة المحسوسة عندنا في أعلى جزء من الكون فإنها إشارة إلى جسم، وتلك إشارة إلى إثبات، إذا علم ذلك فالاستواء صفة كانت له سبحانه وتعالى في قدمه، لكن لم يظهر حكمها إلا بعد خلق العرش، كما أن الحساب صفة قديمة لا يظهر حكمها إلا في الآخرة، وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محله.قال: فإذا علم ذلك فالأمر الذي تهرب المتأولة منه- حيث أولوا الفوقية بفوقية المرتبة، والاستواء بالاستيلاء- فنحن أشد الناس هرباً من ذلك، وتنزيهاً للباري تعالى عن الحد الذي لا يحصره، فلا يحد بحد يحصره، بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته، والإشارة إلى الجهة إنما هي بحسب الكون وأسفله، إذ لا تمكن الإشارة إليه إلا هكذا، وهو في قدسه سبحانه منزه عن صفات الحدث،