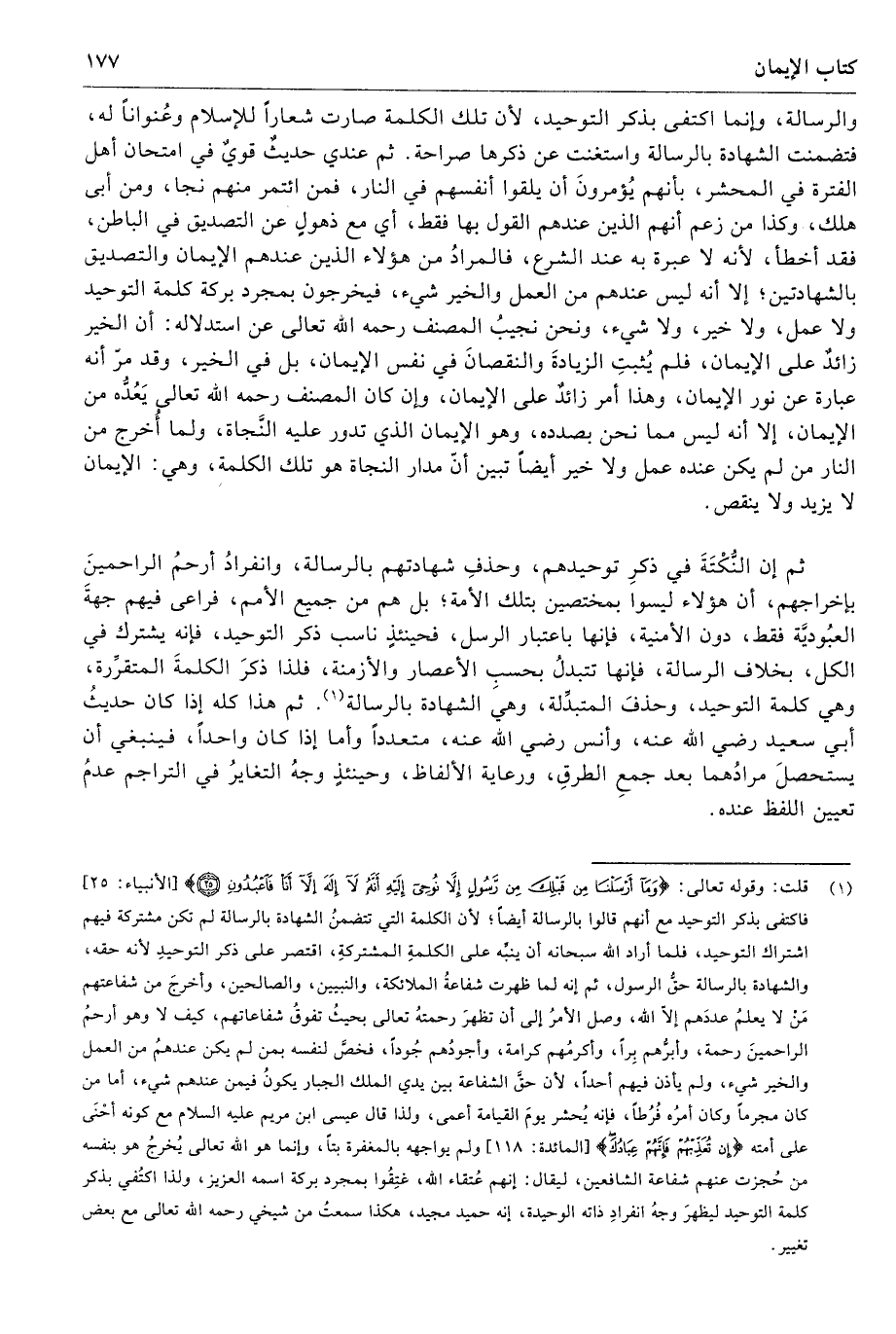
كتاب فيض الباري على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
والرسالة، وإنما اكتفى بذكر التوحيد، لأن تلك الكلمة صارت شعارًا للإسلام وعُنوانًا له، فتضمنت الشهادة بالرسالة واستغنت عن ذكرها صراحة. ثم عندي حديثٌ قويٌ في امتحان أهل الفترة في المحشر، بأنهم يُؤمرونَ أن يلقوا أنفسهم في النار، فمن ائتمر منهم نجا، ومن أبى هلك، وكذا من زعم أنهم الذين عندهم القول بها فقط، أي مع ذهولٍ عن التصديق في الباطن، فقد أخطأ، لأنه لا عبرة به عند الشرع، فالمرادُ من هؤلاء الذين عندهم الإيمان والتصديق بالشهادتين؛ إلا أنه ليس عندهم من العمل والخير شيء، فيخرجون بمجرد بركة كلمة التوحيد ولا عمل، ولا خير، ولا شيء، ونحن نجيبُ المصنف رحمه الله تعالى عن استدلاله: أن الخير زائدٌ على الإيمان، فلم يُثبتُ الزيادةَ والنقصانَ في نفس الإيمان، بل في الخير، وقد مرّ أنه عبارة عن نور الإيمان، وهذا أمر زائدٌ على الإيمان، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى يَعُدُّه من الإيمان، إلا أنه ليس مما نحن بصدده، وهو الإيمان الذي تدور عليه النَّجاة، ولما أُخرج من النار من لم يكن عنده عمل ولا خير أيضًا تبين أنّ مدار النجاة هو تلك الكلمة، وهي: الإيمان لا يزيد ولا ينقص.ثم إن النُّكْتَةَ في ذكرِ توحيدهم، وحذفِ شِهادتهم بالرسالة، وانفرادُ أرحمُ الراحمينَ بإخراجهم، أن هؤلأَ ليسوا بمختصين بتلك الأمة؛ بل هم من جميع الأمم، فراعى فيهم جهةَ العبُوديَّة فقط، دون الأممية، فإنها باعتبار الرسل، فحينئذٍ ناسب ذكر التوحيد، فإنه يشترك في الكل، بخلاف الرسالة، فإنها تتبدلُ بحسبِ الأعصار والأزمنة، فلذا ذكرَ الكلمةَ المتقرِّرة، وهي كلمة التوحيد، وحذفَ المتبدِّلة، وهي الشهادة بالرسالة (¬1). ثم هذا كله إذا كان حديثُ أبي سعيد رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه، متعددًا وأما إذا كان واحدًا، فينبغي أن يستحصلَ مرادُهما بعد جمعِ الطرقِ، ورعاية الألفاظ، وحينئذٍ وجهُ التغايرُ في التراجم عدمُ تعيين اللفظ عنده.
¬__________
(¬1) قلت: وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} [الأنبياء: 25] فاكتفى بذكر التوحيد مع أنهم قالوا بالرسالة أيضًا. لأن الكلمة التي تتضمنُ الشهادة بالرسالة لم تكن مشتركة فيهم اشتراك التوحيد، فلما أراد الله سبحانه أن ينبِّه على الكلمةِ المشتركةِ، اقتصر على ذكر التوحيدِ لأنه حقه، والشهادة بالرسالة حقُّ الرسول، ثم إنه لما ظهرت شفاعةُ الملائكة، والنبيين، والصالحين، وأخرجَ من شفاعتهم مَن لا يعلمُ عددَهم إلَّا الله، وصل الأمرُ إلى أن تظهرَ رحمتهُ تعالى بحيثُ تفوقُ شفاعاتهم، كيف لا وهو أرحمُ الراحمينَ رحمة، وأبرَّهم بِرًا، وأكرمُهم كرامة، وأجودُهم جُودًا، فخصَّ لنفسه بمن لم يكن عندهمُ من العمل والخير شيء، ولم يأذن فيهم أحدًا، لأن حقَّ الشفاعة بين يدي الملك الجبار يكونُ فيمن عندهم شيء، أما من كان مجرمًا وكان أمرُه فُرُطًا، فإنه يُحشر يومَ القيامة أعمى، ولذا قال عيسى ابن مريم عليه السلام مع كونه أحْنَى على أمته {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} [المائدة: 118] ولم يواجهه بالمغفرة بتًا، وإنما هو الله تعالى يُخرجُ هو بنفسه من حُجزت عنهم شفاعة الشافعين، ليقال: إنهم عُتقاء الله، عْتِقُوا بمجرد بركة اسمه العزيز، ولذا اكتُفي بذكر كلمة التوحيد ليظهرَ وجهُ انفرادِ ذاته الوحيدة، إنه حميد مجيد، هكذا سمعتُ من شيخي رحمه الله تعالى مع بعض تغيير.