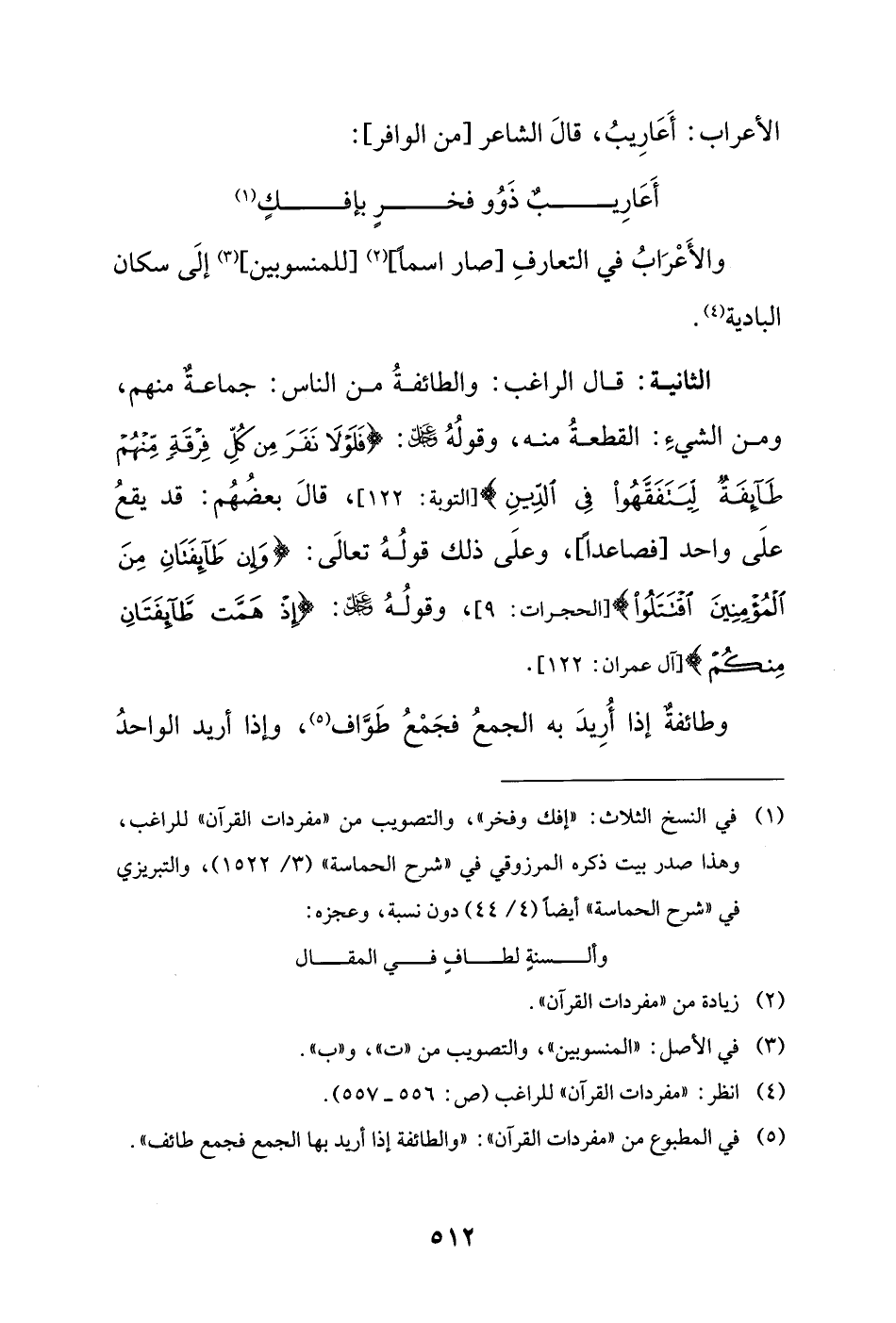
كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)
الإعراب: أَعارِيبُ، قَالَ الشاعر [من الوافر]:أَعارِيبٌ ذَوُو فخرٍ بإفكٍ (¬1)
والأَعْرابُ في التعارفِ [صار اسماً] (¬2) [للمنسوبين] (¬3) إلَى سكان البادية (¬4).
الثانية: قال الراغب: والطائفةُ من الناس: جماعةٌ منهم، ومن الشيءِ: القطعةُ منه، وقولهُ - عز وجل -: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122]، قَالَ بعضُهُم: قد يقعُ علَى واحد [فصاعداً]، وعلَى ذلك قولُهُ تعالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9]، وقولُهُ - عز وجل -: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ} [آل عمران: 122].
وطائفةٌ إذا أُرِيدَ به الجمعُ فجَمْعُ طَوّاف (¬5)، وإذا أريد الواحدُ
¬__________
(¬1) في النسخ الثلاث: "إفك وفخر"، والتصويب من "مفردات القرآن" للراغب، وهذا صدر بيت ذكره المرزوقي في "شرح الحماسة" (3/ 1522)، والتبريزي في "شرح الحماسة" أيضًا (4/ 44) دون نسبة، وعجزه:
وألسنةِ لطافٍ في المقال
(¬2) زيادة من "مفردات القرآن".
(¬3) في الأصل: "المنسوبين"، والتصويب من "ت"، و"ب".
(¬4) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 556 - 557).
(¬5) في المطبوع من "مفردات القرآن": "والطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف".