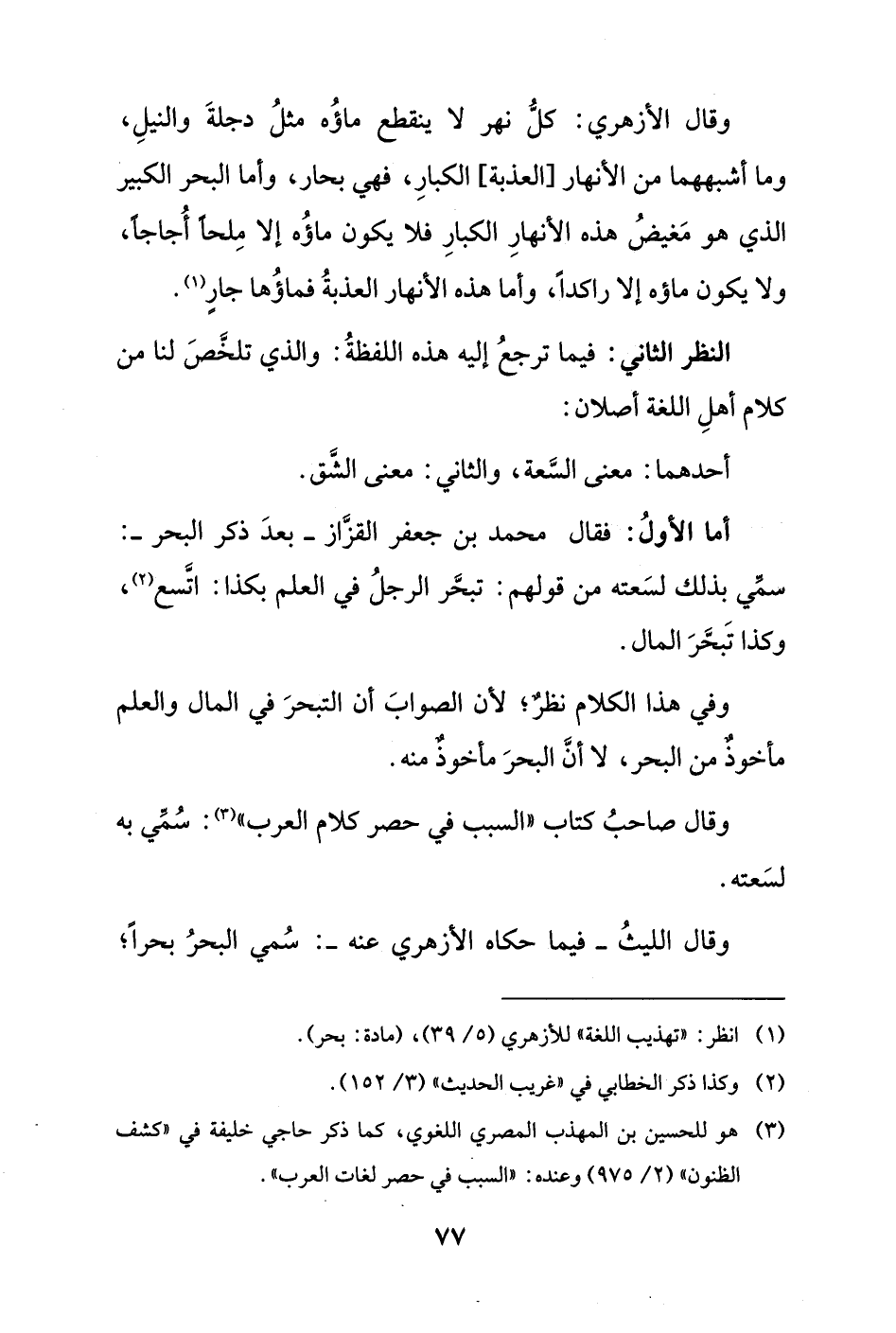
كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)
وقال الأزهري: كلُّ نهر لا ينقطع ماؤُه مثلُ دجلةَ والنيلِ، وما أشبههما من الأنهار [العذبة] الكبارِ، فهي بحار، وأما البحر الكبير الذي هو مَغيضُ هذه الأنهارِ الكبارِ فلا يكون ماؤُه إلَّا مِلحاً أُجاجاً، ولا يكون ماؤه إلَّا راكداً، وأما هذه الأنهار العذبةُ فماؤُها جارٍ (¬1).النظر الثَّاني: فيما ترجعُ إليه هذه اللفظةُ: والذي تلخَّصَ لنا من كلام أهلِ اللغة أصلان:
أحدهما: معنى السَّعة، والثاني: معنى الشَّق.
أما الأولُ: فقال محمد بن جعفر القزَّاز - بعدَ ذكر البحر -: سمِّي بذلك لسَعته من قولهم: تبحَّر الرجلُ في العلم بكذا: اتَّسع (¬2)، وكذا تَبحَّرَ المال.
وفي هذا الكلام نظرٌ؛ لأنَّ الصوابَ أن التبحرَ في المال والعلم مأخوذٌ من البحر، لا أنَّ البحرَ مأخوذٌ منه.
وقال صاحبُ كتاب "السبب في حصر كلام العرب" (¬3): سُمِّي به لسَعته.
وقال الليثُ - فيما حكاه الأزهري عنه -: سُمي البحرُ بحراً؛
¬__________
(¬1) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (5/ 39)، (مادة: بحر).
(¬2) وكذا ذكر الخطابي في "غريب الحديث" (3/ 152).
(¬3) هو للحسين بن المهذب المصري اللغوي، كما ذكر حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 975) وعنده: "السبب في حصر لغات العرب".