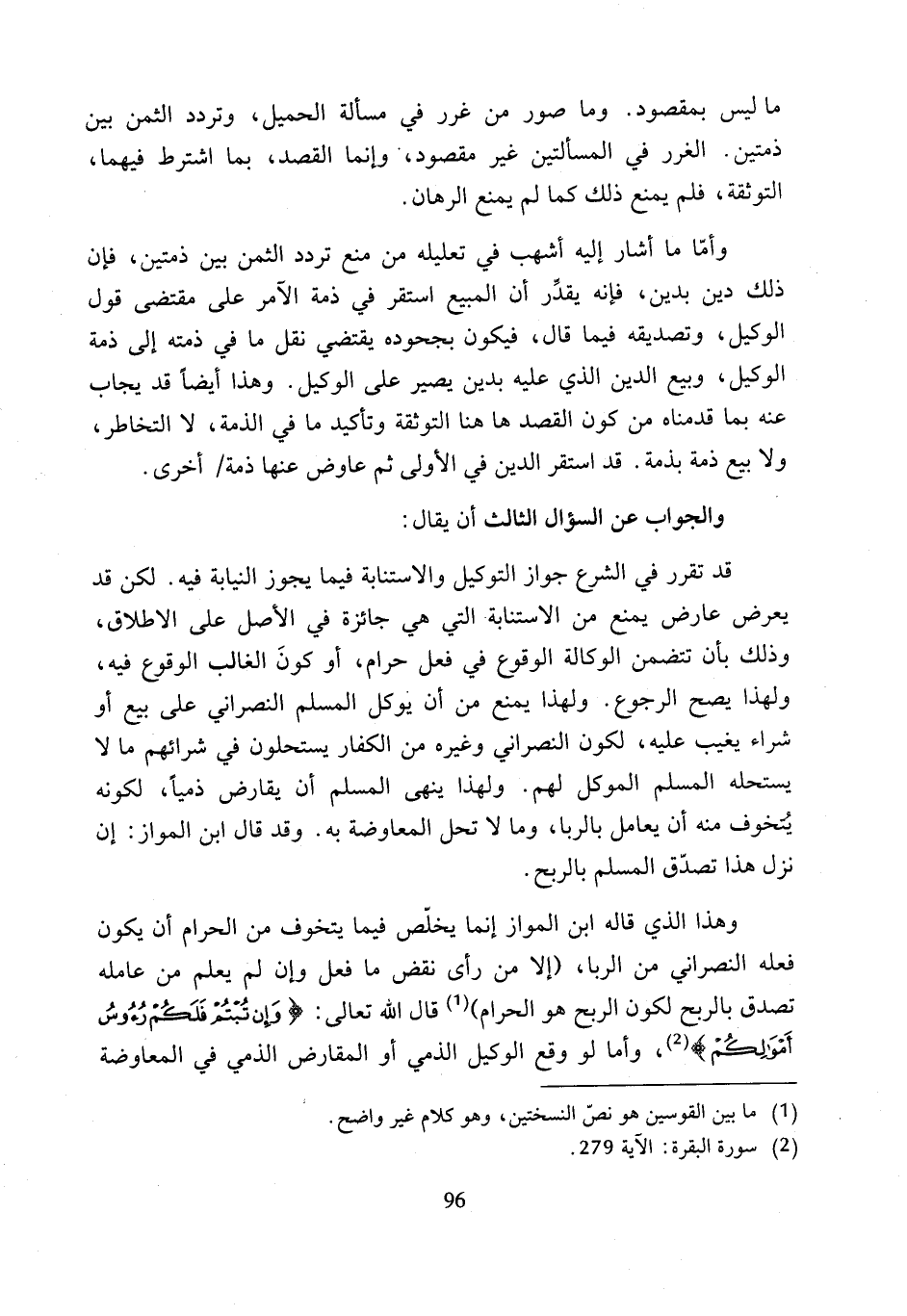
كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 2)
ما ليس بمقصود. وما صور من غرر في مسألة الحميل، وتردد الثمن بين ذمتين. الغرر في المسألتين غير مقصود، وإنما القصد، بما اشترط فيهما، التوثقة، فلم يمنع ذلك كما لم يمنع الرهبان.وأمّا ما أشار إليه أشهب في تعليله من منع تردد الثمن بين ذمتين، فإن ذلك دين بدين، فإنه يقدِّر أن المبيع استقر في ذمة الآمر على مقتضى قول الوكيل، وتصديقه فيما قال، فيكون بجحوده يقتضي نقل ما في ذمته إلى ذمة الوكيل، وبيع الدين الذي عليه بدين يصير على الوكيل. وهذا أيضًا قد يجاب عنه بما قدمناه من كون القصد ها هنا التوثقة وتأكيد ما في الذمة، لا التخاطر، ولا بيع ذمة بذمة. قد استقر الدين في الأولى ثم عاوض عنها ذمة أخرى.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال:
قد تقرر في الشرع جواز التوكيل والاستنابة فيما يجوز النيابة فيه. لكن قد يعرض عارض يمنع من الاستنابة التي هي جائزة في الأصل على الإطلاق، وذلك بأن تتضمن الوكالة الوقوع في فعل حرام، أو كونَ الغالب الوقوع فيه، ولهذا يصح الرجوع. ولهذا يمنع من أن يوكل المسلم النصراني على بيع أو شراء يغيب عليه، لكون النصراني وغيره من الكفار يستحلون في شرائهم ما لا يستحله المسلم الموكل لهم. ولهذا ينهى المسلم أن يقارض ذميًا، لكونه يُتخوف منه أن يعامل بالربا، وما لا تحل المعاوضة به. وقد قال ابن المواز: إن نزل هذا تصدّق المسلم بالربح.
وهذا الذي قاله ابن المواز إنما يخلّص فيما يتخوف من الحرام أن يكون فعله النصراني من الربا، (إلا من رأى نقض ما فعل وإن لم يعلم من عامله تصدق بالربح لكون الربح هو الحرام) (¬1) قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} (¬2)، وأما لو وقع الوكيل الذمي أو المقارض الذمي في المعاوضة
¬__________
(¬1) ما بين القوسين هو نصّ النسختين، وهو كلام غير واضح.
(¬2) سورة البقرة: الآية 279.