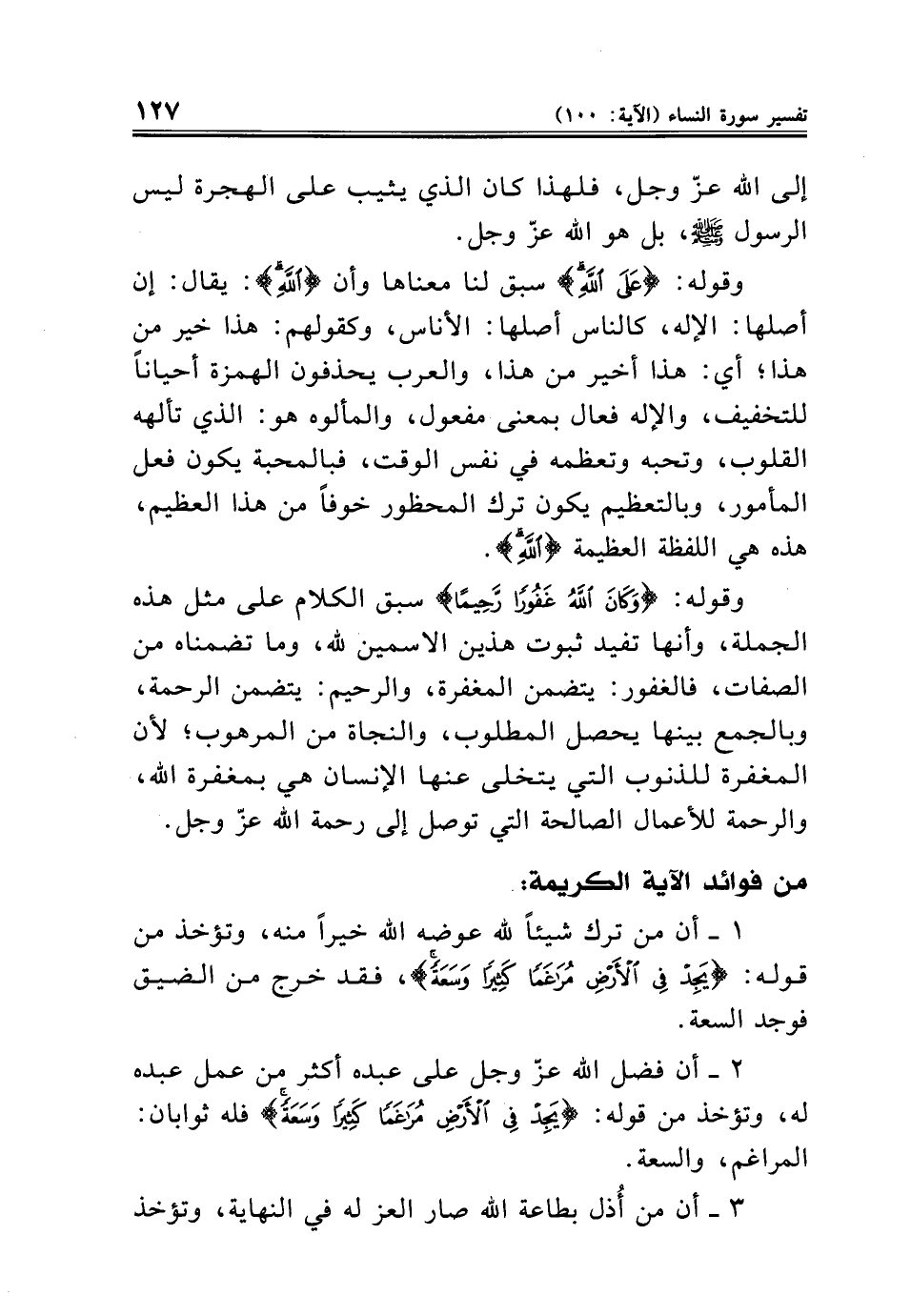
كتاب تفسير العثيمين: النساء (اسم الجزء: 2)
إلى الله عزّ وجل، فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل هو الله عزّ وجل.وقوله: {عَلَى اللَّهِ} سبق لنا معناها وأن {اللهِ}: يقال: إن أصلها: الإله، كالناس أصلها: الأناس، وكقولهم: هذا خير من هذا؛ أي: هذا أخير من هذا، والعرب يحذفون الهمزة أحيانًا للتخفيف، والإله فعال بمعنى مفعول، والمألوه هو: الذي تألهه القلوب، وتحبه وتعظمه في نفس الوقت، فبالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفًا من هذا العظيم، هذه هي اللفظة العظيمة {اللهِ}.
وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} سبق الكلام على مثل هذه الجملة، وأنها تفيد ثبوت هذين الإسمين لله، وما تضمناه من الصفات، فالغفور: يتضمن المغفرة، والرحيم: يتضمن الرحمة، وبالجمع بينها يحصل المطلوب، والنجاة من المرهوب؛ لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان هي بمغفرة الله، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عزّ وجل.
من فوائد الآية الكريمة:
١ - أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وتؤخذ من قوله: {يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً}، فقد خرج من الضيق فوجد السعة.
٢ - أن فضل الله عزّ وجل على عبده أكثر من عمل عبده له، وتؤخذ من قوله: {وَيَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} فله ثوابان: المراغم، والسعة.
٣ - أن من أُذل بطاعة الله صار العز له في النهاية، وتؤخذ