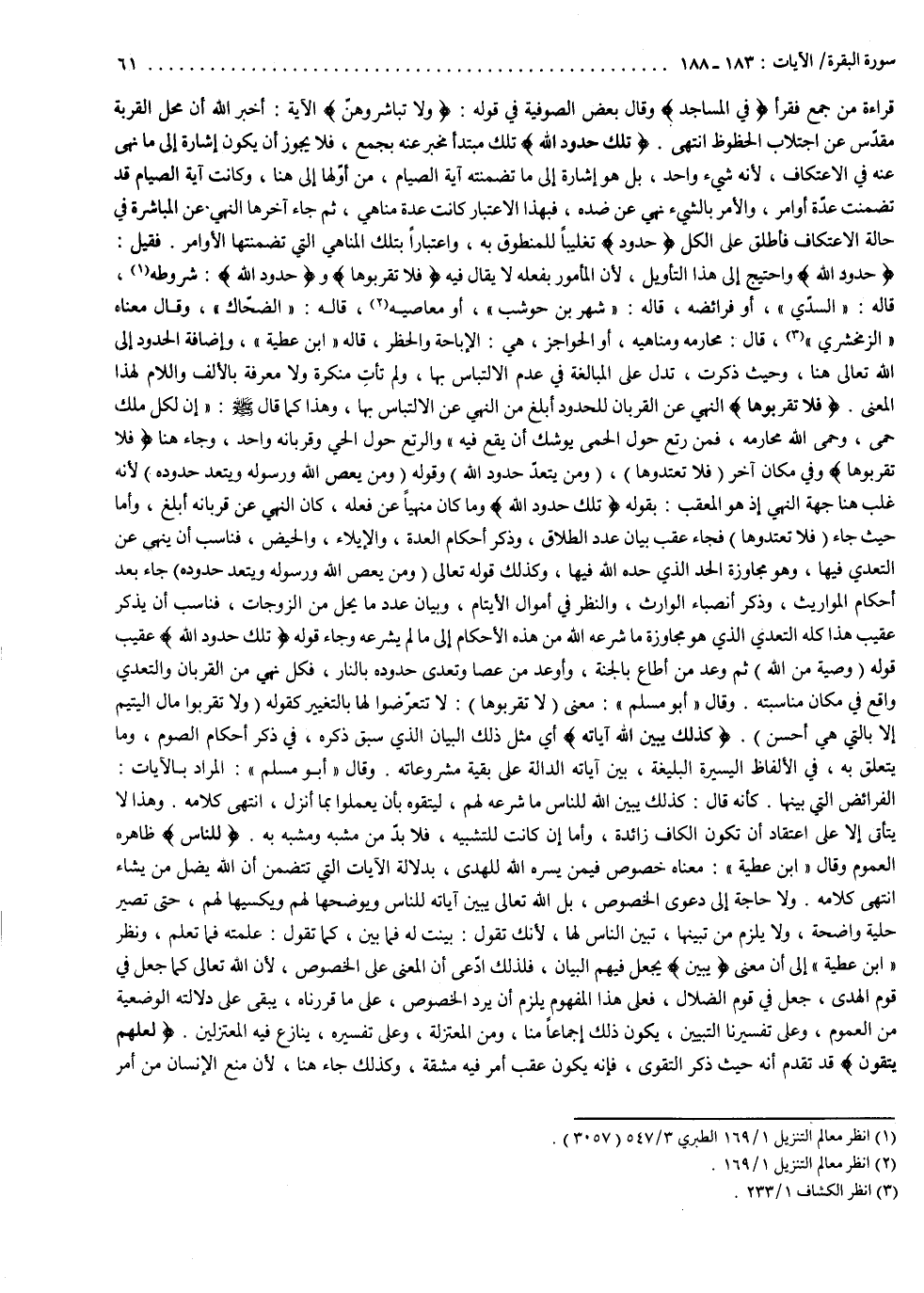
كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 2)
" صفحة رقم 61 "قراءة من جمع فقرأ في المساجد .
وقال بعض الصوفية في قوله : ) وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ ( الآية . أخبر الله أن محل القربة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ . انتهى .
( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ( تلك مبتدأ مخبر عنه بجمع فلا يجوز أن يكون إشارة إلى ما نهى عنه في الاعتكاف ، لأنه شيء واحد ، بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام من أوّلها إلى هنا . وكانت آية الصيام قد تضمنت عدّة أوامر ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ، فبهذا الاعتبار كانت عدة مناهي ، ثم جاء أخرها النهي عن المباشرة في حالة الاعتكاف ، فأطلق على الكل : حدود ، تغليباً للمنطوق به ، واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتها الأوامر . فقيل : حدود الله ، واحتيج إلى هذا التأويل ، لأن المأمور بفعله لا يقال فيه : فلا تقربوها ، وحدود الله : شروطه ، قاله السدّي . أو : فرائضه ، قاله شهر بن حوشب . أو : معاصيه ، قاله الضحاك . وقال معناه الزمخشري ، قال : محارمه ومناهيه ، أو الحواجز هي الإباحة والحظر قاله ابن عطية .
وإضافة الحدود إلى الله تعالى هنا ، وحيث ذكرت ، تدل على المبالغة في عدم الالتباس بها ، ولم تأت منكرة ولا معرّفة بالالف واللام لهذا المعنى .
( فَلاَ تَقْرَبُوهَا ( النهي عن القربان للحدود أبلغ من النهي عن الالتباس بها ، وهذا كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) ) : ( إن لكل ملك حمى ، وحمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) . والرتع حول الحمى وقربانه واحد ، وجاء هنا : فلا تقربوها ، وفي مكان آخر : ) فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ( وقوله : ) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ( ، لأنه غلب هنا جهة النهي ، اذ هو المعقب بقوله : تلك حدود الله ، وما كان منهياً عن فعله كان النهي عن قربانه أبلغ ، وأما حيث جاء : فلا تعتدوها ، فجاء عقب بيان عدد الطلاق ، وذكر أحكام العدة والإيلاء والحيض ، فناسب أن ينهي عن التعدي فيها ، وهو مجاوزة الحد الذي حده الله فيها ، وكذلك قوله تعالى : ) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ( جاء بعد أحكام المواريث ، وذكر أنصباء الوارث ، والنظر في أموال الأيتام ، وبيان عدد ما يحل من الزوجات ، فناسب أن يذكر عقيب هذا كله التعدي الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من هذه الأحكام إلى ما لم يشرعه . وجاء قوله : تلك حدود الله ، عقيب قوله : ) وَصِيَّةً مّنَ اللَّهِ ( ثم وعد من أطاع بالجنة ، وأوعد من عصا وتعدى حدوده بالنار ، فكل نهي من القربان والتعدي واقع في مكان مناسبته .
وقال أبو مسلم معنى : لا تقربوها : لا تتعرّضوا لها بالتغيير ، كقوله : ) وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ).
) كَذالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ( أي : مثل ذلك البيان الذي سبق ذكره في ذكر أحكام الصوم وما يتعلق به في الألفاظ اليسيرة البليغة يبين آياته الدالة على بقية مشروعاته ، وقال أبو مسلم : المراد بالآيات : الفرائض التي بينها ، كأنه قال كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما أنزل . إنتهى كلامه . وهذا لا يتأتى إلاّ على اعتقاد أن تكون الكاف زائدة وأما إن كانت للتشبيه فلا بد من مشبه ومشبه به .
( لِلنَّاسِ ( : ظاهره العموم وقال ابن عطية : معناه خصوص فيمن يسره الله للهدى ، بدلالة الآيات التي يتضمن ) إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء ( انتهى كلامه ولا حاجة إلى دعوى الخصوص ، بل الله تعالى يبين آياته للناس ويوضحها لهم ، ويكسيها لهم حتى تصير جلية واضحة ، ولا يلزم من تبينها تبين الناس لها ، لأنك تقول : بينت له فما بين ، كما تقول : علمته فما تعلم .
ونظر ابن عطية إلى أن معنى يبين ، يجعل فيهم البيان ، فلذلك ادّعى أن المعنى على الخصوص ، لأن الله تعالى كما جعل في قوم الهدى ، جعل في قوم الضلال ، فعلى هذا المفهوم يلزم أن يرد الخصوص على ما قررناه يبقى على دلالته الوضعية من العموم ، وعلى تفسيرنا التبيين يكون ذلك إجماعاً منا ومن المعتزلة ، وعلى تفسيره ينازع فيه المعتزلين .
( لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( قد تقدم أنه حيث ذكر التقوى فإنه يكون عقب أمر فيه مشقة ، وكذلك جاء هنا لأن منع الإنسان من أمر