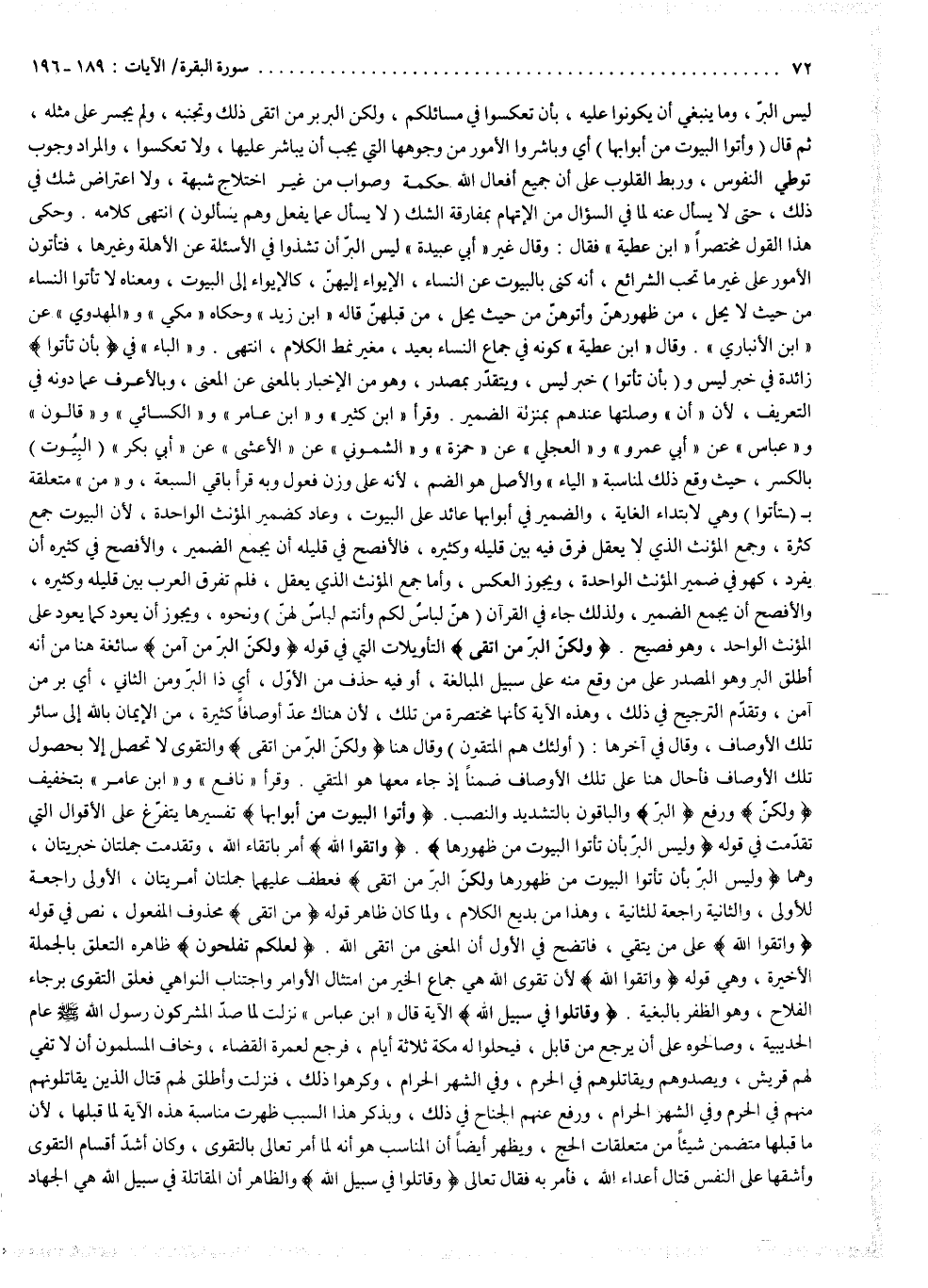
كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 2)
" صفحة رقم 72 "ليس البرّ ، وما ينبغي أن يكونوا عليه ، بأن تعكسوا في مسائلكم ، ولكن البر بر من اتقى ذلك وتجنبه ، ولم يجسر على مثله .
ثم قال : ) وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِهَا ( أي : وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن يباشر عليها ، ولا تعكسوا ، والمراد وجوب توطيء النفوس وربط القلوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غير اختلاج شبهة ، ولا اعتراض شك في ذلك ، حتى لا يسأل عنه لما في السؤال من الاتهام بمفارقة الشك ) لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ). انتهى كلامه .
وحكى هذا القول مختصراً ابن عطية ، فقال : وقال غير أبي عبيدة : ليس البرّ أن تشذوا في الأسئلة عن الأهلة وغيرها ، فتأتون الأمور على غير ما تحب الشرائع ، أنه كنى بالبيوت عن النساء الإيواء اليهنّ كالإيواء إلى البيوت ، ومعناه : لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهنّ ، وآتوهنّ من حيث يحل من قَبُلهنّ . قاله ابن زيد ، وحكاه مكي ، والمهدوي عن ابن الأنباري .
وقال ابن عطية : كونه في جماع النساء بعيد مغير نمط الكلام ، انتهى .
والباء في : بان تأتوا زائدة في خبر ليس ، وبأن تأتوا ، خبر ليس ، ويتقدّر بمصدر ، وهو من الإخبار بالمعنى عن المعنى ، وبالأعرف عما دونه في التعريف ، لأن : أن وصلتها ، عندهم بمنزلة الضمير .
وقرأ ابن كثير ، وابن عامر ، والكسائي ، وقالون ، وعباس ، عن أبي عمرو ؛ والعجلي عن حمزة ؛ والشموني عن الأعشى ، عن أبي بكر : البيوتِ ، بالكسر حيث وقع ذلك لمناسبة الياء ، والأصل هو الضم لأنه على وزن فعول ، وبه قرأ باقي السبعة و : مِنْ ، متعلقة : بتأتوا ، وهي لابتداء الغاية ، والضمير في : أبوابها ، عائد على البيوت . وعاد كضمير المؤنث الواحدة ، لأن البيوت جمع كثرة ، وجمع المؤنث الذي لا يعقل فرق فيه بين قليله وكثيره ، فالأفصح في قليله أن يجمع الضمير ، والأفصح في كثيره أن يفرد . كهو في ضمير المؤنث الواحدة ، ويجوز العكس . وأما جمع المؤنث الذي يعقل فلم تفرق العرب بين قليله وكثيره ، والأفصح أن يجمع الضمير . ولذلك جاء في القرآن : ) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ( ونحوه ، ويجوز أن يعود كما يعود على المؤنث الواحد وهو فصيح .
( وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ( التأويلات التي في قوله : ) وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءامَنَ ( سائغة هنا ، من أنه أطلق البر ، وهو المصدر ، على من وقع منه على سبيل المبالغة ، أو فيه حذف من الأوّل ، أي : ذا البرّ ، ومن الثاني أي : بر من آمن . وتقدّم الترجيح في ذلك .
وهذه الآية كأنها مختصرة من تلك لأن هناك عدّ أوصافاً كثيرة من الإيمان بالله إلى سائر تلك الأوصاف ، وقال في آخرها : ) أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( وقال هنا : ) وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ( والتقوى لا تحصل إلاَّ بحصول تلك الأوصاف ، فأحال هنا على تلك الأوصاف ضمناً إذ جاء معها : هو المتقي .
وقرأ نافع ، وابن عامر بتخفيف : ولكنّ ، ورفع : البرّ ، والباقون بالتشديد والنصب .
( وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِهَا ( تفسيرها : يتفرّغ على الأقوال التي تقدّمت في قوله : ) وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ).
) وَاتَّقُواْ اللَّهَ ( : أمر باتقاء الله ، وتقدمت جملتان خبريتان وهما ) وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ( فعطف عليهما جملتان أمريتان الأولى راجعة للأول ، والثانية راجعة للثانية ، وهذا من بديع الكلام .
ولما كان ظاهر قوله : من اتقى ، محذوف المفعول ، نص في قوله : واتقوا الله ، على من يتقى ، فاتضح في الأول أن المعنى من اتقى الله .
( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ظاهره التعلق بالجملة الأخيرة ، وهي قوله ) وَاتَّقُواْ اللَّهَ ( لأن تقوى الله هو إجماع الخير من امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، فعلق التقوى برجاء الفلاح ، وهو الظفر بالبغية .
البقرة : ( 190 ) وقاتلوا في سبيل . . . . .
( وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( الآية . قال ابن عباس : نزلت لما صدّ المشركون رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) عام الحديبية ، وصالحوه على أن يرجع من قابل فيحلوا له مكة ثلاثة أيام ، فرجع لعمرة القضاء ، وخاف المسلمون أن لا تفي لهم قريش ، ويصدوهم ، ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر الحرام ، وكرهوا ذلك ، فنزلت . وأطلق لهم قتال الذين يقاتلونهم منهم في الحرم وفي الشهر الحرام ، ورفع عنهم الجناح في ذلك ، وبذكر هذا السبب ظهرت مناسبة هذه الآية لما قبلها ، لأن ما قبلها متضمن شيئاً من متعلقات الحج ، ويظهر أيضاً أن المناسب هو : أنه لما أمر تعالى بالتقوى ، وكان أشدّ أقسام التقوى وأشقها على النفس قتال أعداء الله ، فأمر به فقال تعالى : ) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( والظاهر أن المقاتلة في سبيل الله هي الجهاد