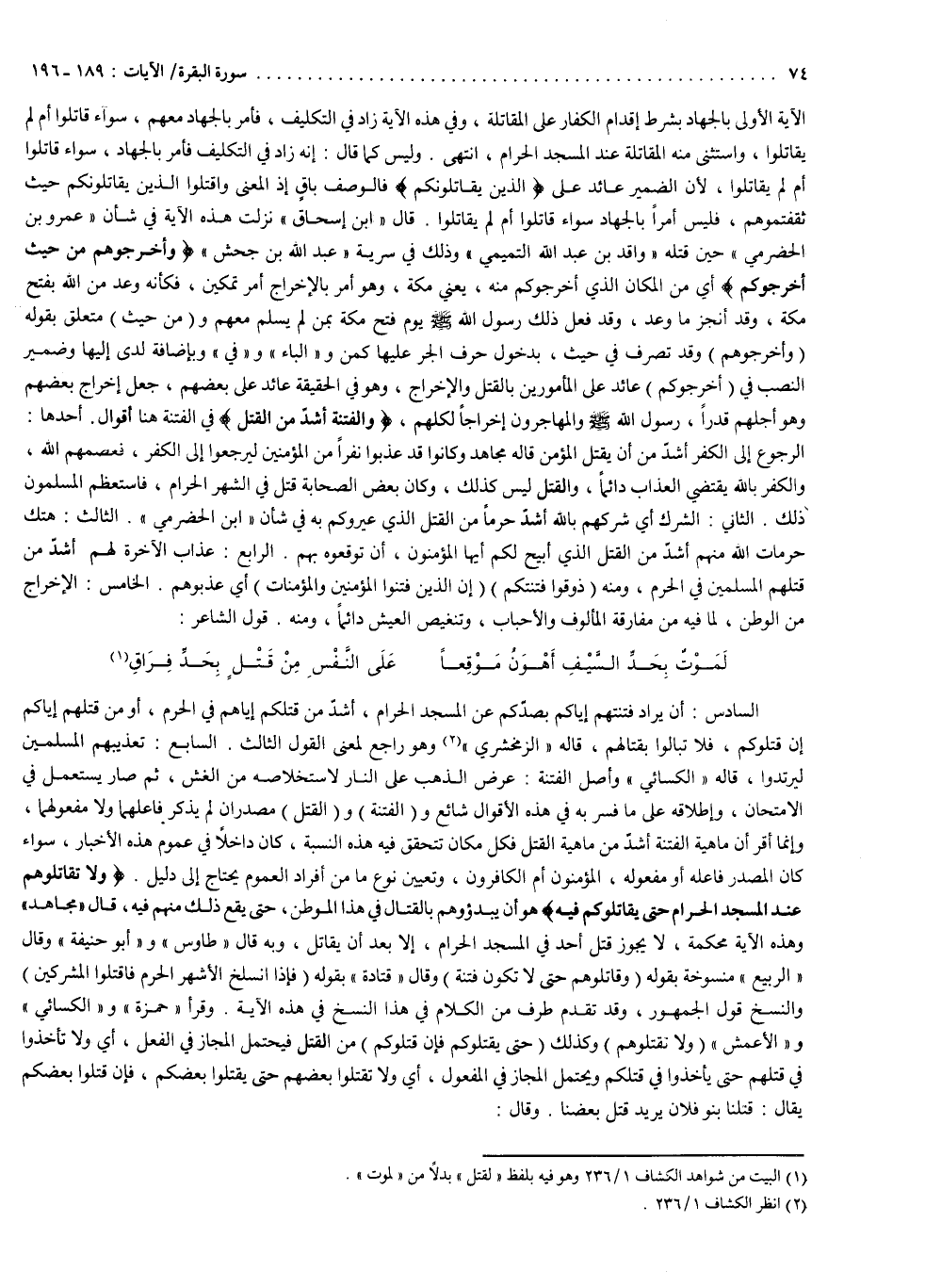
كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 2)
" صفحة رقم 74 "الآية : الأولى بالجهاد بشرط إقدام الكفار على المقاتلة ، وفي هذه الآية زاد في التكليف . فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا ، واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام . انتهى . وليس كما قال : إنه زاد في التكليف فأمر بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا ، لأن الضمير عائد على : الذين يقاتلونكم ، فالوصف باقٍ إذْ المعنى : واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم ، فليس أمراً بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا .
قال ابن إسحاق : نزلت هذه الآية في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله وافد بن عبد الله التميمي ، وذلك في سرية عبد الله بن جحش .
( وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ( أي : من المكان الذي أخرجوكم منه ، يعني مكة ، وهو أمر بالإخراج أمر تمكين ، فكأنه وعد من الله بفتح مكة ، وقد أنجز ما وعد ، وقد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) يوم فتح مكة بمن لم يسلم معهم ، و : مِنْ حيثُ ، متعلق بقوله : وأخرجوهم ، وقد تصرف في : حيث ، بدخول حرف الجر عليها : كمن ، والباء ، وفي ، وبإضافة لدى إليها .
وضمير النصب في : أخرجوكم ، عائد على المأمورين بالقتل ، والإخراج ، وهو في الحقيقة عائد على بعضهم ، جعل إخراج بعضهم ، وهو أجلهم قدراً رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) والمهاجرون ، إخراجاً لكلهم .
( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ( في الفتنة هنا أقوال .
أحدها : الرجوع إلى الكفر أشدّ من أن يقتل المؤمن ، قاله مجاهد . وكانوا قد عذبوا نفراً من المؤمنين ليرجعوا إلى الكفر ، فعصمهم الله . والكفر بالله يقتضي العذاب دائماً ، والقتل ليس كذلك ، وكان بعض الصحابة قتل في الشهر الحرام ، فاستعظم المسلمون ذلك .
الثاني : الشرك ، أيّ : شركهم بالله أشدّ حرماً من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي .
الثالث : هتك حرمات الله منهم أشدّ من القتل الذي أبيح لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم .
الرابع : عذاب الآخرة لهم أشدّ من قتلهم المسلمين في الحرم ومنه : ) ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ ( ) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( أي : عذبوهم .
الخامس : الإخراج من الوطن لما فيه من مفارقة المألوف والأحباب ، وتنغيص العيش دائماً ، ومنه قول الشاعر : لموت بحدّ السيف أهون موقعا
على النفس من قتل بحدِّ فراقِ
السادس : أن يراد فتنتهم إياكم بصدّكم عن المسجد الحرام ، أشدّ من قتلكم إياهم في الحرم ، أو من قتلهم إياكم ، إن قتلوكم ، فلا تبالوا بقتالهم ، قاله الزمخشري ، وهو راجع لمعنى القول الثالث .
السابع : تعذيبهم المسلمين ليرتدوا ، قاله الكسائي .
وأصل الفتنة عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش ، ثم صار يستعمل في الامتحان ، وإطلاقه على ما فسر به في هذه الاقوال شائع ، والفتنة والقتل مصدران لم يذكر فاعلهما ، ولا مفعولهما ، وإنما أقرَّ أن ماهية الفتنة أشدّ من القتل ، فكل مكان تتحقق فيه هذه النسبة كان داخلاً في عموم ، هذه الأخبار سوآء كان المصدر فاعله أو مفعوله : المؤمنون أم الكافرون ، وتعيين نوع مّا من أفراد العموم يحتاج إلى دليل .
( وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ( هو أن يبدأهم بالقتال في هذا الموطن حتى يقع ذلك منهم فيه ، قال مجاهد : وهذه الآية محكمة لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلاَّ بعد أن يقاتل . وبه قال طاووس ، وأبو حنيفة ؛ وقال الربيع : منسوخة بقوله : ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتَنَّاهُ ( وقال قتادة بقوله : ) فَإِذَا انسَلَخَ الاشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ( والنسخ قول الجمهور ، وقد تقدم طرف من الكلام في هذا النسخ ، في هذه الآية . وقرأ حمزة ، والكسائي والأعمش : ولا تقتلوهم ، وكذلك حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ، من القتل ، فيحتمل المجاز في الفعل ، أي : ولا تأخذوا في قتلهم حتى يأخذوا في قتلكم ، ويحتمل المجاز في المفعول ، أي : ولا تقتلوا بعضهم حتى يقتلوا بعضكم ، فإن قتلوا بعضكم ، يقال : قتلنا بنو فلان ، يريد قتل بعضنا وقال :