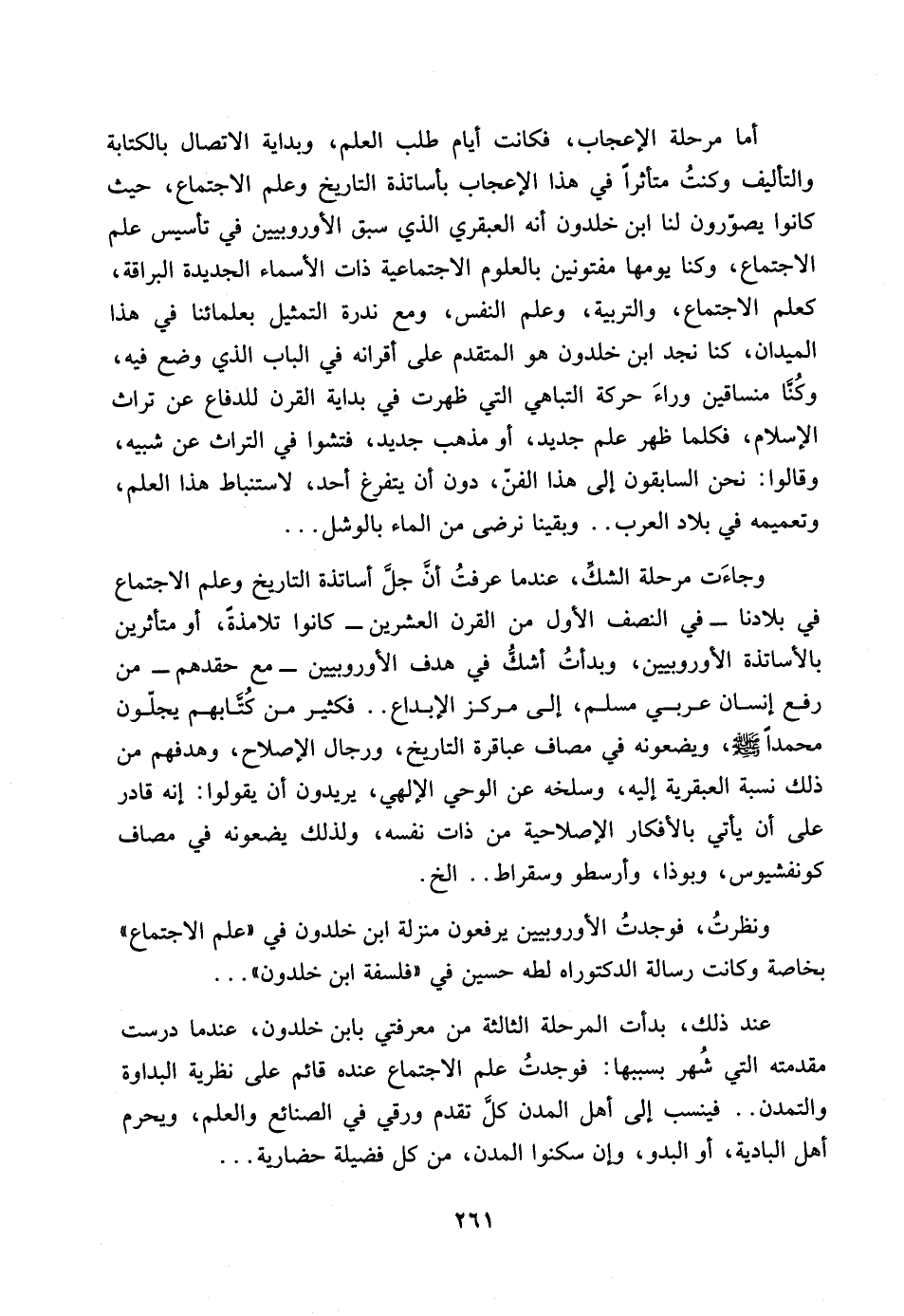
كتاب المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي (اسم الجزء: 2)
261…أما مرحلة الإعجاب، فكانت أيام طلب العلم، وبداية الاتصال بالكتابة والتأليف وكنتُ متأثراً في هذا الإعجاب بأساتذة التاريخ وعلم الاجتماع، حيث كانوا يصوّرون لنا ابن خلدون أنه العبقري الذي سبق الأوروبيين في تأسيس علم الاجتماع، وكنا يومها مفتونين بالعلوم الاجتماعية ذات الأسماء الجديدة البراقة، كعلم الاجتماع، والتربية، وعلم النفس، ومع ندرة التمثيل بعلمائنا في هذا الميدان، كنا نجد ابن خلدون هو المتقدم على أقرانه في الباب الذي وضع فيه، وكُنَّا منساقين وراءَ حركة التباهي التي ظهرت في بداية القرن للدفاع عن تراث الإسلام، فكلما ظهر علم جديد، أو مذهب جديد، فتشوا في التراث عن شبيه، وقالوا: نحن السابقون إلى هذا الفنّ، دون أن يتفرغ أحد، لاستنباط هذا العلم، وتعميمه في بلاد العرب .. وبقينا نرضى من الماء بالوشل ...
وجاءَت مرحلة الشكِّ، عندما عرفتُ أنَّ جلَّ أساتذة التاريخ وعلم الاجتماع في بلادنا ـ في النصف الأول من القرن العشرين ـ كانوا تلامذةً، أو متأثرين بالأساتذة الأوروبيين، وبدأتُ أشكُّ في هدف الأوروبيين ـ مع حقدهم ـ من رفع إنسان عربي مسلم، إلى مركز الإبداع .. فكثير من كُتَّابهم يجلُّون محمداً ص، ويضعونه في مصاف عباقرة التاريخ، ورجال الإصلاح، وهدفهم من ذلك نسبة العبقرية إليه، وسلخه عن الوحي الإلهي، يريدون أن يقولوا: إنه قادر على أن يأتي بالأفكار الإصلاحية من ذات نفسه، ولذلك يضعونه في مصاف كونفشيوس، ويوذا، وأرسطو وسقراط .. الخ.
ونظرتُ، فوجدتُ الأوروبيين يرفعون منزلة ابن خلدون في " علم الاجتماع " بخاصة وكانت رسالة الدكتوراه لطه حسين في " فلسفة ابن خلدون " ...
عند ذلك، بدأت المرحلة الثالثة من معرفتي بابن خلدون، عندما درست مقدمته التي شُهر بسببها: فوجدتُ علم الاجتماع عنده قائم على نظرية البداوة والتمدن .. فينسب إلى أهل المدن كلَّ تقدم ورقي في الصنائع والعلم، ويحرم أهل البادية، أو البدو، وإن سكنوا المدن، من كل فضيلة حضارية ... …