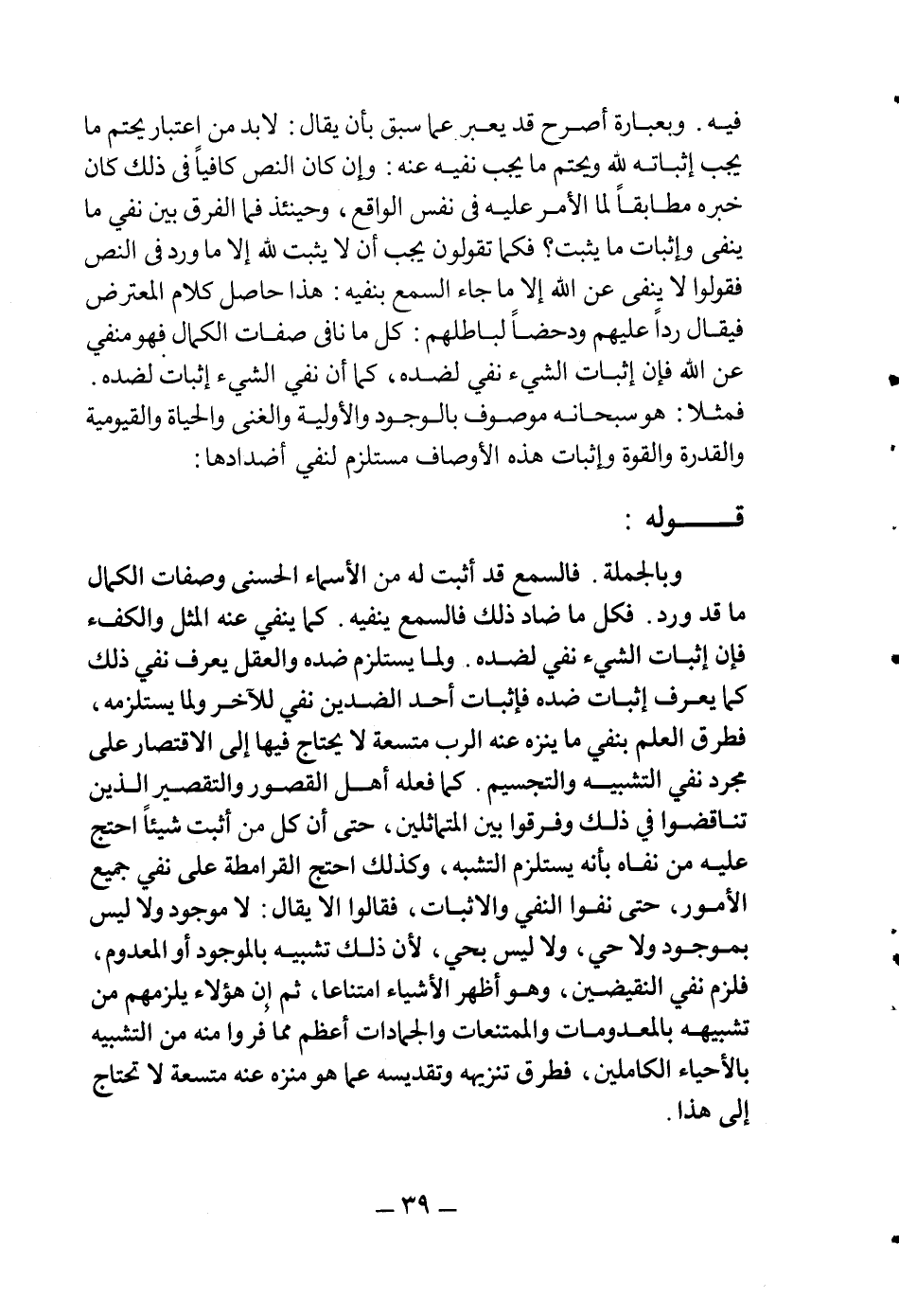
كتاب التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية (اسم الجزء: 2)
فيه. وبعبارة أصرح قد يعبر عما سبق بأن يقال: لابد من اعتبار يحتم ما يجب إثباته لله ويحتم ما يجب نفيه عنه، وإن كان النص كافيا في ذلك كان خبره مطابقا لما الأمر عليه في نفس الواقع، وحينئذ فما الفرق بين نفي ما ينفى وإثبات ما يثبت؟ فكما تقولون يجب أن لا يثبت لله إلا ما ورد في النص فقولوا لا ينفى عن الله إلا ما جاء السمع بنفيه. هذا حاصل كلام المعترض فيقال ردا عليهم ودحضا لباطلهم: كل ما نافى صفات الكمال فهو منفي عن الله، فإن إثبات الشيء نفي لضده، كما أن نفي الشيء إثبات لضده. فمثلا: هو سبحانه موصوف بالوجود والأولية والغنى والحياة والقيومية والقدرة والقوة وإثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفي أضدادها.اعتراض المعتزلة على الأشاعرة
...
قوله:
وبالجملة. فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفء فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم. كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى أن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور، حتى نفوا النفي والإثبات، فقالوا: لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي، ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا.