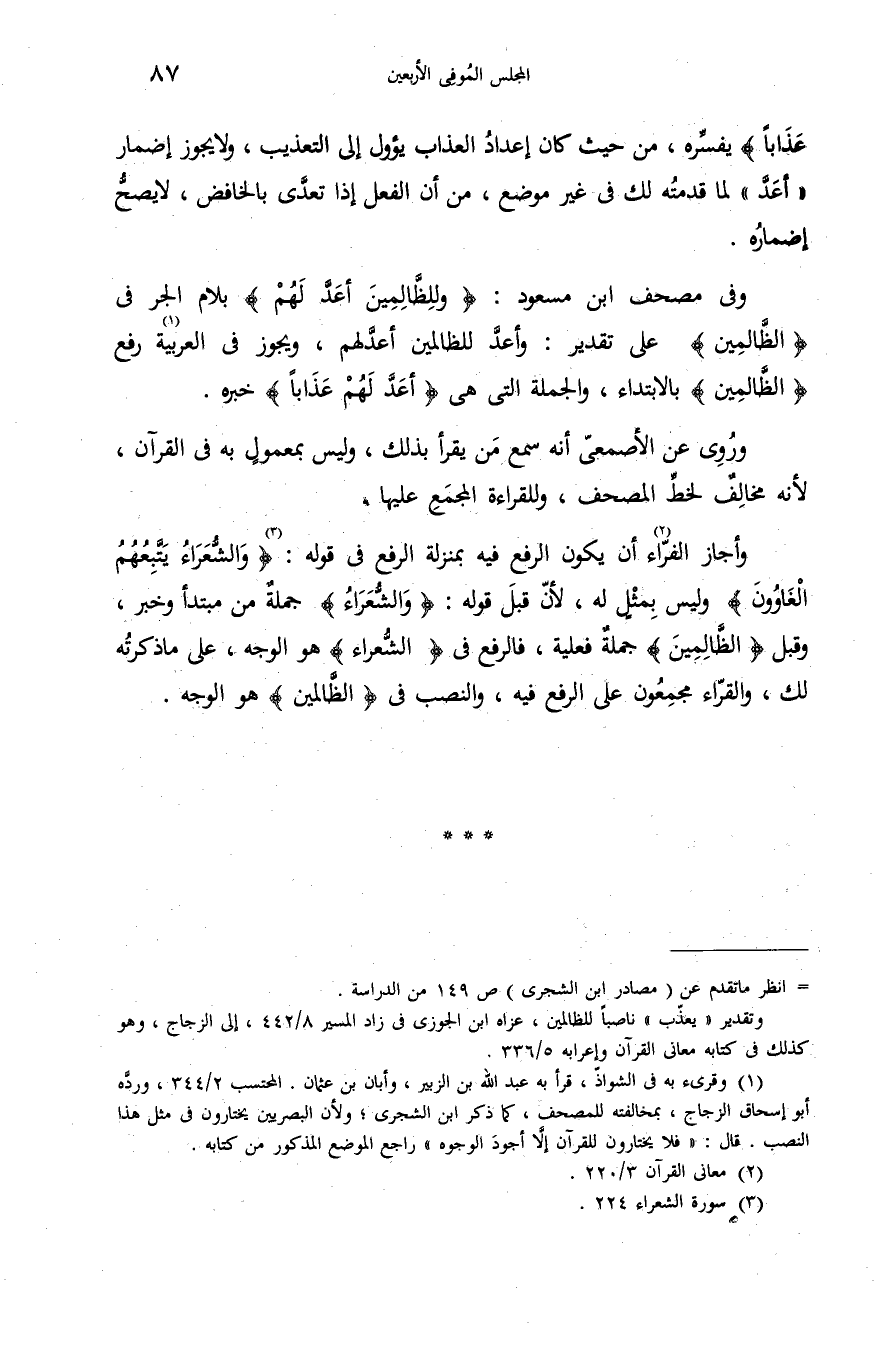
كتاب أمالي ابن الشجري (اسم الجزء: 2)
{عَذاباً} يفسّره، من حيث كان إعداد العذاب يؤول إلى التعذيب، ولا يجوز إضمار «أعدّ» لما قدمته لك فى غير موضع، من أن الفعل إذا تعدّى بالخافض، لا يصحّ إضماره.وفى مصحف ابن مسعود: «وللظّالمين أعدّ لهم» بلام الجر فى {الظّالِمِينَ} على تقدير: وأعدّ للظالمين أعدّ لهم، ويجوز فى العربية (¬1) رفع {الظّالِمِينَ} بالابتداء، والجملة التى هى {أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً} خبره.
وروى عن الأصمعىّ أنه سمع من يقرأ بذلك، وليس بمعمول به فى القرآن، لأنه مخالف لخطّ المصحف، وللقراءة المجمع عليها.
وأجاز الفرّاء (¬2) أن يكون الرفع فيه بمنزلة الرفع فى قوله: (¬3) {وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ} وليس بمثل له، لأنّ قبل قوله: {وَالشُّعَراءُ} جملة من مبتدأ وخبر، وقبل {الظّالِمِينَ} جملة فعلية، فالرفع فى {الشُّعَراءُ} هو الوجه، على ما ذكرته لك، والقرّاء مجمعون على الرفع فيه، والنصب فى {الظّالِمِينَ} هو الوجه.
...
¬_________
= انظر ما تقدم عن (مصادر ابن الشجرى) ص 149 من الدراسة. وتقدير «يعذّب» ناصبا للظالمين، عزاه ابن الجوزى فى زاد المسير 8/ 442، إلى الزجاج، وهو كذلك فى كتابه معانى القرآن وإعرابه 5/ 336.
(¬1) وقرئ به فى الشواذّ، قرأ به عبد الله بن الزبير، وأبان بن عثمان. المحتسب 2/ 344، وردّه أبو إسحاق الزجاج، بمخالفته للمصحف، كما ذكر ابن الشجرى؛ ولأن البصريين يختارون فى مثل هذا النصب. قال: «فلا يختارون للقرآن إلاّ أجود الوجوه» راجع الموضع المذكور من كتابه.
(¬2) معانى القرآن 3/ 220.
(¬3) سورة الشعراء 224.