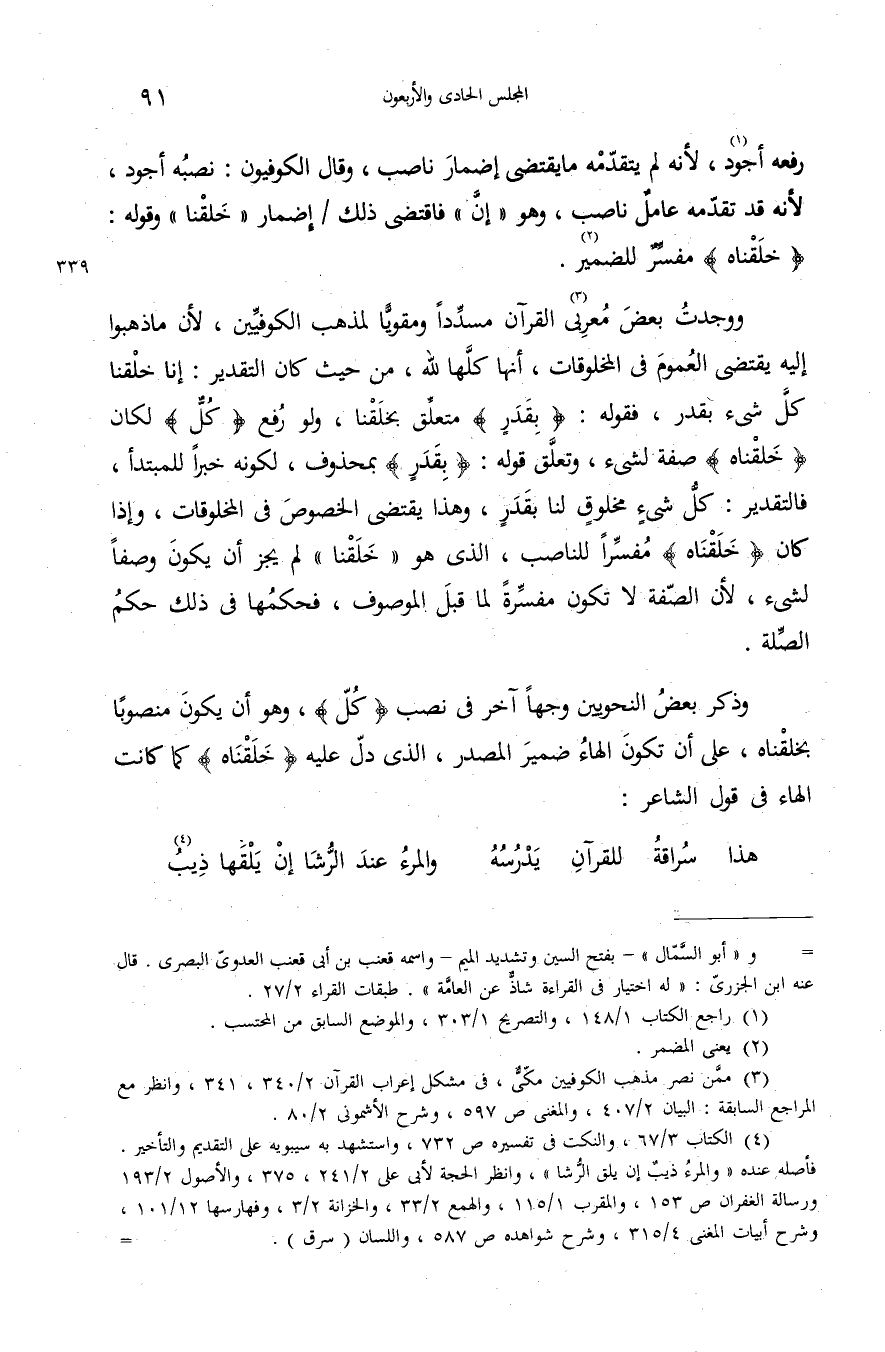
كتاب أمالي ابن الشجري (اسم الجزء: 2)
رفعه أجود (¬1)، لأنه لم يتقدّمه ما يقتضى إضمار ناصب، وقال الكوفيون: نصبه أجود، لأنه قد تقدّمه عامل ناصب، وهو «إنّ» فاقتضى ذلك/إضمار «خلقنا» وقوله:{خَلَقْناهُ} مفسّر للضمير (¬2).
ووجدت بعض معربى (¬3) القرآن مسدّدا ومقويّا لمذهب الكوفيّين، لأن ما ذهبوا إليه يقتضى العموم فى المخلوقات، أنها كلّها لله، من حيث كان التقدير: إنا خلقنا كلّ شيء بقدر، فقوله: {بِقَدَرٍ} متعلّق بخلقنا، ولو رفع {كُلَّ} لكان {خَلَقْناهُ} صفة لشيء، وتعلّق قوله: {بِقَدَرٍ} بمحذوف، لكونه خبرا للمبتدإ، فالتقدير: كلّ شيء مخلوق لنا بقدر، وهذا يقتضى الخصوص فى المخلوقات، وإذا كان {خَلَقْناهُ} مفسّرا للناصب، الذى هو «خلقنا» لم يجز أن يكون وصفا لشيء، لأن الصّفة لا تكون مفسّرة لما قبل الموصوف، فحكمها فى ذلك حكم الصّلة.
وذكر بعض النحويين وجها آخر فى نصب {كُلَّ}، وهو أن يكون منصوبا بخلقناه، على أن تكون الهاء ضمير المصدر، الذى دلّ عليه {خَلَقْناهُ} كما كانت الهاء فى قول الشاعر:
هذا سراقة للقرآن يدرسه … والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب (¬4)
¬_________
= و «أبو السّمّال» -بفتح السين وتشديد الميم-واسمه قعنب بن أبى قعنب العدوىّ البصرى. قال عنه ابن الجزرىّ: «له اختيار فى القراءة شاذّ عن العامّة». طبقات القراء 2/ 27.
(¬1) راجع الكتاب 1/ 148، والتصريح 1/ 303، والموضع السابق من المحتسب.
(¬2) يعنى المضمر.
(¬3) ممّن نصر مذهب الكوفيين مكّىّ، فى مشكل إعراب القرآن 2/ 340،341، وانظر مع المراجع السابقة: البيان 2/ 407، والمغنى ص 597، وشرح الأشمونى 2/ 80.
(¬4) الكتاب 3/ 67، والنكت فى تفسيره ص 732، واستشهد به سيبويه على التقديم والتأخير. فأصله عنده «والمرء ذيب إن يلق الرّشا»، وانظر الحجة لأبى على 2/ 241،375، والأصول 2/ 193 ورسالة الغفران ص 153، والمقرب 1/ 115، والهمع 2/ 33، والخزانة 2/ 3، وفهارسها 12/ 101، وشرح أبيات المغنى 4/ 315، وشرح شواهده ص 587، واللسان (سرق).