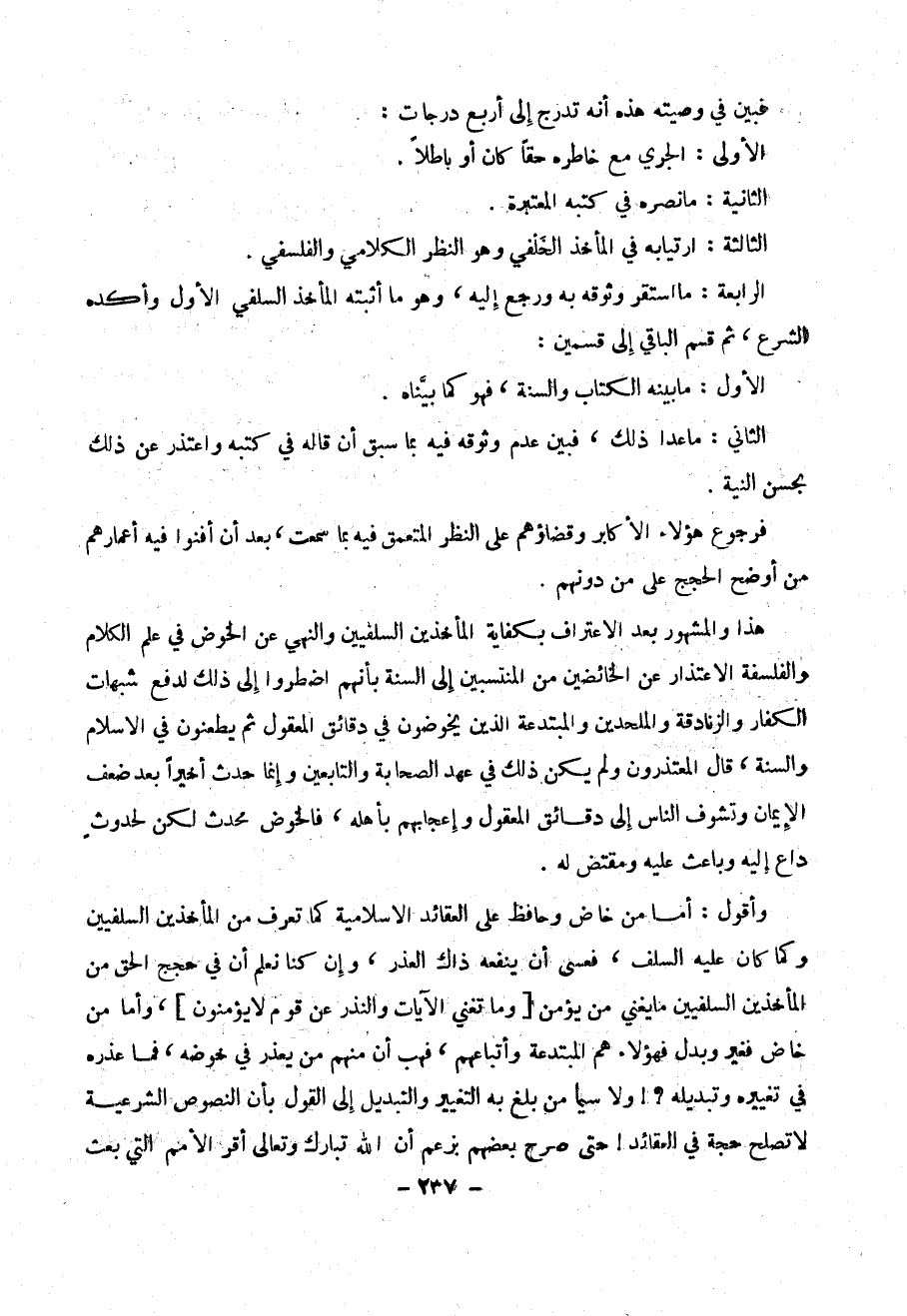
كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
فبين في وصيته هذه أنه تدرج إلى أربع درجات :الأولى : الجري مع خاطره حقاً كان أو باطلاً .
الثانية : ما نصره في كتبه المعتبرة .
الثالثة: ارتيابه في المأخذ الخلفي وهو النظر الكلامي والفلسفي .
الرابعة : ما استقر وثوقه به ورجع إليه ، وهو ما أثبته المأخذ السلفي الأول وأكده الشرع ، ثم قسم الباقي إلى قسمي :
الأول : ما بينه الكتاب والسنة ، فهو كما بيناه .
الثاني ما عدا ذلك ، فبين عدم وثوقه فيه بما سبق أن قاله في كتبه واعتذر عن ذلك بحسن النية .
فرجوع هؤلاء الأكابر وقضاؤهم على النظر المتعمق فيه بما سمعت ، بعد أن أفنوا فيه أعمارهم من أوضح الحجج على من دونهم .
هذا والمشهور بعد الاعتراف بكفاية المأخذين السلفيين والنهي عن الخوض في علم الكلام والفلسفة الاعتذار عن الخائضين من المنتسبين إلى السنة بأنهم اضطروا إلى ذلك لدفع شبهات الكفار والزنادقة ، والملحدين والمبتدعة الذين يخوضون في دقائق المعقول ثم يطعنون في الإسلام والسنة ، قال المعتذرون ولم يكن ذلك في عهد الصحابة والتابعين وإنما حدث أخيراً بعد ضعف الإيمان وتشوف الناس إلى دقائق المعقول وإعجابهم بأهله ، فالخوض محدث لكن لحدوث داع إليه وباعث عليه ومقتض له .
و أقول : أما من خاض وحافظ على العقائد الإسلامية كما تعرف من المأخذين السلفيين وكما كان عليه السلف ، فعسى أن ينفعه ذاك العذر ، وإن كنا نعلم أن في حجج الحق من المأخذين السلفيين ما يغني من يؤمن [ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ] ، وأما من خاض فغير وبدل فهؤلاء هم المبتدعة وأتباعهم ، فهب أن منهم من يعذر في خوضه ، فما عذره في تغييره وتبديله ؟ ! ولا سيما من بلغ به التغيير والتبديل إلى القول بأن النصوص الشرعية لا تصلح حجة في العقائد ! حتى صرح بعضهم بزعم أن الله تبارك وتعالى أقر الأمم التي بعث