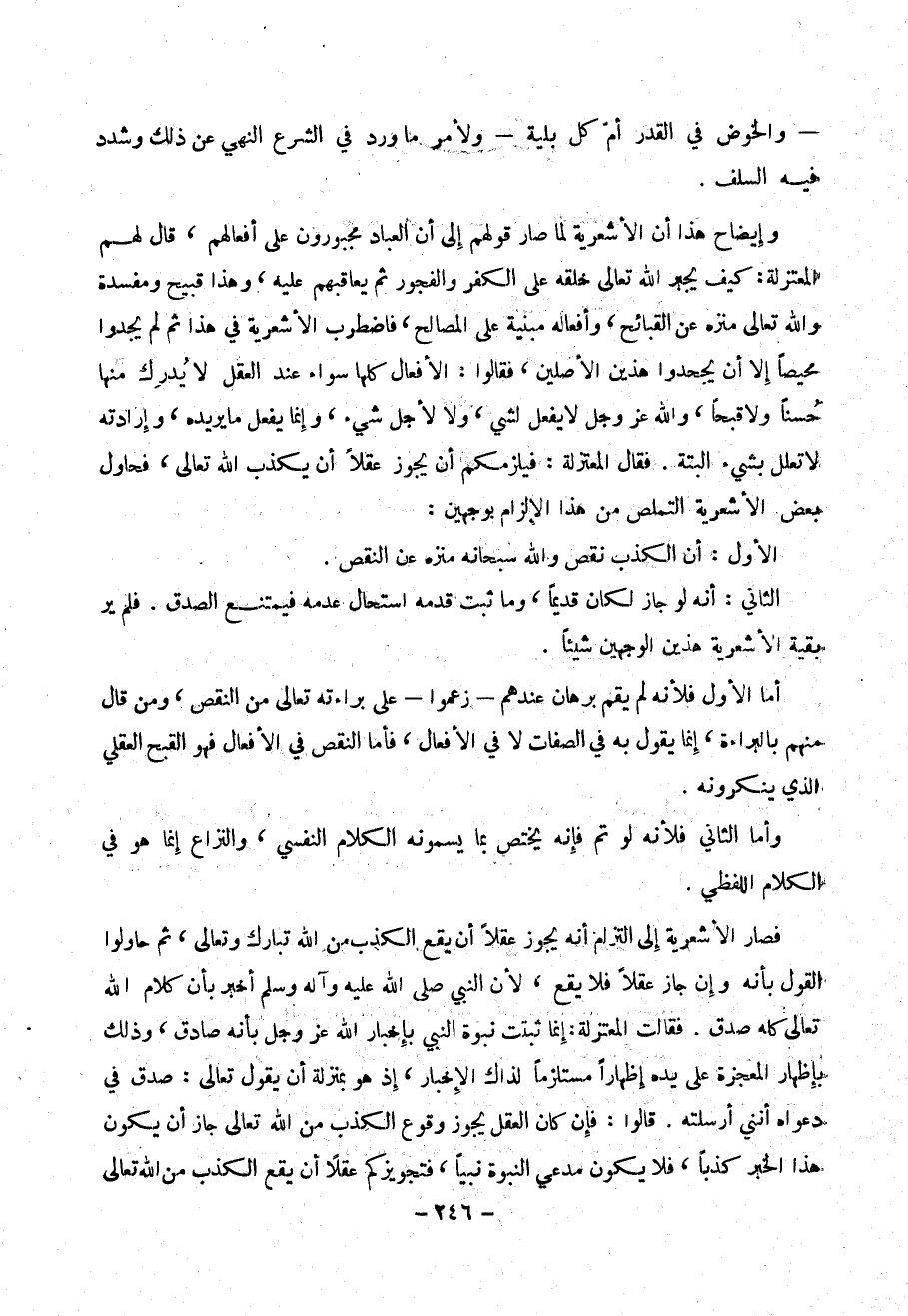
كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
- والخوض في القدر أم كل بلية – ولأمر ما ورد في الشرع النهي عن ذلك وشدد فيه السلف .وإيضاح هذا أن الأشعرية لما صار قولهم إلى أن العباد مجبورون على أفعالهم ، قال لهم المعتزلة: كيف يجبر الله تعالى خلقه على الكفر والفجور ثم يعاقبهم عليه ، وهذا قبيح ومفسدة والله تعالى منزه عن القبائح ، وأفعاله مبنية على المصالح ، فاضطرب الأشعرية في هذا ثم لم يجدوا محيصاً إلا أ، يجحدوا هذين الأصلين ،فقالوا : الأفعال كلها سواء عند العقل ولا يدرك منها حسناً ولا قبحاً ، والله عز وجل لا يفعل لشئ ، ولا لأجل ، إنما يفعل ما يريده ، وإرادته لا تعلل بشئ البتة . فقال المعتزلة : فيلزمكم أن يجوز عقلاً أن يكذب الله تعالى ، فحاول بعض الأشعرية التملص من هذا الإلزام بوجهين :
الأول : أن الكذب نقص والله سبحانه منزه عن النقص .
الثاني : أنه لو جاز لكان قديماً ، وما ثبت قدمه استحال عدمه فيمتنع الصدق . فلم ير بقية الأشعرية هذين الوجهين شيئاً .
أما الأول فلأنه لم يقم برهان عندهم – زعموا – على براءته تعالى من النقص ، ومن قال منهم بالبراءة ، إنما يقول به في الصفات لا في الأفعال ، فأما النقص في الأفعال فهو القبح العقلي الذي ينكرونه .
و أما الثاني فلأنه لو تم فإنه لو تم يختص بما يسمونه الكلام النفسي ، والنزاع إنما هو في الكلام اللفظي .
فصار الأشعرية إلى التزام أنه يجوز عقلاً أن يقع الكذب من الله تبارك وتعالى ، ثم حاولوا القول بأنه وإن جاز عقلاً فلا يقع ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن كلام الله تعالى كله صدق . فقالت المعتزلة : إنما ثبتت نبوة النبي بإخبار الله عز وجل بأنه صادق ، وذلك بإظهار المعجزة على يده إظهار مستلزماً لذاك الإخبار ، إذ هو بمنزلة أن يقول تعالى : صدق في دعواه أنني أرسلته .قالوا : فإن كان العقل يجوز وقوع الكذب من الله تعالى جاز أن يكون هذا الخبر كذباً ، فلا يكون مدعي النبوة نبياً ، فتجويزكم عقلاً أن يقع الكذب من الله تعالى