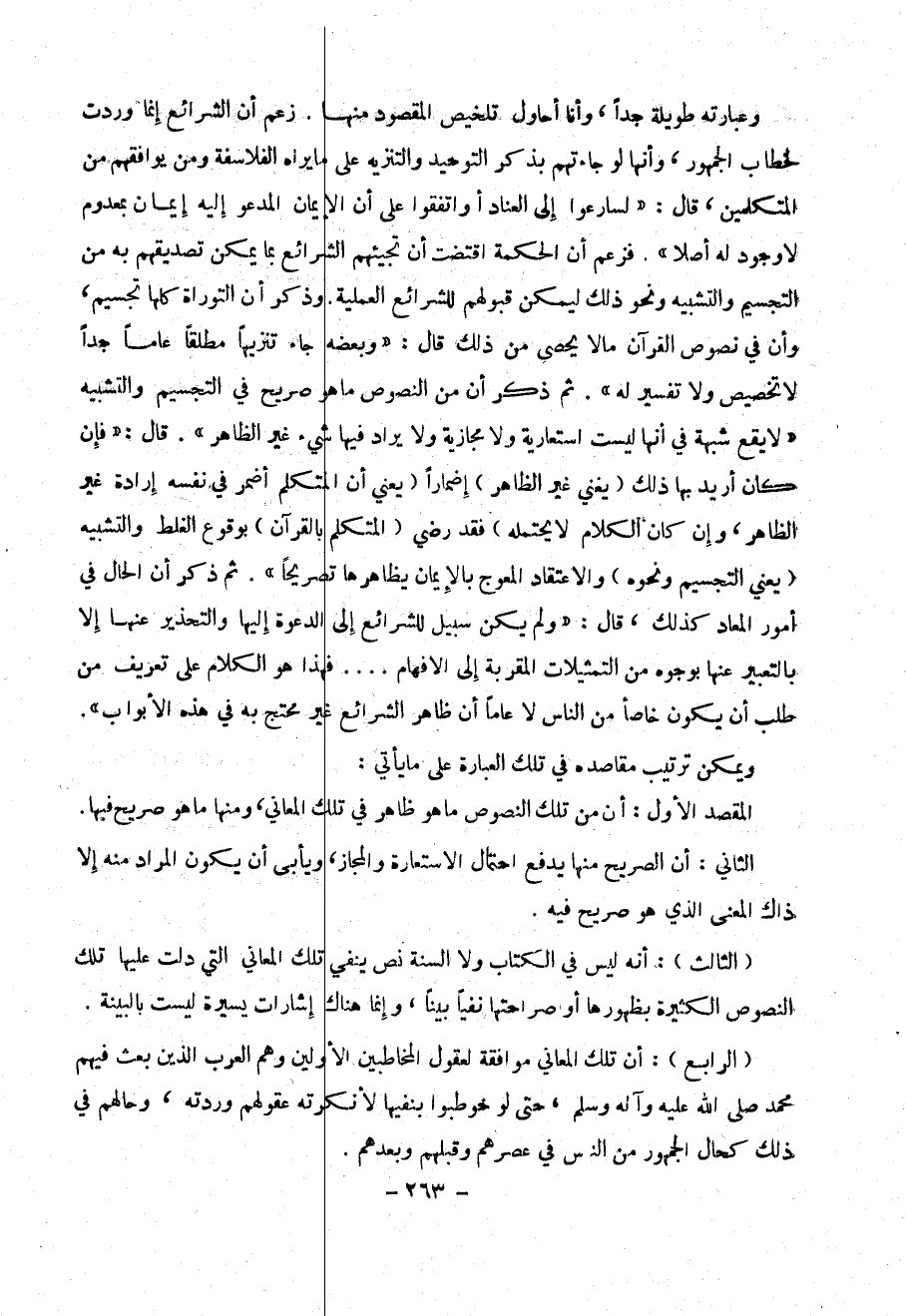
كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
و عباراته طويلة جداً ، وأنا أحاول المقصود أحاول تلخيص المقصود منها . زعم أن الشرائع إنما وردت لخطاب الجمهور ، أنها لو جائتهم بذكر التوحيد والتنزيه على ما يراه الفلاسفة ومن يوافقهم من المتكلمين ، قال : (( لسارعوا إلى العناد أو أتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه لإيمان بمعدوم لا وجود له أصلا )) . فزعم أن الحكمة اقتضت أن تجيئهم الشرائع بما يمكن تصديقهم به من التجسيم والتشبيه ونحو ذلك ليمكن قبولهم للشرائع العملية . وذكر أن التوراة كلها تجسيم وأن في نصوص القرآن ما لا يحصى من ذلك قال: (( وبعضه جاء تنيهاً مطلقاً عاماً جداً لا تخصيص ولا تفسير له )) . ثم ذكر أن من النصوص ما هو صريح في التجسيم والتشبيه (( ولا يقع شبهة في أنها ليست استعارية ولا مجازية ولا يراد فيها شئ غير الظاهر )) . قال : (( فإن كان أريد بها ذلك ( يغني غير الظاهر ) إضماراً ( يعني أن المتكلم أضمر في نفسه إرادة غير الظاهر ، وإن كان الكلام لا يحتمله ) فقد رضي ( المتكلم بالقرآن ) بوقوع الغلط والتشبيه ( يعني التجسيم ونحوه ) والاعتقاد المعوج بالإيمان يظاهرها تصريحاً )) . ثم ذكر أن الحال في أمور المعاد كذلك ، قال: (( ولم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة إليها والتحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجود من التمثيلات المقربة إلى الافهام ... . فهذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خصاً من الناس لا عاماً أن ظاهر الشرائع غير محتج به في هذه الأبواب )) .و يمكن ترتيب مقاصده في تلك العبارة على ما يا يأتي :
المقصد الأول : أن من تلك النصوص ما هو ظاهر في تلك المعاني ، ومنها ما هو صريح فيها.
الثاني : أن الصريح منها يدفع احتمال الاستعارة والمجاز ، ويأبى أن يكون المراد منه إلا ذاك المعنى الذي هو صريح فيه .
( الثالث ) : أنه ليس في الكتاب ولا السنة نص ينفي تلك المعاني التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة بظهورها أو صراحتها أو صراحتها نفياً بيناً ، وإنما هناك إشارات يسيرة ليست بالبينة .
( الرابع ) : أن تلك المعاني موافقة لعقول المخاطبين الأولين وهو العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وآله ويلم ، حتى لو خوطبوا بنفيها لأنكرته عقولهم وردته ، وحالهم في ذلك كحال الجمهور من الناس في عصرهم وقبلهم وبعدهم .