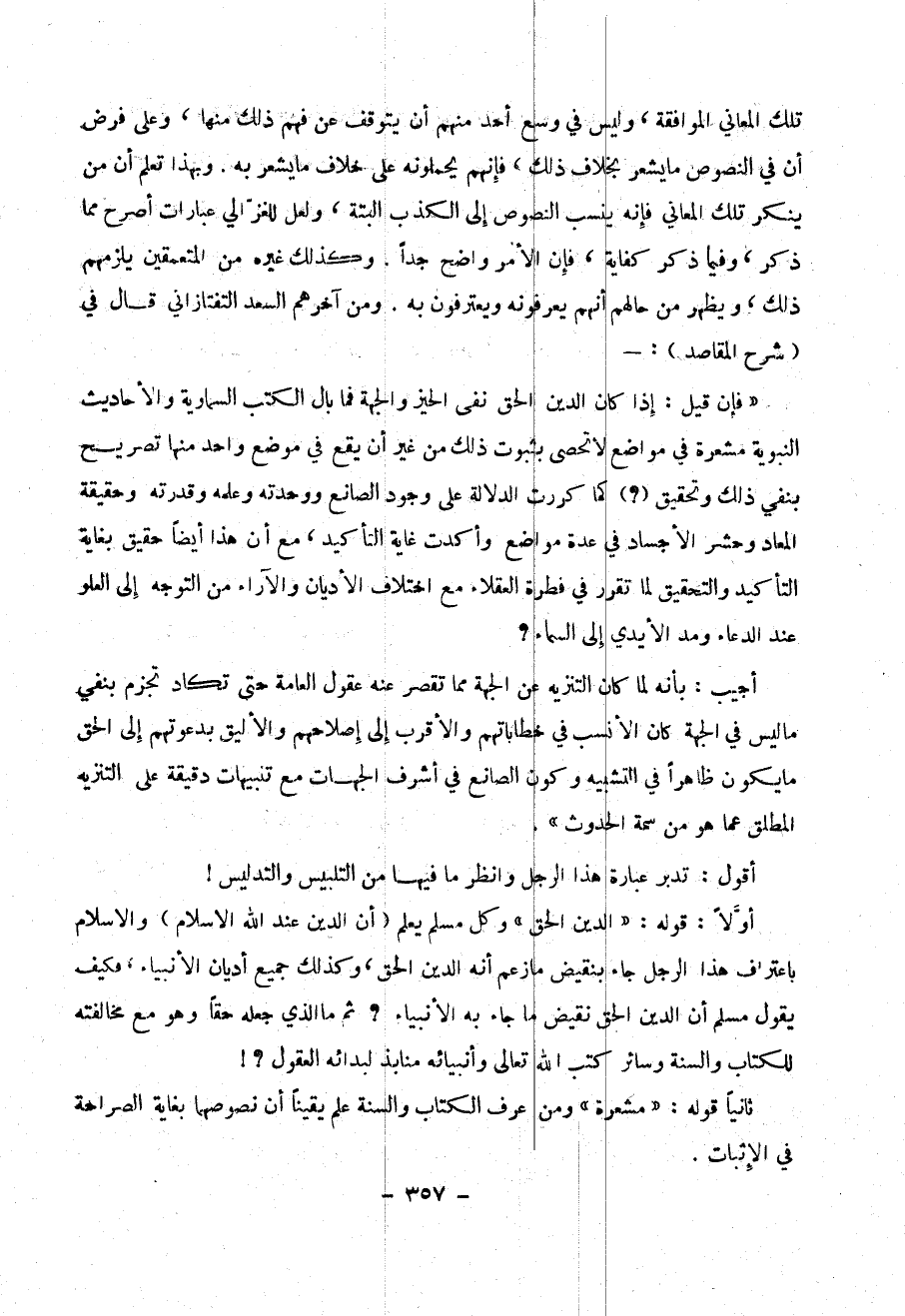
كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
تلك المعاني الموافقة، وليس في وسع أحد منهم أن يتوقف عن فهم ذلك منها، وعلى فرض أن في النصوص ما يشعر بخلاف ذلك، فإنهم يحملونه على خلاف ما يشعرون به. وبهذا تعلم أن من ينكر تلك المعاني فإنه ينسب النصوص إلى الكذب البتة، ولعل للغزالي عبارات أصرح مما ذكر، وفيما ذكر كفاية، وفإن الأمر واضح جداً. وكذلك غيره من المتعمقين يلزمهم ذلك، ويظهر من حالهم أنهم يعرفونه ويعترفون به. ومن آخرهم السعد التفتازاني قال في (شرح المقاصد): - ((فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع واحد منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق (؟) كما كررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع وأكدت غاية التأكيد، مع أن هذا أيضاً حقيق بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ومد الأيدي إلى السماء؟أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعزتهم إلى الحق ما يكون ظاهراً في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمة الحدوث)).
أقول: تدبر عبارة هذا الرجل وانظر ما فيها من التلبيس والتدليس!
أولاً: قوله: ((الدين الحق)) وكل مسلم يعلم (أن الدين عند الله الإسلام) والإسلام باعتراف هذا الرجل جاء بنقيض ما زعم أنه الدين الحق، وكذلك جميع أديان الأنبياء، فكيف يقول مسلم أن الدين الحق نقيض ما جاء به الأنبياء؟ ثم ما الذي جعله حقاً وهو مع مخالفته للكتب والسنة وسائر كتب الله تعالى وأنبيائه منابذ لبدائة العقول؟!
ثانياً قوله: ((مشعرة)) ومن عرف الكتاب والسنة علم يقيناً أن نصوصهما بغاية الصراحة في الإثبات.