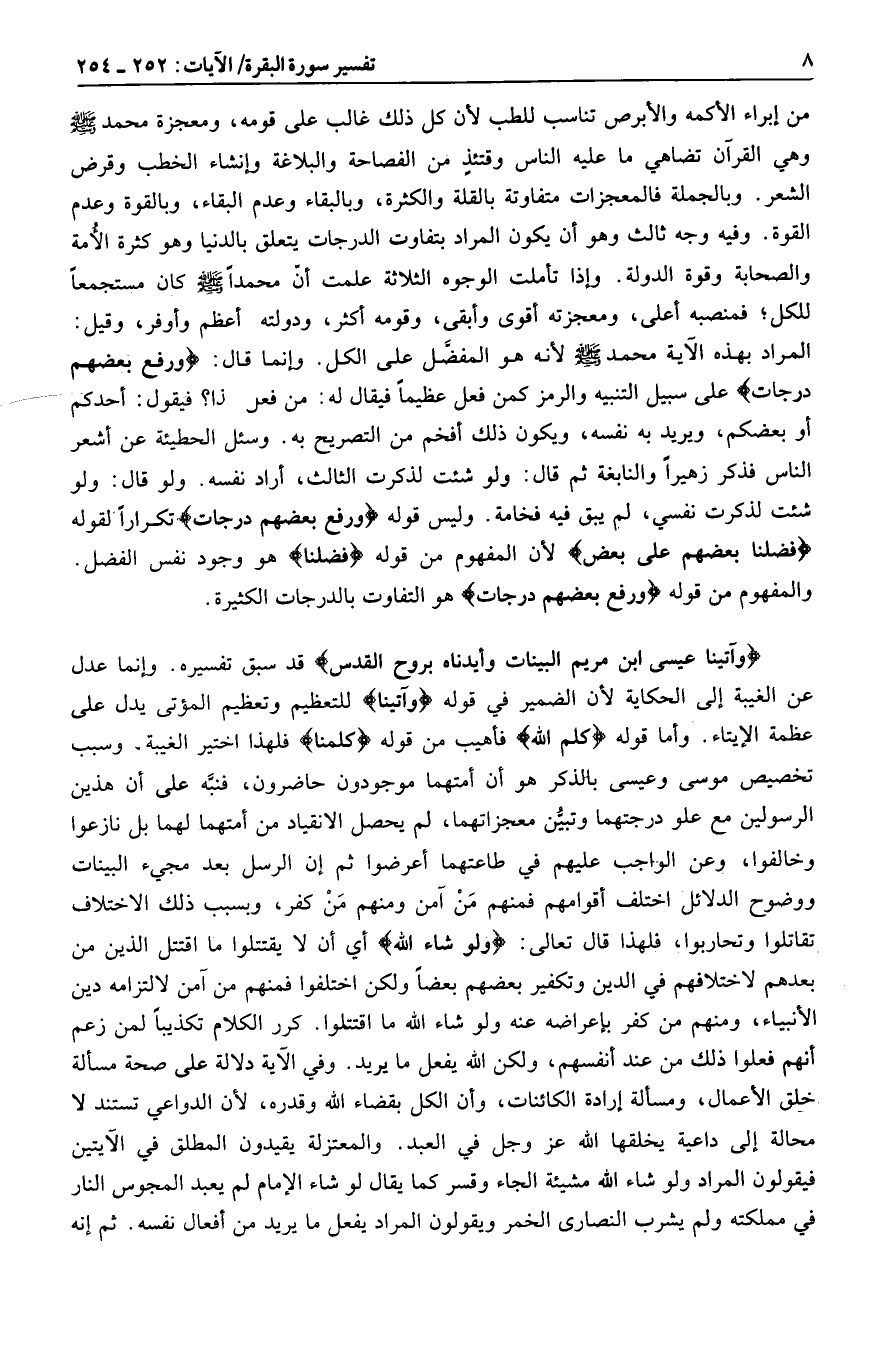
كتاب تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (اسم الجزء: 2)
من إبراء الأكمه والأبرص تناسب للطب لأن كل ذلك غالب على قومه، ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن تضاهي ما عليه الناس وقتئذ من الفصاحة والبلاغة وإنشاء الخطب وقرض الشعر. وبالجملة فالمعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة، وبالبقاء وعدم البقاء، وبالقوة وعدم القوة. وفيه وجه ثالث وهو أن يكون المراد بتفاوت الدرجات يتعلق بالدنيا وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة. وإذا تأملت الوجوه الثلاثة علمت أنّ محمدا صلى الله عليه وسلم كان مستجمعا للكل فمنصبه أعلى، ومعجزته أقوى وأبقى، وقومه أكثر، ودولته أعظم وأوفر، وقيل:المراد بهذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو المفضّل على الكل. وإنما قال: وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ على سبيل التنبيه والرمز كمن فعل عظيما فيقال له: من فعل؟؟؟ هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم، ويريد به نفسه، ويكون ذلك أفخم من التصريح به. وسئل الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيرا والنابغة ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث، أراد نفسه. ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسي، لم يبق فيه فخامة. وليس قوله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ تكرارا لقوله فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ لأن المفهوم من قوله فَضَّلْنا هو وجود نفس الفضل.
والمفهوم من قوله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ هو التفاوت بالدرجات الكثيرة.
وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قد سبق تفسيره. وإنما عدل عن الغيبة إلى الحكاية لأن الضمير في قوله وَآتَيْنا للتعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء. وأما قوله كَلَّمَ اللَّهُ فأهيب من قوله كلمنا فلهذا اختير الغيبة. وسبب تخصيص موسى وعيسى بالذكر هو أن أمتهما موجودون حاضرون، فنبّه على أن هذين الرسولين مع علو درجتهما وتبيّن معجزاتهما، لم يحصل الانقياد من أمتهما لهما بل نازعوا وخالفوا، وعن الواجب عليهم في طاعتهما أعرضوا ثم إن الرسل بعد مجيء البينات ووضوح الدلائل اختلف أقوامهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا، فلهذا قال تعالى: وَلَوْ شاءَ اللَّهُ أي أن لا يقتتلوا ما اقتتل الذين من بعدهم لاختلافهم في الدين وتكفير بعضهم بعضا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن لالتزامه دين الأنبياء، ومنهم من كفر بإعراضه عنه ولو شاء الله ما اقتتلوا. كرر الكلام تكذيبا لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم، ولكن الله يفعل ما يريد. وفي الآية دلالة على صحة مسألة خلق الأعمال، ومسألة إرادة الكائنات، وأن الكل بقضاء الله وقدره، لأن الدواعي تستند لا محالة إلى داعية يخلقها الله عز وجل في العبد. والمعتزلة يقيدون المطلق في الآيتين فيقولون المراد ولو شاء الله مشيئة الجاء وقسر كما يقال لو شاء الإمام لم يعبد المجوس النار في مملكته ولم يشرب النصارى الخمر ويقولون المراد يفعل ما يريد من أفعال نفسه. ثم إنه