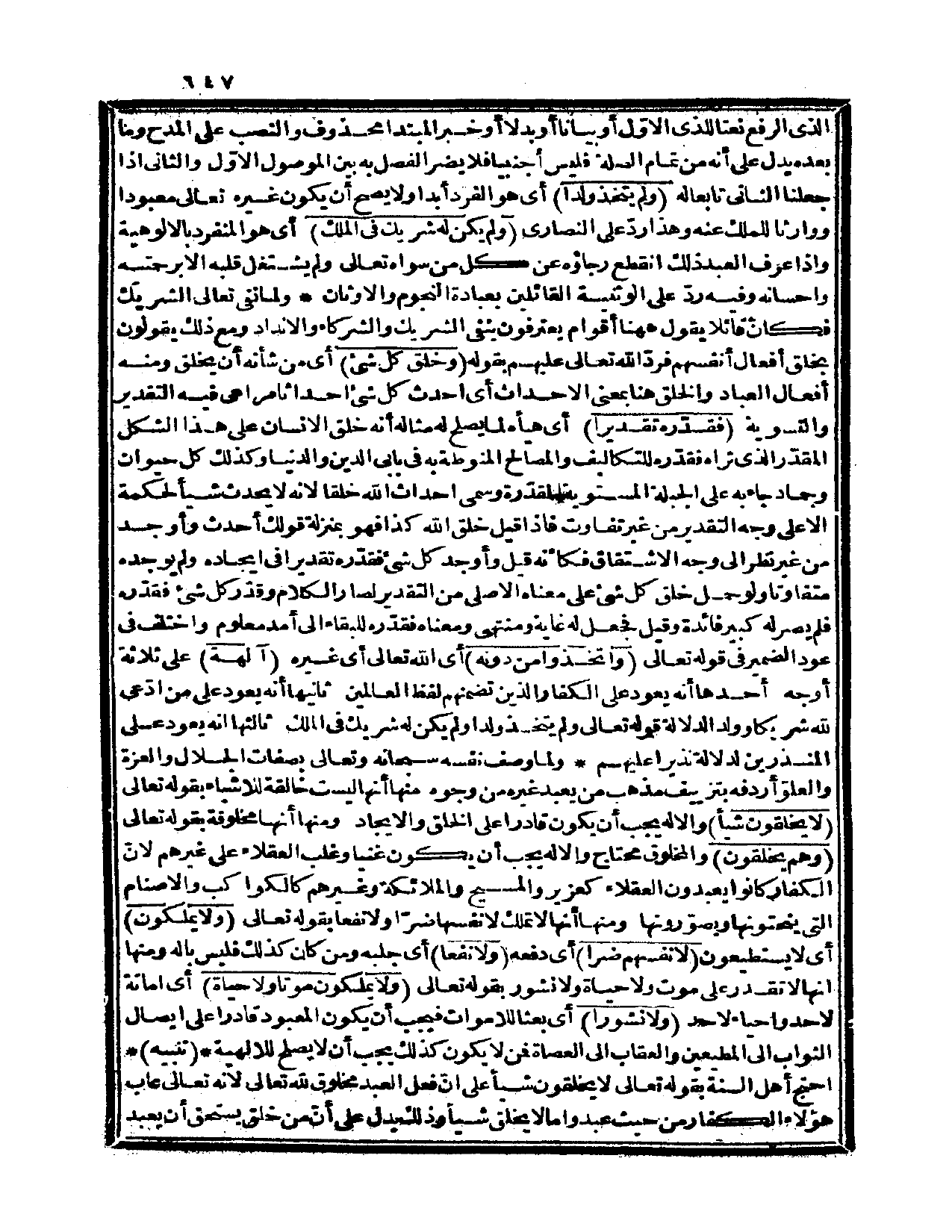
كتاب السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (اسم الجزء: 2)
الذي الرفع نعتاً للذي الأول أو بياناً أو بدلاً، أو خبراً لمبتدأ محذوف والنصب على المدح، وما بعده يدل على أنه من تمام الصلة، فليس أجنبياً فلا يضر الفصل به بين الموصول الأول والثاني إذا جعلنا الثاني تابعاً له {ولم يتخذ ولداً} أي: هو الفرد أبداً ولا يصح أن يكون غيره تعالى معبوداً ووارثاً للملك عنه، وهذا رد على النصارى، {ولم يكن له شريك في الملك} أي: هو المنفرد بالألوهية، وإذا عرف العبد ذلك انقطع رجاؤه عن كل من سواه تعالى ولم يشتغل قلبه إلا برحمته وإحسانه، وفيه ردّ على الوثنية القائلين بعبادةالنجوم والأوثان، ولما نفى تعالى الشريك، فكأن قائلاً يقول: هاهنا أقوام يعترفون بنفي الشريك والشركاء والأنداد ومع ذلك يقولون: يخلق أفعال أنفسهم، فرد الله تعالى عليهم بقوله: {وخلق كل شيء} أي: من شأنه أن يخلق ومنه أفعال العباد، والخلق هنا بمعنى الإحداث أي: أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية {فقدره تقديراً} أي: هيأه لما يصلح له، مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر الذي تراه، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدرة، وسمي إحداث الله خلقاً؛ لأنه لا يحدث شيئاً لحكمة إلا على وجه التقدير من غير تفاوت.فإذا قيل: خلق الله كذا، فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق، فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره تقديراً في إيجاده، ولم يوجده متفاوتاً، ولو حمل خلق كل شيء على معناه الأصلي من التقدير لصار الكلام: وقدر كل شيء فقدره، فلم يصر له كبير فائدة، وقيل: فجعل له غاية ومنتهى ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد معلوم، واختلف في عود الضمير في قوله تعالى:
{واتخذوا من دونه} أي: الله تعالى أي: غيره {آلهة} على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يعود على الكفار الذين تضمنهم لفظ العالمين.
ثانيها: أنه يعود على من ادعى لله شريكاً وولداً لدلالة قوله تعالى: {ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك} .
ثالثها: أنه يعود على المنذرين لدلالة نذيراً عليهم، ولما وصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والعزة والعلو أردفه بتزييف مذهب من يعبد غيره من وجوه منها: أنها ليست خالقة للأشياء بقوله تعالى: {لا يخلقون شيئاً} والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد، ومنها: أنها مخلوقة بقوله تعالى: {وهم يخلقون} والمخلوق محتاج والإله يجب أن يكون غنياً، وغلب العقلاء على غيرهم؛ لأن الكفار كانوا يعبدون العقلاء كعزير والمسيح والملائكة، وغيرهم كالكواكب والأصنام التي ينحتونها ويصورونها، ومنها: أنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً بقوله تعالى: {ولا يملكون} أي: لا يستطيعون {لأنفسهم ضراً} أي: دفعه {ولا نفعاً} أي: جلبه ومن كان كذلك، فليس بإله، ومنها: أنها لا تقدر على موت ولا حياة ولا نشور بقوله تعالى: {ولا يملكون موتاً ولا حياة} أي: إماتة لأحد وإحياء لأحد {ولا نشوراً} أي: بعثاً للأموات، فيجب أن يكون المعبود قادراً على إيصال الثواب إلى المطيعين، والعقاب إلى العصاة، فمن لا يكون كذلك يجب أن لا يصلح للإلهية.
تنبيه: احتج أهل السنة بقوله تعالى: {لايخلقون شيئاً} على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى؛ لأنه تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث عبدوا ما لا يخلق شيئاً، وذلك يدل على أن من خلق يستحق أن يعبد،