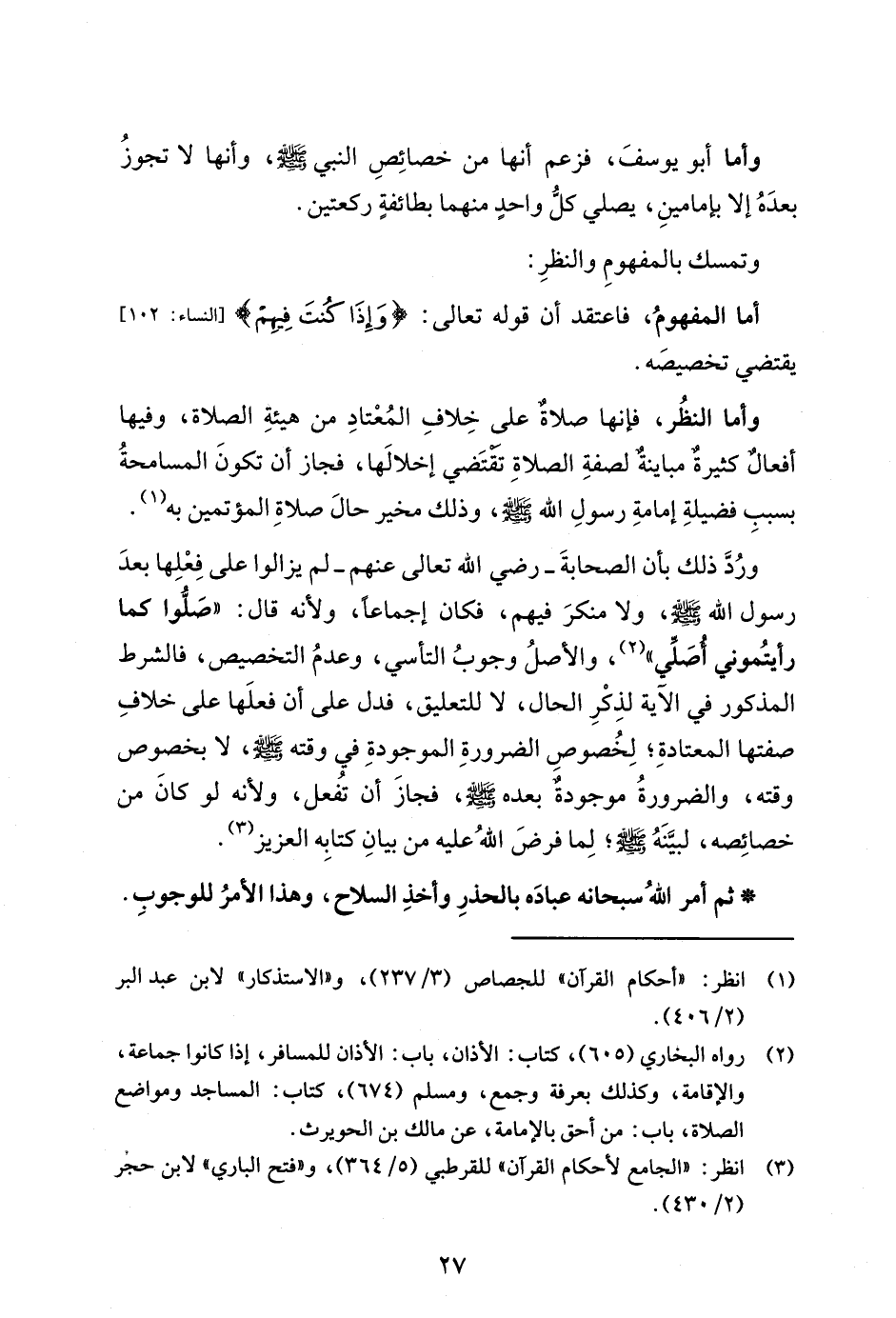
كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)
وأما أبو يوسفَ، فزعم أنها من خصائِصِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنها لا تجوزُ بعدَهُ إلا بإمامينِ، يصلي كلُّ واحدٍ منهما بطائفةٍ ركعتين.وتمسك بالمفهومِ والنظرِ:
أما المفهومُ، فاعتقد أن قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} [النساء: 102] يقتضي تخصيصَه.
وأما النظُر، فإنها صلاةٌ على خِلافِ المُعْتادِ من هيئةِ الصلاة، وفيها أفعال كثيرة مباينة لصفةِ الصلاةِ تقتَضي إخلالَها، فجاز أن تكونَ المسامحةُ بسببِ فضيلةِ إمامةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مخير حالَ صلاةِ المؤتمين به (¬1).
ورُدَّ ذلك بأن الصحابةَ -رضي الله تعالى عنهم- لم يزالوا على فِعْلِها بعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا منكرَ فيهم، فكان إجماعاً، ولأنه قال: "صَلُّوا كما رأيتُموني أصَلِّي" (¬2)، والأصلُ وجوبُ التأسي، وعدمُ التخصيص، فالشرط المذكور في الآية لذِكْرِ الحال، لا للتعليق، فدل على أن فعلَها على خلافِ صفتها المعتادةِ؛ لِخُصوصِ الضرورةِ الموجودةِ في وقته - صلى الله عليه وسلم -، لا بخصوص وقته، والضرورةُ موجودة بعده - صلى الله عليه وسلم -، فجازَ أن تُفعل، ولأنه لو كانَ من خصائِصه، لبينَهُ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِما فرضَ اللهُ عليه من بيانِ كتابِه العزيز (¬3).
* ثم أمر اللهُ سبحانه عبادَه بالحذرِ وأخذِ السلاح، وهذا الأمرُ للوجوبِ.
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 237)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 406).
(¬2) رواه البخاري (605)،كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، ومسلم (674)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة، عن مالك بن الحويرث.
(¬3) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 364)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 430).