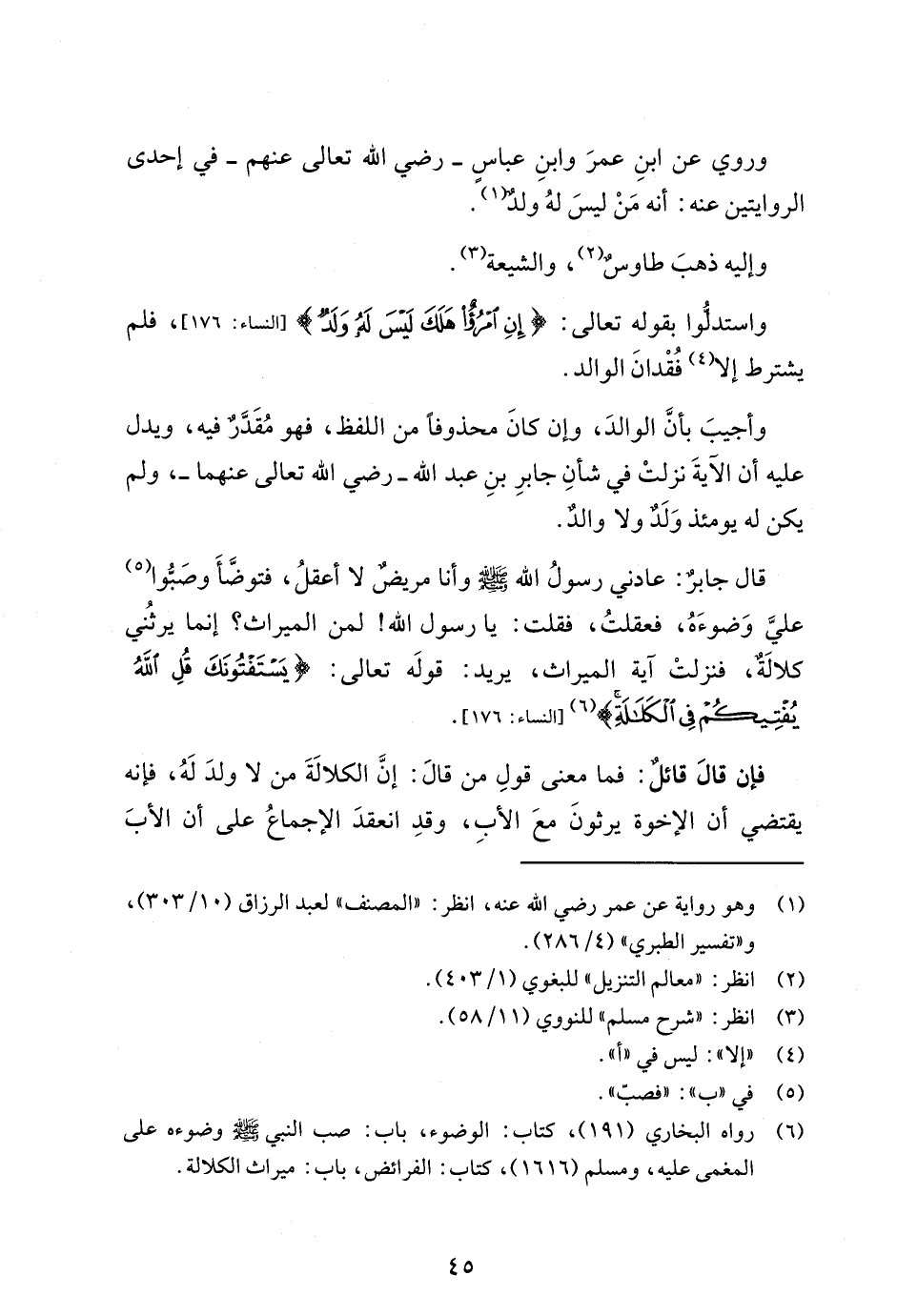
كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)
وروي عن ابنِ عمرَ وابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهم- في إحدى الروايتين عنه: أنه مَنْ ليسَ لهُ ولد (¬1).وإليه ذهبَ طاوسٌ (¬2)، والشيعة (¬3).
واستدلُّوا بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176]، فلم يشترط إلا (¬4) فُقْدانَ الوالد.
وأجيبَ بأنَّ الوالدَ، وإن كانَ محذوفاً من اللفظ، فهو مُقَدَّرٌ فيه، ويدل عليه أن الآيةَ نزلتْ في شأنِ جابرِ بنِ عبد الله -رضي الله تعالى عنهما-، ولم يكن له يومئذ وَلَدٌ ولا والدٌ.
قال جابرٌ: عادني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضٌ لا أعقلُ، فتوضَّأَ وصَبّوا (¬5) عليَّ وَضوءَهُ، فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث؟ إنما يرثنُي كلالَةٌ، فنزلتْ آية الميراث، يريد: قولَه تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (¬6) [النساء: 176].
فإن قالَ قائلٌ: فما معنى قولِ من قالَ: إنَّ الكلالَةَ من لا ولدَ لَهُ، فإنه يقتضي أن الإخوة يرثونَ معَ الأبِ، وقدِ انعقدَ الإجماعُ على أن الأبَ
¬__________
(¬1) وهو رواية عن عمر رضي الله عنه، انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (10/ 303)، و"تفسير الطبري" (4/ 286).
(¬2) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 403).
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 58).
(¬4) "إلا": ليس في "أ".
(¬5) في "ب": "فصبّ".
(¬6) رواه البخاري (191)، كتاب: الوضوء، باب: صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه، ومسلم (1616)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة.