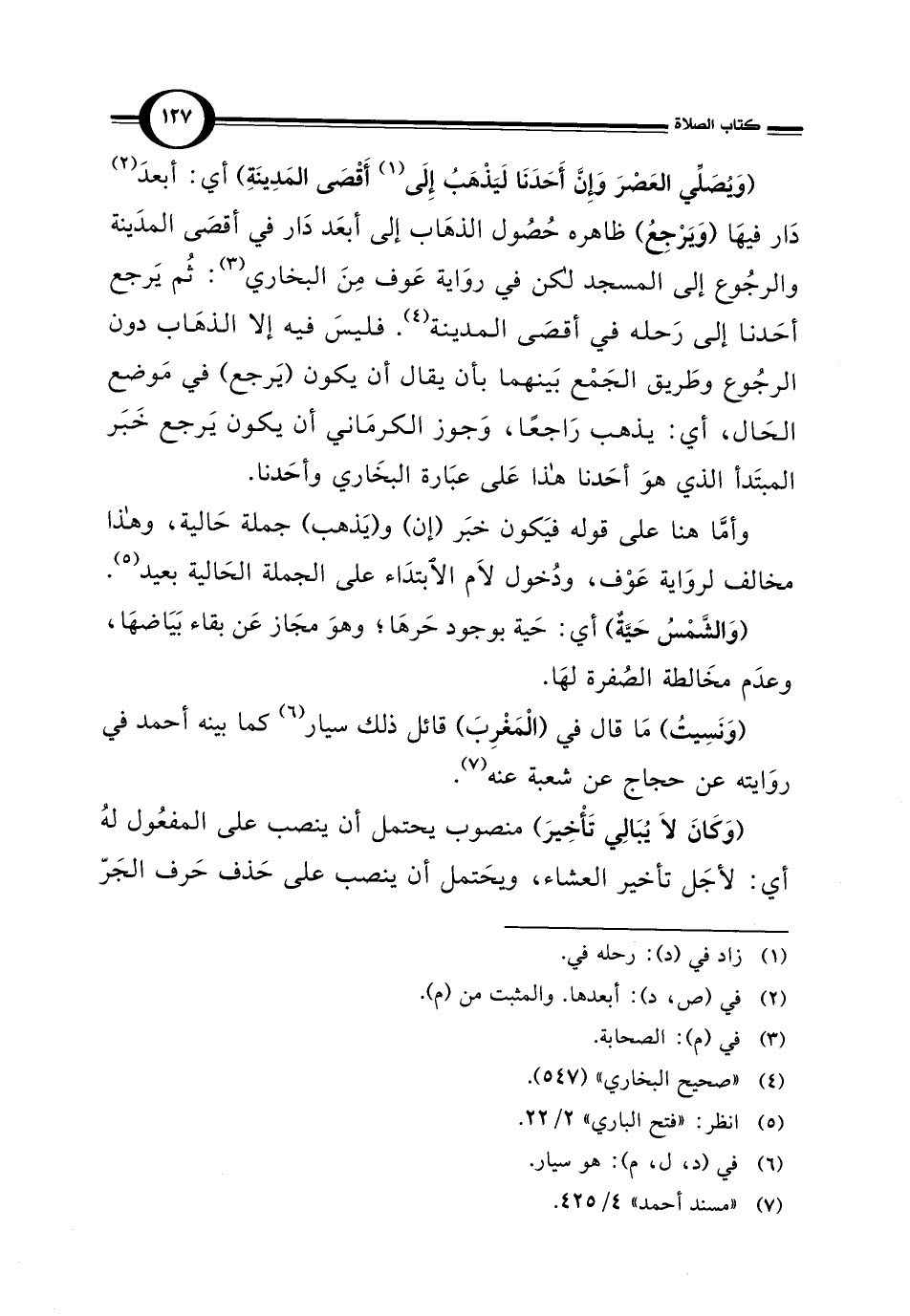
كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
(وَيُصَلِّي العَصْرَ وَإنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى (¬1) أَقْصَى المَدِينَةِ) أي: أبعدَ (¬2) دَار فيهَا (وَيَرْجِعُ) ظاهره حُصُول الذهَاب إلى أبعَد دَار في أقصَى المدَينة والرجُوع إلى المسجد لكن في روَاية عَوف مِنَ البخاري (¬3): ثُم يَرجع أحَدنا إلى رَحله في أقصَى المدينة (¬4). فليسَ فيه إلا الذهَاب دون الرجُوع وطَريق الجَمْع بَينهما بأن يقال أن يكون (يَرجع) في مَوضع الحَال، أي: يذهب رَاجعًا، وَجوز الكرمَاني أن يكون يَرجع خَبَر المبتَدأ الذي هوَ أحَدنا هذا عَلى عبَارة البخَاري وأحَدنا.وأمَّا هنا على قوله فيَكون خبَر (إن) و (يَذهب) جملة حَالية، وهذا مخالف لروَاية عَوْف، ودُخول لَام الابتدَاء على الجملة الحَالية بعيد (¬5).
(وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) أي: حَية بوجود حَرهَا؛ وهوَ مجَاز عَن بقاء بَيَاضهَا، وعدَم مخَالطة الصُفرة لهَا.
(وَنَسِيتُ) مَا قال في (الْمَغْرِبَ) قائل ذلك سيار (¬6) كما بينه أحمد في روَايته عن حجاج عن شعبة عنه (¬7).
(وَكانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ) منصوب يحتمل أن ينصب على المفعُول لهُ أي: لأجَل تأخير العشاء، ويحَتمل أن ينصب على حَذف حَرف الجَرّ
¬__________
(¬1) زاد في (د): رحله في.
(¬2) في (ص، د): أبعدها. والمثبت من (م).
(¬3) في (م): الصحابة.
(¬4) "صحيح البخاري" (547).
(¬5) انظر: "فتح الباري" 2/ 22.
(¬6) في (د، ل، م): هو سيار.
(¬7) "مسند أحمد" 4/ 425.