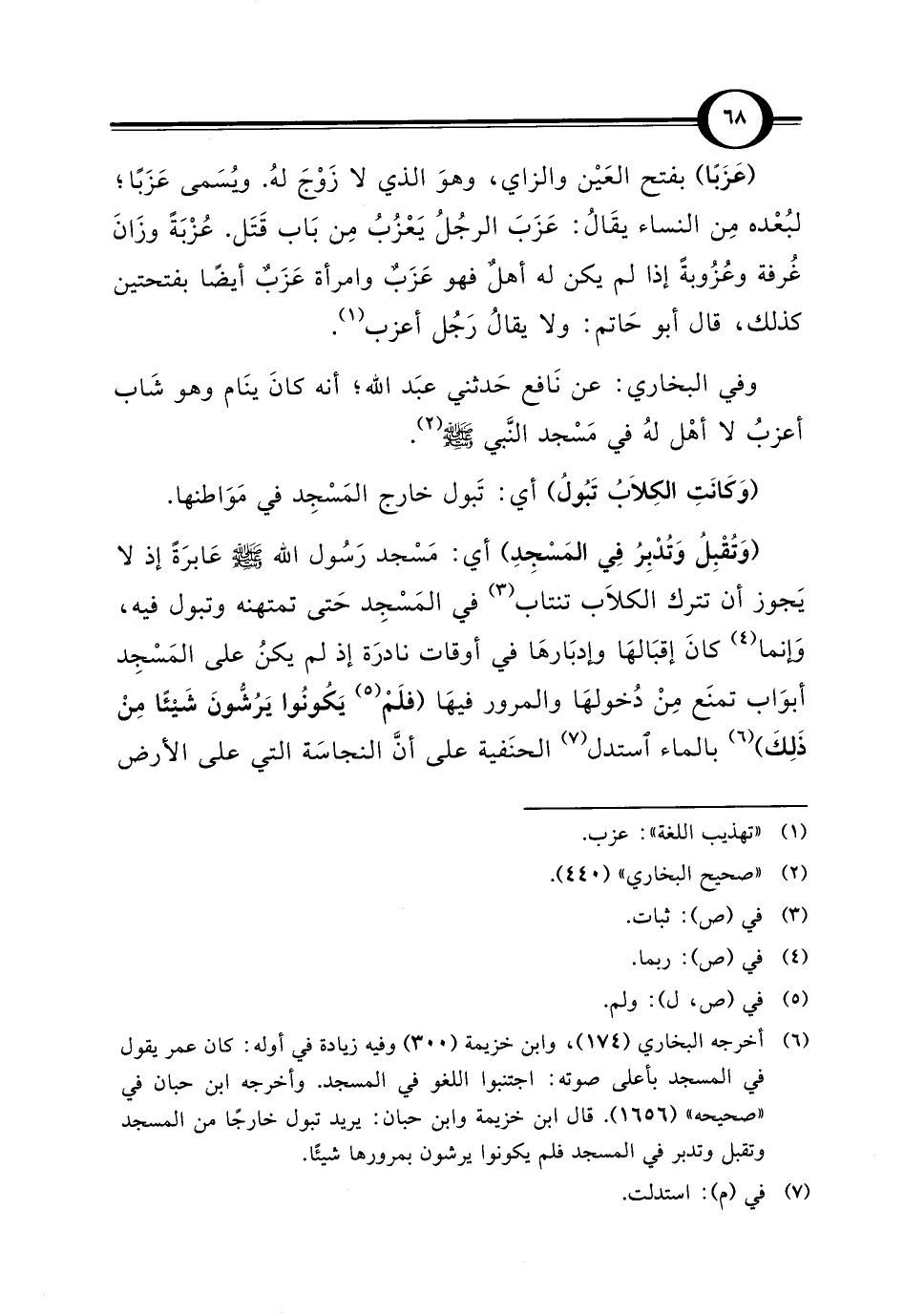
كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
(عَزَبًا) بفتح العَيْن والزاي، وهوَ الذي لا زَوْجَ لهُ. ويُسَمى عَزَبًا؛ لبُعْده مِن النساء يقَالُ: عَزَبَ الرجُلُ يَعْزُبُ مِن بَاب قَتَل. عُزْبَةً وزَانَ غُرفة وعُزُوبةً إذا لم يكن له أهل فهو عَزَبٌ وامرأة عَزَبٌ أيضًا بفتحتين كذلك، قال أبو حَاتم: ولا يقالُ رَجُل أعزب (¬1).وفي البخاري: عن نَافع حَدثني عبَد الله؛ أنه كانَ ينَام وهو شَاب أعزبُ لا أهْل لهُ في مَسْجد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
(وَكَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ) أي: تَبول خارج المَسْجِد في مَوَاطنها.
(وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ) أي: مَسْجد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَابرَةً إذ لا يَجوز أن تترك الكلَاب تنتاب (¬3) في المَسْجِد حَتى تمتهنه وتبول فيه، وَإنما (¬4) كانَ إقبَالهَا وإدبَارهَا في أوقات نادرَة إذ لم يكنُ على المَسْجِد أبوَاب تمنَع مِنْ دُخولهَا والمرور فيهَا (فلَمْ (¬5) يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) (¬6) بالماء استدل (¬7) الحنَفية على أنَّ النجاسَة التي على الأرض
¬__________
(¬1) "تهذيب اللغة": عزب.
(¬2) "صحيح البخاري" (440).
(¬3) في (ص): ثبات.
(¬4) في (ص): ربما.
(¬5) في (ص، ل): ولم.
(¬6) أخرجه البخاري (174)، وابن خزيمة (300) وفيه زيادة في أوله: كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1656). قال ابن خزيمة وابن حبان: يريد تبول خارجًا من المسجد وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون بمرورها شيئًا.
(¬7) في (م): استدلت.