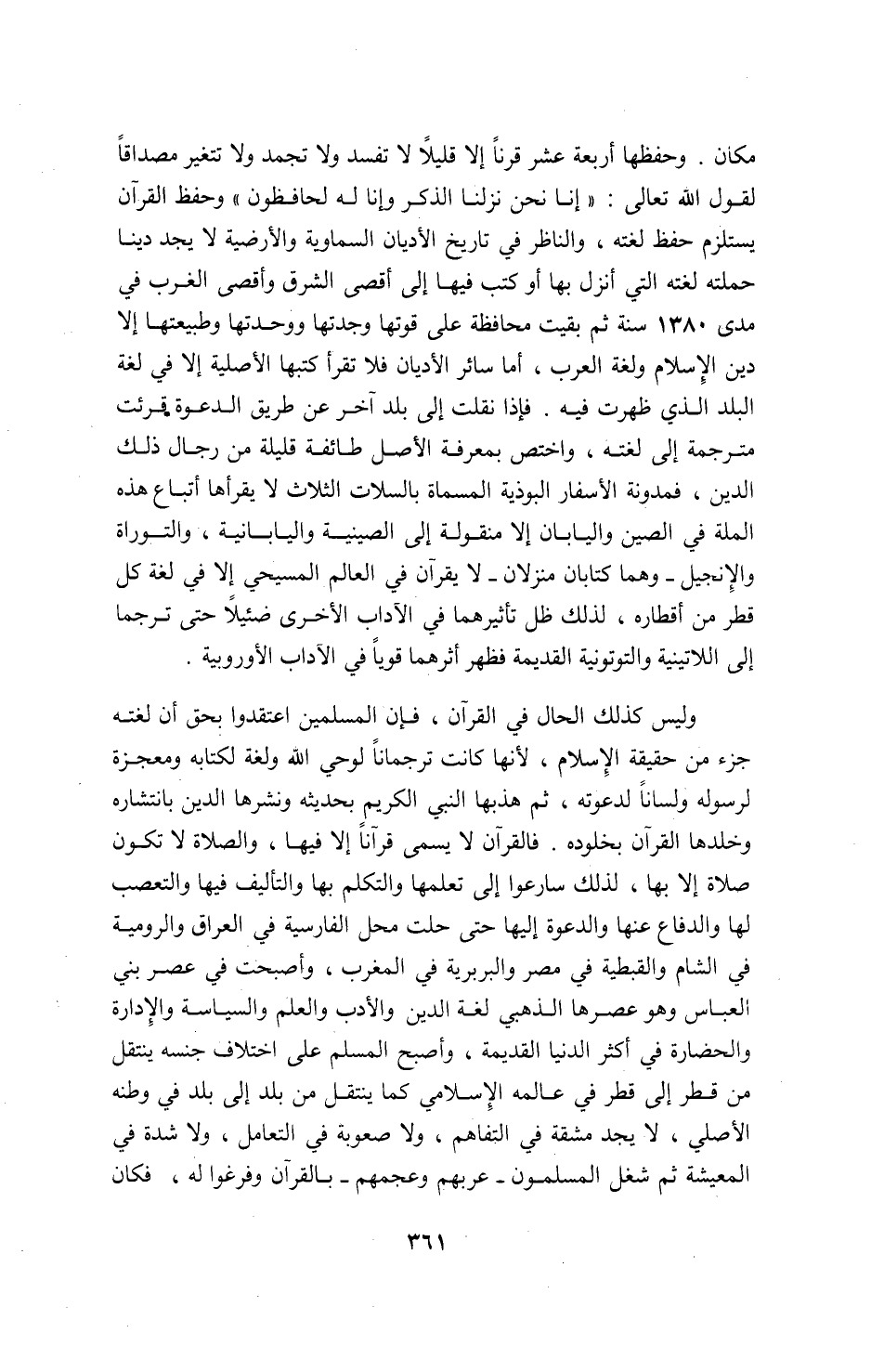
كتاب الأزهر في ألف عام (اسم الجزء: 3)
مكان. وحفظها أربعة عشر قرنا إلا قليلا لا تفسد ولا تجمد ولا تتغير مصداقا لقول اللّه تعالى: «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ» وحفظ القرآن يستلزم حفظ لغته، والناظر في تاريخ الأديان السماوية والأرضية لا يجد دينا حملته لغته التي أنزل بها أو كتب فيها إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب في مدى 1380 سنة ثم بقيت محافظة على قوتها وجدتها ووحدتها وطبيعتها إلا دين الإسلام ولغة العرب، أما سائر الأديان فلا تقرأ كتبها الأصلية إلا في لغة البلد الذي ظهرت فيه. فإذا نقلت إلى بلد آخر عن طريق الدعوة قرئت مترجمة إلى لغته، واختص بمعرفة الأصل طائفة قليلة من رجال ذلك الدين، فمدونة الأسفار البوذية المسماة بالسلات الثلاث لا يقرأها أتباع هذه الملة في الصين واليابان إلا منقولة إلى الصينية واليابانية، والتوراة والإنجيل-و هما كتابان منزلان-لا يقرآن في العالم المسيحي إلا في لغة كل قطر من أقطاره، لذلك ظل تأثيرهما في الآداب الأخرى ضئيلا حتى ترجما إلى اللاتينية والتوتونية القديمة فظهر أثرهما قويا في الآداب الأوروبية.وليس كذلك الحال في القرآن، فإن المسلمين اعتقدوا بحق أن لغته جزء من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي اللّه ولغة لكتابه ومعجزة لرسوله ولسانا لدعوته، ثم هذبها النبي الكريم بحديثه ونشرها الدين بانتشاره وخلدها القرآن بخلوده. فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا فيها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها، لذلك سارعوا إلى تعلمها والتكلم بها والتأليف فيها والتعصب لها والدفاع عنها والدعوة إليها حتى حلت محل الفارسية في العراق والرومية في الشام والقبطية في مصر والبربرية في المغرب، وأصبحت في عصر بني العباس وهو عصرها الذهبي لغة الدين والأدب والعلم والسياسة والإدارة والحضارة في أكثر الدنيا القديمة، وأصبح المسلم على اختلاف جنسه ينتقل من قطر إلى قطر في عالمه الإسلامي كما ينتقل من بلد إلى بلد في وطنه الأصلي، لا يجد مشقة في التفاهم، ولا صعوبة في التعامل، ولا شدة في المعيشة ثم شغل المسلمون-عربهم وعجمهم-بالقرآن وفرغوا له، فكان