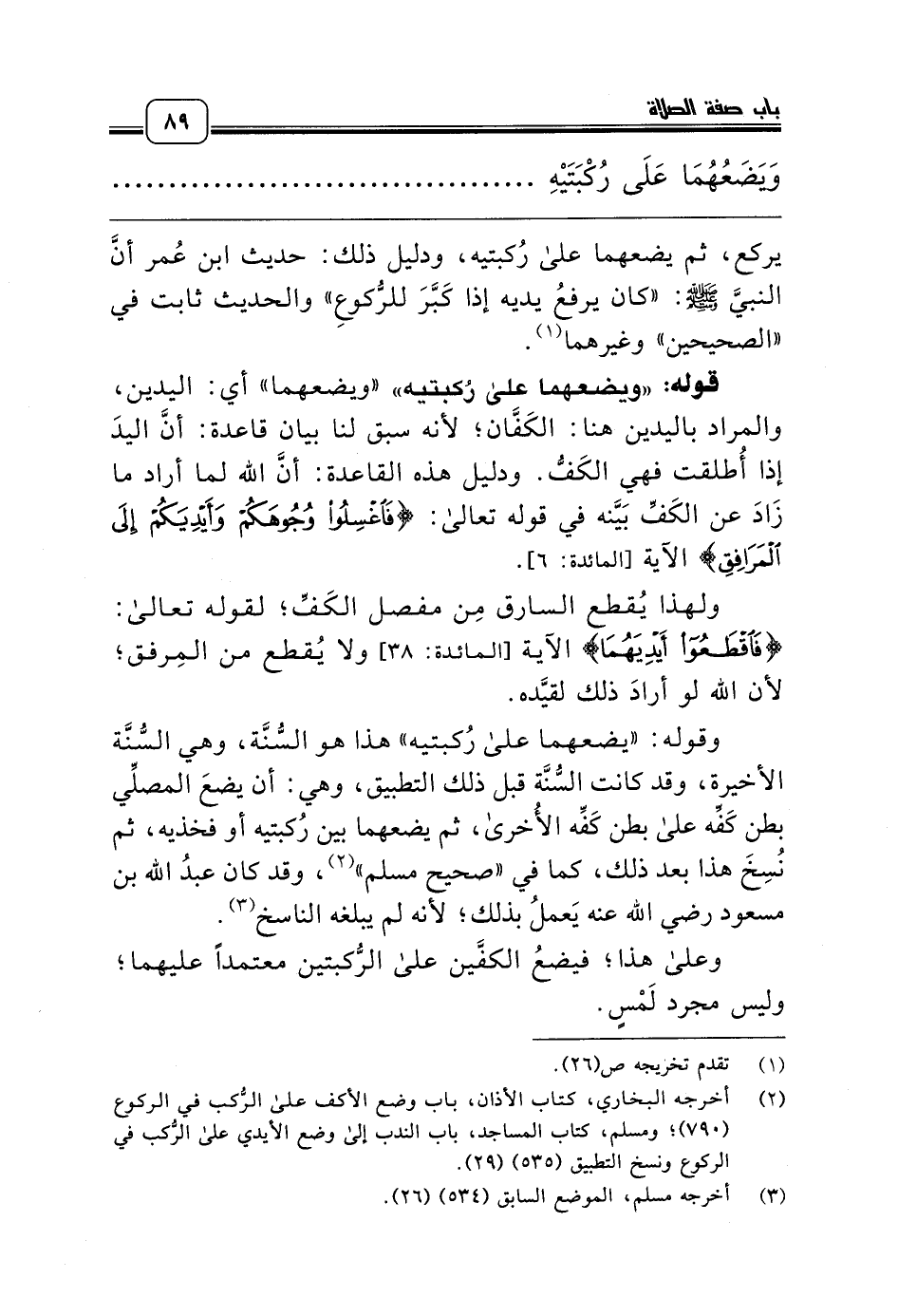
كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 3)
يركع، ثم يضعهما على رُكبتيه، ودليل ذلك: حديث ابن عُمر أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «كان يرفعُ يديه إذا كَبَّرَ للرُّكوعِ» والحديث ثابت في «الصحيحين» وغيرهما (¬1).قوله: «ويضعهما على رُكبتيه» «ويضعهما» أي: اليدين، والمراد باليدين هنا: الكَفَّان؛ لأنه سبق لنا بيان قاعدة: أنَّ اليدَ إذا أُطلقت فهي الكَفُّ. ودليل هذه القاعدة: أنَّ الله لما أراد ما زَادَ عن الكَفِّ بَيَّنه في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية [المائدة: 6].
ولهذا يُقطع السارق مِن مفصل الكَفِّ؛ لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} الآية [المائدة: 38] ولا يُقطع من المِرفق؛ لأن الله لو أرادَ ذلك لقيَّده.
وَيَضَعُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الأَصَابِع، ............
وقوله: «يضعهما على رُكبتيه» هذا هو السُّنَّة، وهي السُّنَّة الأخيرة، وقد كانت السُّنَّة قبل ذلك التطبيق، وهي: أن يضعَ المصلِّي بطن كَفِّه على بطن كَفِّه الأُخرى، ثم يضعهما بين رُكبتيه أو فخذيه، ثم نُسِخَ هذا بعد ذلك، كما في «صحيح مسلم» (¬2)، وقد كان عبدُ الله بن مسعود رضي الله عنه يَعملُ بذلك؛ لأنه لم يبلغه الناسخ (¬3).
وعلى هذا؛ فيضعُ الكفَّين على الرُّكبتين معتمداً عليهما؛ وليس مجرد لَمْسٍ.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه ص (26).
(¬2) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وضع الأكف على الرُّكب في الركوع (790)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الرُّكب في الركوع ونسخ التطبيق (535) (29).
(¬3) أخرجه مسلم، الموضع السابق (534) (26).