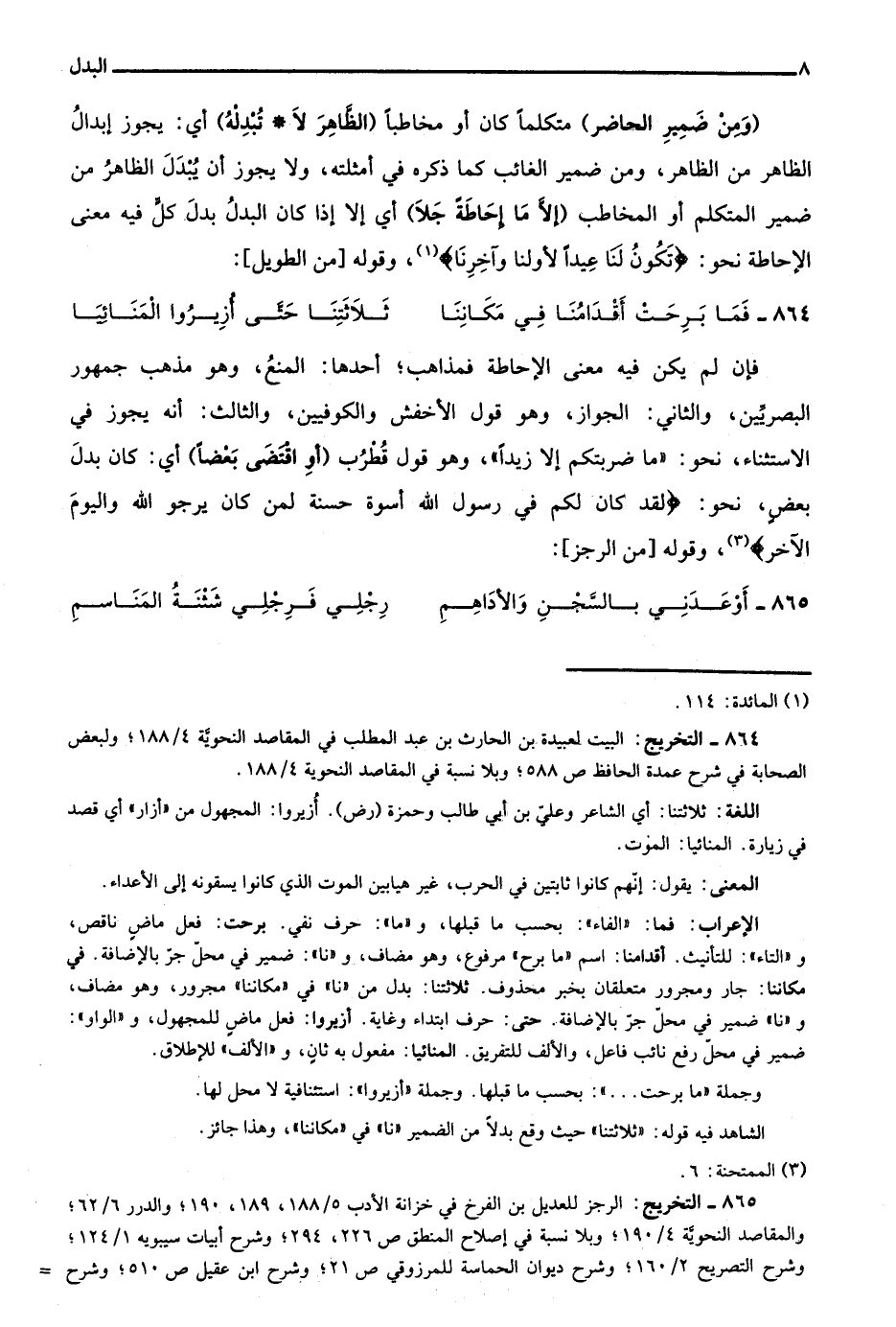
كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (اسم الجزء: 3)
"ومن ضمير الحاضر" متكلمًا كان أو مخاطبًا "الظاهر لا تبدله " أي: يجوز إبدال الظاهر من الظاهر، ومن ضمير الغائب كما ذكره في أمثلة، ولا يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب "إلاَّ مَا إحَاطَةً جَلاَ" أي إلا إذا كان البدل بدل كل فيه معنى الإحاطة نحو: {تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا} 1 وقوله "من الطويل":864-
فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا فِي مَقَامِنَا ... ثَلاَثَتُنَا حَتَّى أُزِيرُوا المَنَائِيَا
فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة فمذاهب: أحدها المنع وهو مذهب جمهور البصريين، والثاني الجواز وهو قول الأخفش والكوفيين، والثالث: أنه يجوز في الاستثناء نحو ما ضربتكم إلا زيدًا وهو قول قطرب "أَو اقْتَضَى بَعْضًا" أي كان بدل بعض نحو: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} 2 وقوله "من الرجز":
865-
أَوعَدَنِي بِالسِّجْنِ وَالأَدَاهِمِ ... رِجْلِي فَرِجْلِي شَثْنَةُ المَنَاسِمِ
__________
1 المائدة: 114.
864- التخريج: البيت لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في المقاصد النحوية 4/ 188؛ ولبعض الصحابة في شرح عمدة الحافظ ص588؛ وبلا نسبة في المقاصد النحوية 4/ 188.
اللغة: ثلاثتنا: أي الشاعر وعلي بن أبي طالب وحمزة -رضي الله عنهما- أزيروا: المجهول من "أزار" أي قصد في زيارة. المنائيا: الموت.
المعنى: يقول: إنهم كانوا ثابتين في الحرب؛ غير هيابين الموت الذي كانوا يسقونه إلى الأعداء.
و"التاء": للتأنيث. أقدامنا: اسم "ما برح" مرفوع، وهو مضاف، و"نا": ضمير في محل جر بالإضافة. في مكاننا: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. ثلاثتنا: بدل من "نا" في "مكاننا" مجرور، وهو مضاف، و"نا" ضمير في محل جر بالإضافة. حتى: حرف ابتداء وغاية. أزيروا: فعل ماض للمجهول، و"الواو": ضمير في محل رفع نائب فاعل، والألف للتفريق. المنائيا: مفعول به ثان، و"الألف" للإطلاق.
وجملة "ما برحت ... ": بحسب ما قبلها وجملة "أزيروا": استئنافية لا محل لها.
الشاهد فيه قوله: "ثلاثتنا" حيث وقع بدلًا من الضمير "نا" في "مكاننا" وهذا جائز.
3 الممتحنة: 6.
865- التخريج: الرجز للعديل بن الفرخ في خزانة الأدب 5/ 188، 189، 190؛ والدرر 6/ 62؛ والمقاصد النحوية 4/ 190؛ وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص226، 294؛ وشرح أبيات سيبويه 1/ 124؛ وشرح التصريح 2/ 160؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص21؛ وشرح ابن عقيل ص510؛ وشرح =