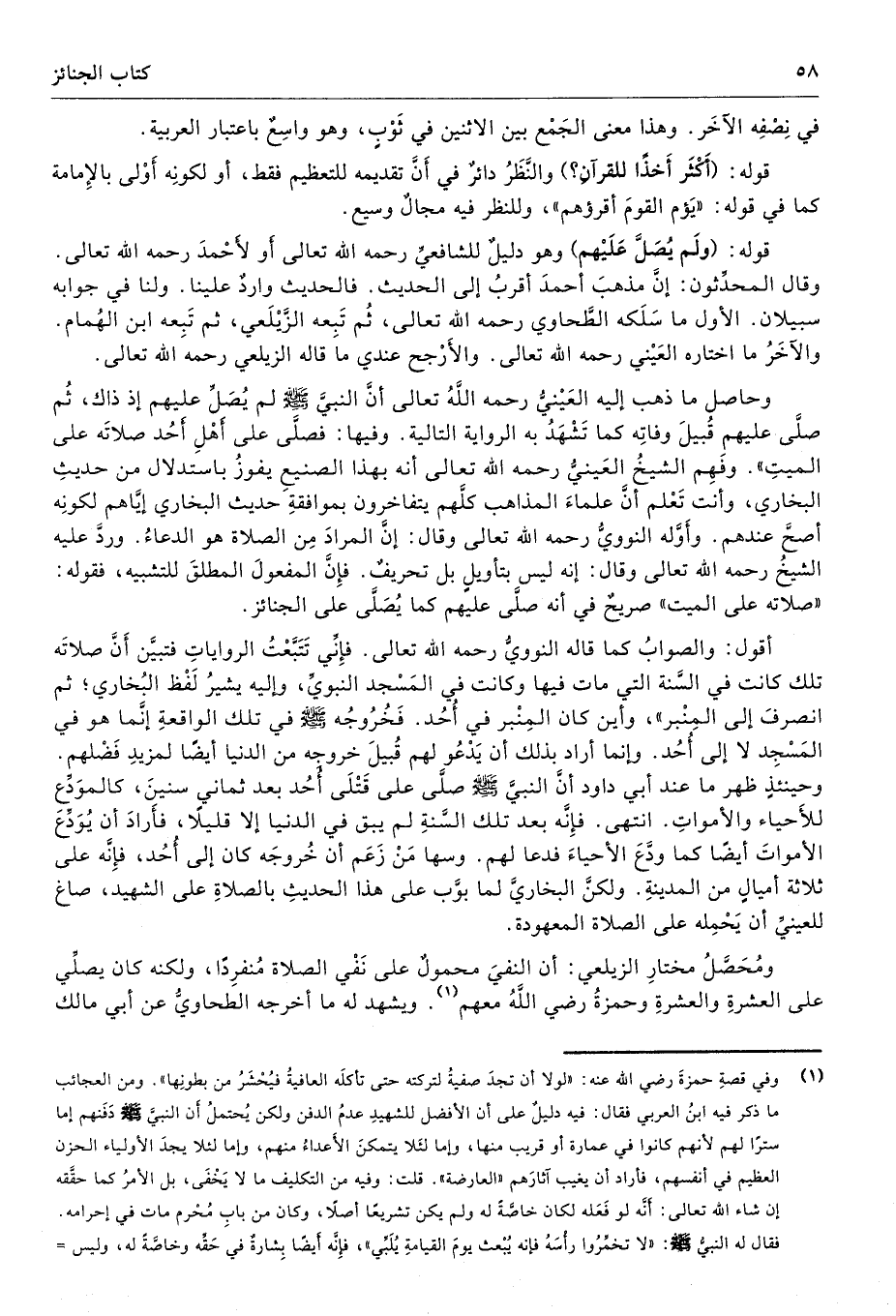
كتاب فيض الباري على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)
في نِصْفِه الآخَر. وهذا معنى الجَمْع بين الاثنين في ثَوْبٍ، وهو واسِعٌ باعتبار العربية.قوله: (أَكْثَرُوا أَخذًا للقرآنِ؟) والنَّظَرُ دائرٌ في أَنَّ تقديمه للتعظيم فقط، أو لكونِه أَوْلى بالإِمامة كما في قوله: «يَؤم القومَ أقرؤهم»، وللنظر فيه مجالٌ وسيع.
قوله: (ولَم يُصَلَّ عَلَيْهم) وهو دليلٌ للشافعيِّ رحمه الله تعالى أَو لأَحْمدَ رحمه الله تعالى. وقال المحدِّثون: إنَّ مذهبَ أحمدَ أقربُ إلى الحديث. فالحديث واردٌ علينا. ولنا في جوابه سبيلان. الأول ما سَلَكه الطَّحاوي رحمه الله تعالى، ثُم تَبِعه الزَّيْلَعي، ثم تَبِعه ابن الهُمام. والآخَرُ ما اختاره العَيْني رحمه الله تعالى. والأَرْجح عندي ما قاله الزيلعي رحمه الله تعالى.
وحاصل ما ذهب إليه العَيْنيُّ رحمه اللَّهُ تعالى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يُصَلِّ عليهم إذ ذاك، ثُم صلَّى عليهم قُبيلَ وفاتِه كما تَشْهَدُ به الرواية التالية. وفيها: فصلَّى على أَهْلِ أَحُد صلاتَه على الميتِ». وفَهِم الشيخُ العَينيُّ رحمه الله تعالى أنه بهذا الصنيعِ يفوزُ باستدلال من حديثِ البخاري، وأنت تَعْلم أنَّ علماءَ المذاهب كلَّهم يتفاخرون بموافقةِ حديث البخاري إيَّاهم لكونِه أصحَّ عندهم. وأَوَّله النوويُّ رحمه الله تعالى وقال: إنَّ المرادَ مِن الصلاة هو الدعاءُ. وردَّ عليه الشيخُ رحمه الله تعالى وقال: إنه ليس بتأويلٍ بل تحريفٌ. فإِنَّ المفعولَ المطلقَ للتشبيه، فقوله: «صلاته على الميت» صريحٌ في أنه صلَّى عليهم كما يُصَلَّى على الجنائز.
أقول: والصوابُ كما قاله النوويُّ رحمه الله تعالى. فإِنَّي تَتَبَّعْتُ الرواياتِ فتبيَّن أَنَّ صلاتَه تلك كانت في السَّنة التي مات فيها وكانت في المَسْجد النبويِّ، وإليه يشيرُ لَفْظ البِخاريُّ؛ ثم انصرفَ إلى المِنْبر»، وأين كان المِنْبر في أُحُد. فَخُرُوجُه صلى الله عليه وسلّم في تلك الواقعةِ إنَّما هو في المَسْجِد لا إلى أُحُد. وإنما أراد بذلك أن يَدْعُو لهم قُبيلَ خروجِه من الدنيا أيضًا لمزيدِ فَضْلهم. وحينئذٍ ظهر ما عند أبي داود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم صلَّى على قَتْلَى أُحُد بعد ثماني سنينَ، كالموَدِّع للأَحياء والأمواتِ. انتهى. فإِنَّه بعد تلك السَّنةِ لم يبق في الدنيا إلا قليلا، فأَرادَ أن يُوَدِّعَ الأمواتَ أيضًا كما ودَّعَ الأحياءَ فدعا لهم. وسها مَنْ زَعَم أن خُروجَه كان إلى أُحُد، فإِنَّه على ثلاثة أميالٍ من المدينةِ. ولكنَّ البخاريَّ لما بوَّب على هذا الحديثِ بالصلاةِ على الشهيد، صاغ للعينيِّ أن يَحْمِله على الصلاة المعهودة.
ومُحَصَّلُ مختارِ الزيلعي: أن النفيَ محمولٌ على نَفْي الصلاة مُنفرِدًا، ولكنه كان يصلِّي على العشرةِ والعشرةِ وحمزةُ رضي اللَّهُ معهم (¬1). ويشهد له ما أخرجه الطحاويُّ عن أبي مالك
¬__________
(¬1) وفي قصةِ حمزةَ رضي الله عنه: "لولا أن تجدَ صفيةُ لتركته حتى تأكلَه العافيةُ فيحْشَرُ من بطونِها". ومن العجائب ما ذكر فيه ابنُ العربي فقال: فيه دليلٌ على أن الأفضل للشهيدِ عدمُ الدفن ولكن يُحتملُ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَفَنهم إما سترًا لهم لأنهم كانوا في عمارة أو قريب منها، وإما لئَلا يتمكنَ الأَعداء منهم، وإما لئلا يجدَ الأولياء الحزن العظيم في أنفسهم، فأراد أن يغيب آثارَهم "العارضة". قلت: وفيه من التكليف ما لا يَخْفَى، بل الأمرُ كما حققه إن شاء الله تعالى: أنه لو فَعَله لكان خاصَّة له ولم يكن تشريعًا أصلًا، وكان من بابِ محْرم مات في إحرامه.
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تخمِّرُوا رأسَة فإنه يُبْعث يومَ القيامةِ يُلَبي"، فإنه أيضًا بِشارة في حَقه خاصَّة له، وليس =