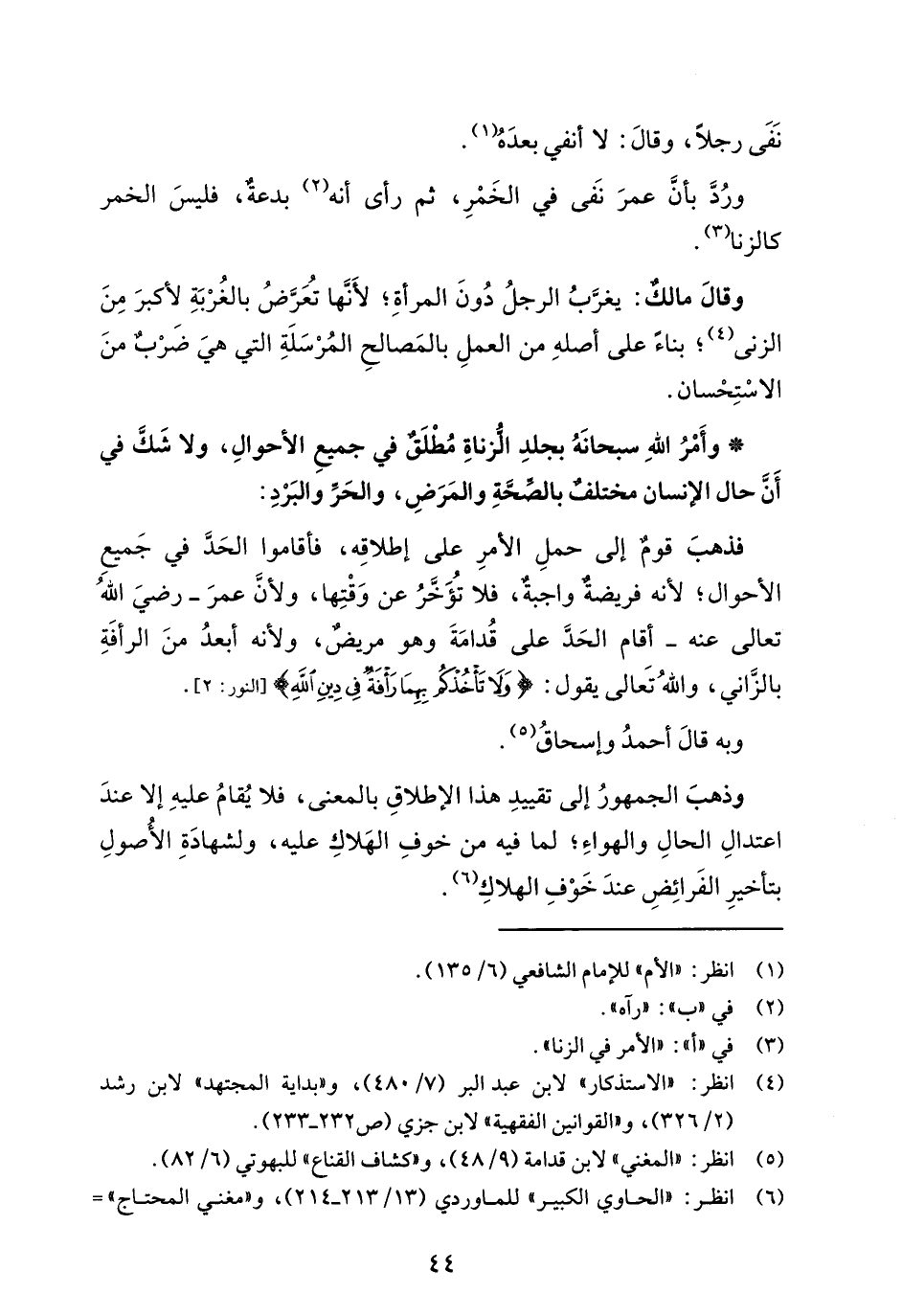
كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)
نَفَى رجلاً، وقالَ: لا أنفي بعدَهُ (¬1).ورُدَّ بأنَّ عمرَ نَفى في الخَمْرِ، ثم رأى أنه (¬2) بدعةٌ، فليسَ الخمر كالزنا (¬3).
وقالَ مالكٌ: يغرَّبُ الرجلُ دُونَ المرأةِ؛ لأَنَّها تُعَرَّضُ بالغُرْبَةِ لأكبرَ مِنَ الزنى (¬4)؛ بناءً على أصلهِ من العملِ بالمَصالحِ المُرْسَلَةِ التي هيَ ضَرْبٌ منَ الاسْتِحْسان.
* وأَمْرُ اللهِ سبحانَهُ بجلدِ الزُّناةِ مُطْلَقٌ في جميعِ الأحوالِ، ولا شَكَّ في أَنَّ حال الإنسان مختلفٌ بالصِّحَّةِ والمَرَضِ، والحَرِّ والبَرْدِ:
فذهبَ قومٌ إلى حملِ الأمرِ على إطلاقِه، فأقاموا الحَدَّ في جَميعِ الأحوال؛ لأنه فريضةٌ واجبةٌ، فلا تُؤَخَّرُ عن وَقْتِها، ولأنَّ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه - أقام الحَدَّ على قُدامَةَ وهو مريضٌ، ولأنه أبعدُ منَ الرأفَةِ بالزَّاني، واللهُ تَعالى يقول: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2].
وبه قالَ أحمدُ وإسحاقُ (¬5).
وذهبَ الجمهورُ إلى تقييدِ هذا الإطلاقِ بالمعنى، فلا يُقامُ عليهِ إلا عندَ اعتدالِ الحالِ والهواءِ؛ لما فيه من خوفِ الهَلاكِ عليه، ولشهادَةِ الأُصولِ بتأخيرِ الفَرائِضِ عندَ خَوْفِ الهلاكِ (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (6/ 135).
(¬2) في "ب": "رآه".
(¬3) في "أ": "الأمر في الزنا".
(¬4) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 480)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 326)، و "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص 232 - 233).
(¬5) انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 48)، و"كشاف القناع" للبهوتي (6/ 82).
(¬6) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (13/ 213 - 214)، و"مغني المحتاج" =