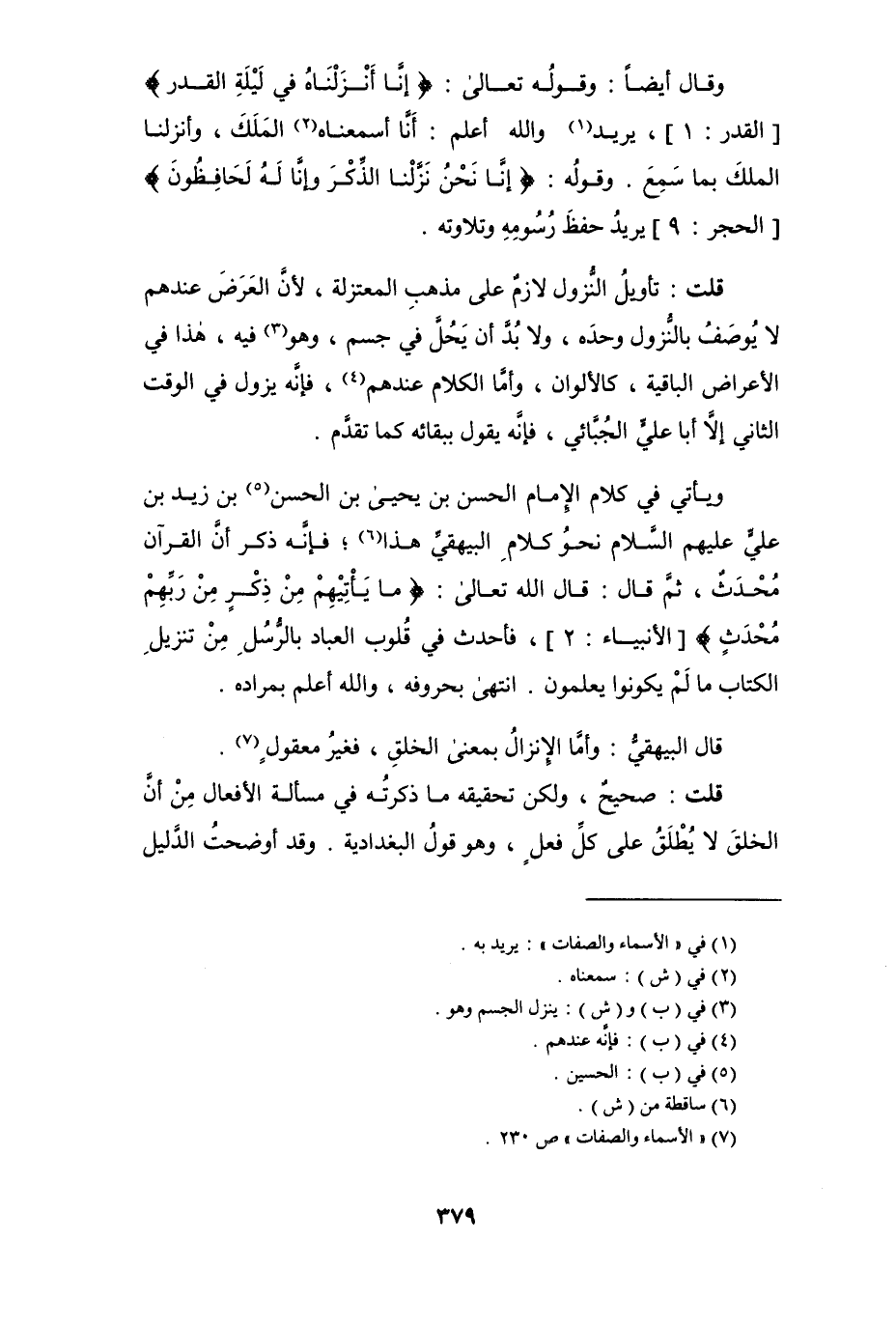
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 4)
وقال أيضاً: وقوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1]، يريد (¬1) والله أعلم: أنا أسمعناه (¬2) المَلَكَ، وأنزلنا الملك بما سمع. وقوله: {إنا نحنُ نزَّلنا الذكرَ وإنا لهُ لَحَافظون} [الحجر: 9] يريد حفظ رسومه وتلاوته.قلت: تأويل النزول لازمٌ على مذهب المعتزلة، لأن العَرَضَ عندهم لا يُوصف بالنزول وحده، ولا بُدَّ أن يحُلَّ في جسم، وهو (¬3) فيه، هذا في الأعراض الباقية، كالألوان، وأما الكلام عندهم (¬4)، فإنه يزول في الوقت الثاني إلاَّ أبا عليٍّ الجُبَّائي، فإنه يقول ببقائه كما تقدم.
ويأتي في كلام الإمام الحسن بن يحيى بن الحسن (¬5) بن زيد بن عليٍّ عليهم السلام نحو كلام البيهقيِّ هذا (¬6)، فإنه ذكر أن القرآن مُحدَثٌ، ثم قال: قال الله تعالى: {ما يأتِيهِمْ مِنْ ذِكرٍ من ربِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2]، فأحدث في قلوب العباد بالرُّسل من تنزيل الكتاب ما لم يكونوا يعلمون. انتهى بحروفه، والله أعلم بمراده.
قال البيهقيُّ: وأما الإنزال بمعنى الخلق، فغيرُ معقولٍ (¬7).
قلت: صحيحٌ، ولكن تحقيقه ما ذكرته في مسألة الأفعال من أن الخلق لا يُطلق على كل فعلٍ، وهو قول البغدادية. وقد أوضحتُ الدليل
¬__________
(¬1) في " الأسماء والصفات ": يريد به.
(¬2) في (ش): سمعناه.
(¬3) في (ب) و (ش): ينزل الجسم وهو.
(¬4) في (ب): فإنه عندهم.
(¬5) في (ب): الحسين.
(¬6) ساقطة من (ش).
(¬7) " الأسماء والصفات " ص 230.