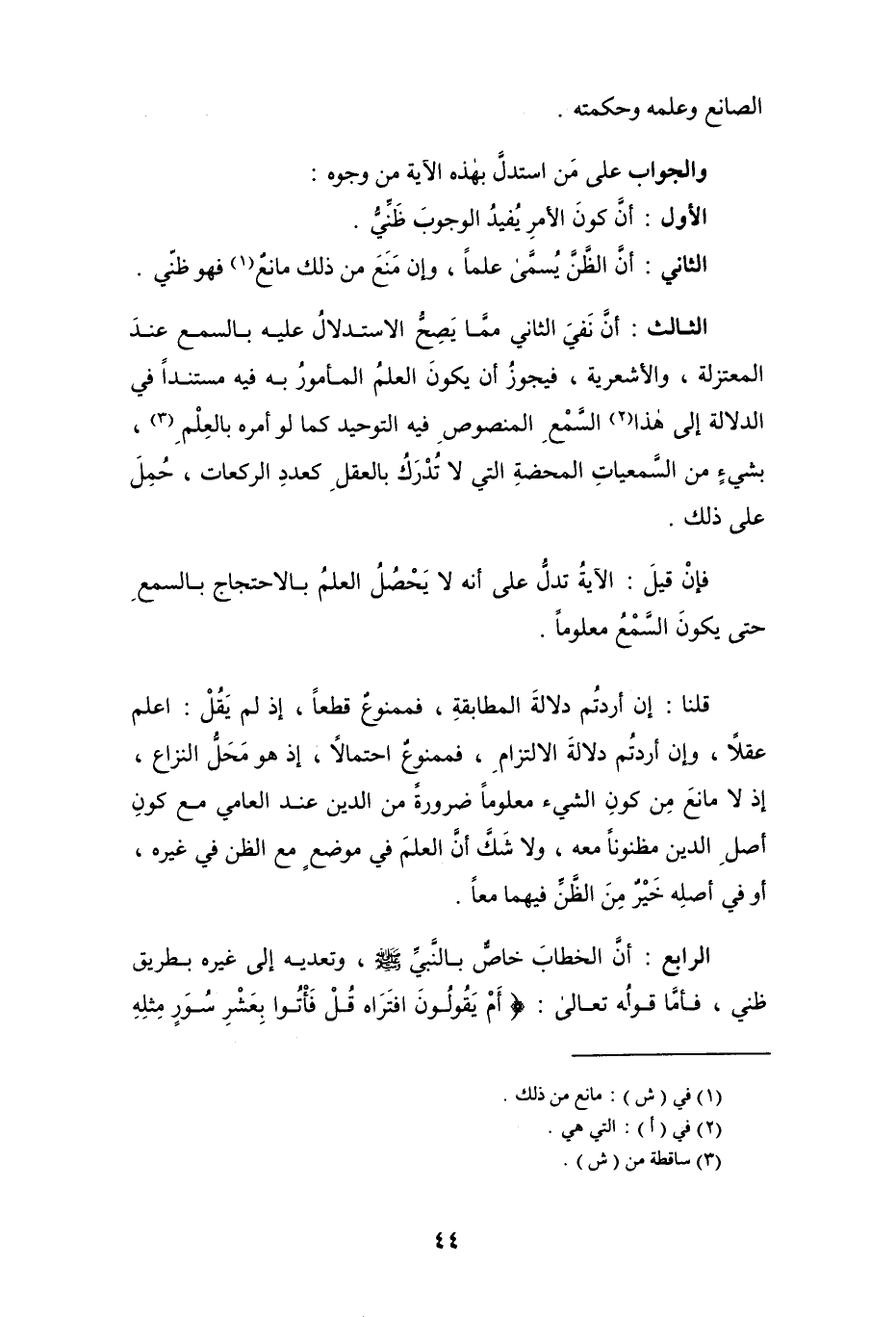
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 4)
الصانع وعلمه وحكمته.والجواب على من استدل بهذه الآية من وجوه:
الأول: أن كون الأمر يُفيدُ الوجوب ظنِّيُّ.
الثاني: أن الظن يُسمى علماً، وإن مَنَعَ من ذلك مانعٌ (¬1) فهو ظنّي.
الثالث: أنّ نفي الثاني ممَّا يَصِحُّ الاستدلالُ عليه بالسمع عند المعتزلة، والأشعرية، فيجوز أن يكون العلم المأمور به فيه مستنداً في الدلالة إلى هذا (¬2) السمع المنصوص فيه التوحيد كما لو أمره بالعِلم (¬3)، بشيءٍ من السَّمعياتِ المحضةِ التي لا تُدركُ بالعقل كعددِ الركعات، حُمِلَ على ذلك.
فإنُ قيل: الآيةُ تدلُّ على أنه لا يحصُلُ العلم بالاحتجاج بالسمع حتى يكون السمع معلوماً.
قلنا: إن أردتُم دلالة المطابقة، فممنوعٌ قطعاً، إذ لم يقُل: اعلم عقلاً، وإن أردتُم دلالة الالتزام، فممنوعٌ احتمالاً، إذ هو مَحَلُّ النزاع، إذ لا مانع من كون الشيء معلوماً ضرورةً من الدين عند العامي مع كون أصل الدين مظنوناً معه، ولا شكَّ أنَّ العلم في موضعٍ مع الظن في غيره، أو في أصله خيرٌ من الظنِّ فيهما معاً.
الرابع: أن الخطاب خاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعديه إلى غيره بطريق ظني، فأمَّا قولُه تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِه
¬__________
(¬1) في (ش): مانع من ذلك.
(¬2) في (أ): التي هي.
(¬3) ساقطة من (ش).