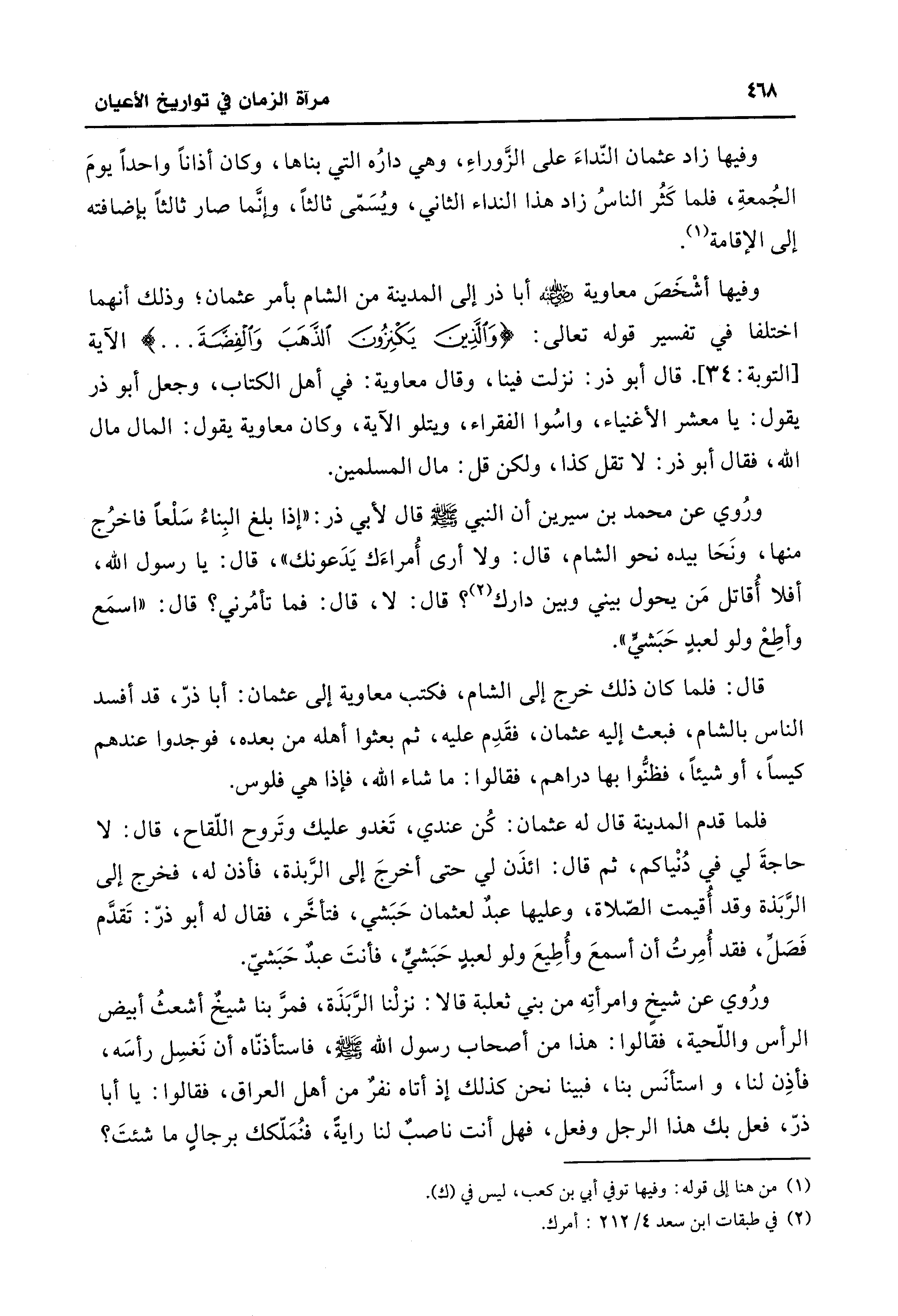
كتاب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (اسم الجزء: 5)
وفيها زاد عثمان النّداءَ على الزَّوراءِ، وهي دارُه التي بناها، وكان أذانًا واحدًا يومَ الجُمعةِ، فلما كَثُر الناسُ زاد هذا النداء الثاني، ويُسَمّى ثالثًا، وإنَّما صار ثالثًا بإضافته إلى الإقامة (¬1).وفيها أشْخَصَ معاوية -رضي اللَّه عنه- أبا ذر إلى المدينة من الشام بأمر عثمان؛ وذلك أنهما اختلفا في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. . .} الآية [التوبة: 34]. قال أبو ذر: نزلت فينا، وقال معاوية: في أهل الكتاب، وجعل أبو ذر يقول: يا معشر الأغنياء، واسُوا الفقراء، ويتلو الآية، وكان معاوية يقول: المال مال اللَّه، فقال أبو ذر: لا تقل كذا، ولكن قل: مال المسلمين.
ورُوي عن محمد بن سيرين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي ذر: "إذا بلغ البِناءُ سَلْعًا فاخرُج منها، ونَحَا بيده نحو الشام، قال: ولا أرى أُمراءَك يَدَعونك"، قال: يا رسول اللَّه، أفلا أُقاتل مَن يحول بيني وبين دارك (¬2)؟ قال: لا، قال: فما تأمُرني؟ قال: "اسمَع وأطِعْ ولو لعبدٍ حَبَشيٍّ".
قال: فلما كان ذلك خرج إلى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان: أبا ذرّ، قد أفسد الناس بالشام، فبعث إليه عثمان، فقَدِم عليه، ثم بعثوا أهله من بعده، فوجدوا عندهم كيسًا، أو شيئًا، فظنُّوا بها دراهم، فقالوا: ما شاء اللَّه، فإذا هي فلوس.
فلما قدم المدينة قال له عثمان: كُن عندي، تَغدو عليك وتَروح اللّقاح، قال: لا حاجةَ لي في دُنْياكم، ثم قال: ائذَن لي حتى أخرجَ إلى الرَّبذة، فأذن له، فخرج إلى الرَّبَذة وقد أُقيمت الصّلاة، وعليها عبدٌ لعثمان حَبَشي، فتأخَّر، فقال له أبو ذرّ: تَقدَّم فَصَلِّ، فقد أُمِرتُ أن أسمعَ وأُطِيعَ ولو لعبدٍ حَبَشيٍّ، فأنتَ عبدٌ حَبَشيّ.
ورُوي عن شيخٍ وامرأتِه من بني ثعلبة قالا: نزلْنا الرَّبَذَة، فمرَّ بنا شيخٌ أشعثُ أبيض الرأس واللّحية، فقالوا: هذا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستأذنّاه أن نَغسِل رأسَه، فأذِن لنا، واستأنَس بنا، فبينا نحن كذلك إذ أتاه نفرٌ من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذرّ، فعل بك هذا الرجل وفعل، فهل أنت ناصبٌ لنا رايةً، فنُمَلّكك برجالٍ ما شئتَ؟
¬__________
(¬1) من هنا إلى قوله: وفيها توفي أي بن كعب، ليس في (ك).
(¬2) في طبقات ابن سعد 4/ 212: أمرك.