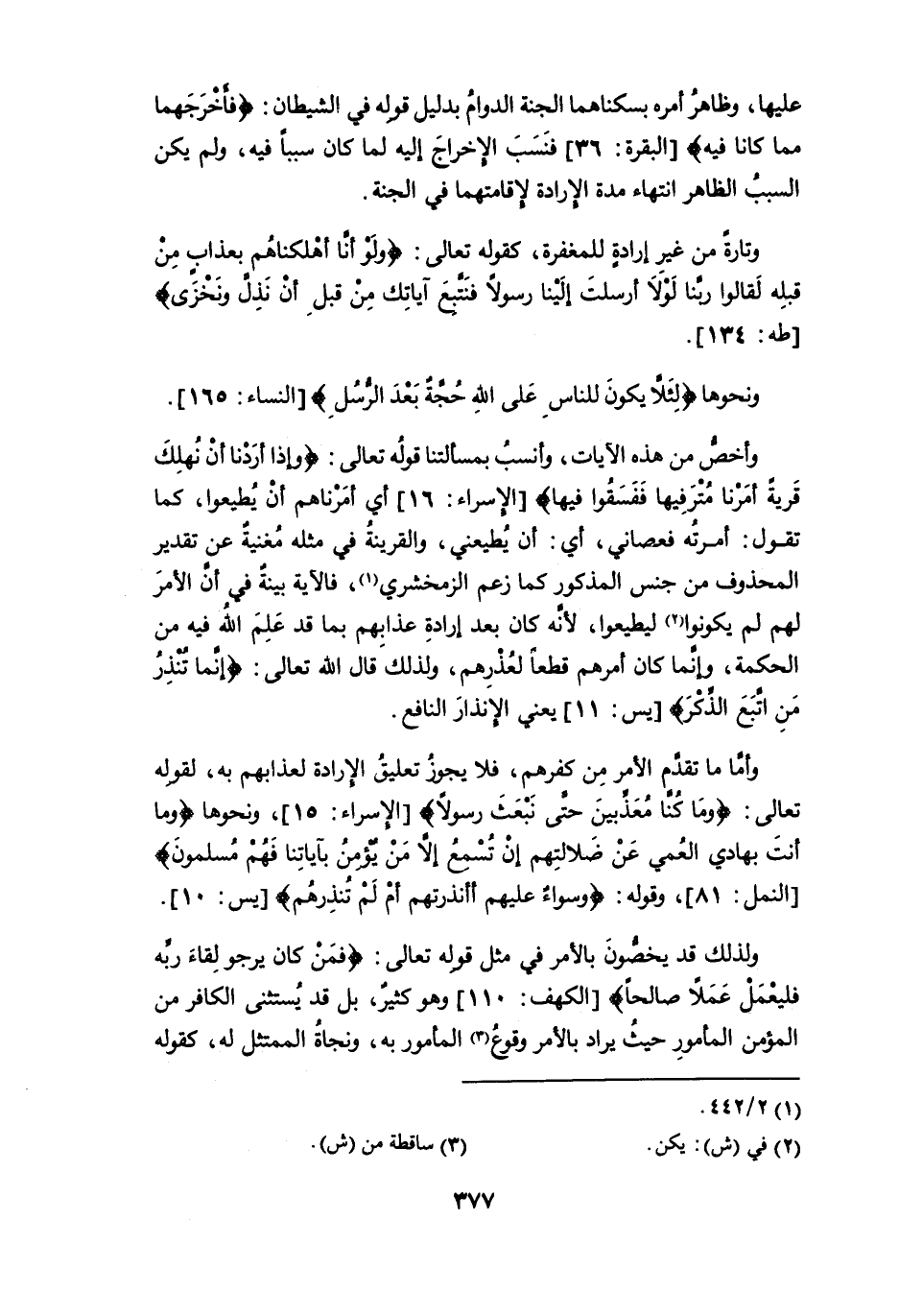
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 5)
عليها، وظاهرُ أمره بسكناهما الجنة الدوام بدليل قوله في الشيطان: {فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه} [البقرة: 36] فنسب الإخراج إليه لما كان سبباً فيه، ولم يكن السببُ الظاهر انتهاء مدة الإرادة لإقامتهما في الجنة.وتارةً من غير إرادةٍ للمغفرة، كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} [طه: 134].
ونحوها {لِئَلاَّ يكونَ للناس على الله حُجَّةٌ بعد الرُّسُل} [النساء: 165].
وأخصُّ من هذه الآيات، وأنسبُ بمسألتنا قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا} [الإسراء: 16] أي أمرناهم أن يطيعوا، كما تقول: أمرته فعصاني، أي: أن يُطيعني، والقرينة في مثله مُغنيةٌ عن تقدير المحذوف من جنس المذكور كما زعم الزمخشري (¬1)، فالآية بينةٌ في أن الأمر لهم لم يكونوا (¬2) ليطيعوا، لأنه كان بعد إرادة عذابهم بما قد علم الله فيه من الحكمة، وإنما كان أمرهم قطعاً لعُذْرِهم، ولذلك قال الله تعالى: {إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْر} [يس: 11] يعني الإنذار النافع.
وأما ما تقدم الأمر من كفرهم، فلا يجوز تعليق الإراده لعذابهم به، لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، ونحوها {وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُون} [النمل: 81]، وقوله: {وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُم} [يس: 10].
ولذلك قد يخصُّون بالأمر في مثل قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110] وهو كثير، بل قد يستثنى الكافر من المؤمن المأمور حيث يراد بالأمر وقوع (¬3) المأمور به، ونجاة الممتثل له، كقوله
¬__________
(¬1) 2/ 422.
(¬2) في (ش): يكن.
(¬3) ساقطة من (ش).