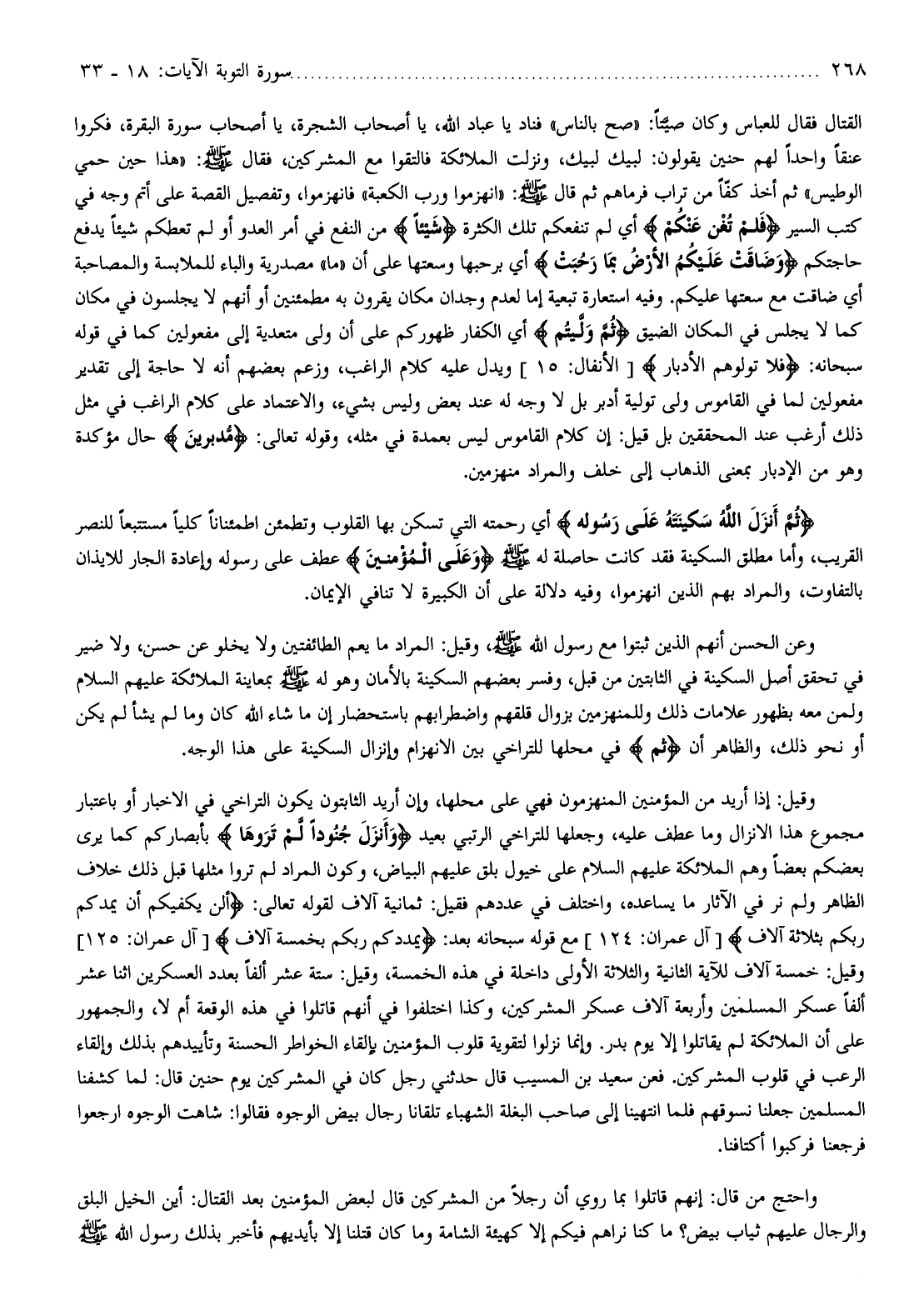
كتاب تفسير الألوسي = روح المعاني (اسم الجزء: 5)
القتال فقال للعباس وكان صيّتا: «صح بالناس» فناد يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، فكروا عنقا واحدا لهم حنين يقولون: لبيك لبيك، ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين،فقال صلّى الله عليه وسلّم: «هذا حين حمي الوطيس» ثم أخذ كفّا من تراب فرماهم ثم قال صلّى الله عليه وسلّم: «انهزموا ورب الكعبة» فانهزموا،
وتفصيل القصة على أتم وجه في كتب السير فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ أي لم تنفعكم تلك الكثرة شَيْئاً من النفع في أمر العدو أو لم تعطكم شيئا يدفع حاجتكم وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ أي برحبها وسعتها على أن «ما» مصدرية والباء للملابسة والمصاحبة أي ضاقت مع سعتها عليكم. وفيه استعارة تبعية إما لعدم وجدان مكان يقرون به مطمئنين أو أنهم لا يجلسون في مكان كما لا يجلس في المكان الضيق ثُمَّ وَلَّيْتُمْ أي الكفار ظهوركم على أن ولى متعدية إلى مفعولين كما في قوله سبحانه: فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ [الأنفال: 15] ويدل عليه كلام الراغب، وزعم بعضهم أنه لا حاجة إلى تقدير مفعولين لما في القاموس ولى تولية أدبر بل لا وجه له عند بعض وليس بشيء، والاعتماد على كلام الراغب في مثل ذلك أرغب عند المحققين بل قيل: إن كلام القاموس ليس بعمدة في مثله، وقوله تعالى: مُدْبِرِينَ حال مؤكدة وهو من الإدبار بمعنى الذهاب إلى خلف والمراد منهزمين.
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ أي رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمئن اطمئنانا كليا مستتبعا للنصر القريب، وأما مطلق السكينة فقد كانت حاصلة له صلّى الله عليه وسلّم وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ عطف على رسوله وإعادة الجار للايذان بالتفاوت، والمراد بهم الذين انهزموا، وفيه دلالة على أن الكبيرة لا تنافي الإيمان.
وعن الحسن أنهم الذين ثبتوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقيل: المراد ما يعم الطائفتين ولا يخلو عن حسن، ولا ضير في تحقق أصل السكينة في الثابتين من قبل، وفسر بعضهم السكينة بالأمان وهو له صلّى الله عليه وسلّم بمعاينة الملائكة عليهم السلام ولمن معه بظهور علامات ذلك وللمنهزمين بزوال قلقهم واضطرابهم باستحضار إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أو نحو ذلك، والظاهر أن ثُمَّ في محلها للتراخي بين الانهزام وإنزال السكينة على هذا الوجه.
وقيل: إذا أريد من المؤمنين المنهزمون فهي على محلها، وإن أريد الثابتون يكون التراخي في الاخبار أو باعتبار مجموع هذا الانزال وما عطف عليه، وجعلها للتراخي الرتبي بعيد وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها بأبصاركم كما يرى بعضكم بعضا وهم الملائكة عليهم السلام على خيول بلق عليهم البياض، وكون المراد لم تروا مثلها قبل ذلك خلاف الظاهر ولم نر في الآثار ما يساعده، واختلف في عددهم فقيل: ثمانية آلاف لقوله تعالى: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ [آل عمران: 124] مع قوله سبحانه بعد: يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ [آل عمران: 125] وقيل: خمسة آلاف للآية الثانية والثلاثة الأولى داخلة في هذه الخمسة، وقيل: ستة عشر ألفا بعدد العسكرين اثنا عشر ألفا عسكر المسلمين وأربعة آلاف عسكر المشركين، وكذا اختلفوا في أنهم قاتلوا في هذه الوقعة أم لا، والجمهور على أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر. وإنما نزلوا لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدهم بذلك وإلقاء الرعب في قلوب المشركين. فعن سعيد بن المسيب قال حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا.
واحتج من قال: إنهم قاتلوا بما
روي أن رجلا من المشركين قال لبعض المؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق والرجال عليهم ثياب بيض؟ ما كنا نراهم فيكم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم فأخبر بذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم