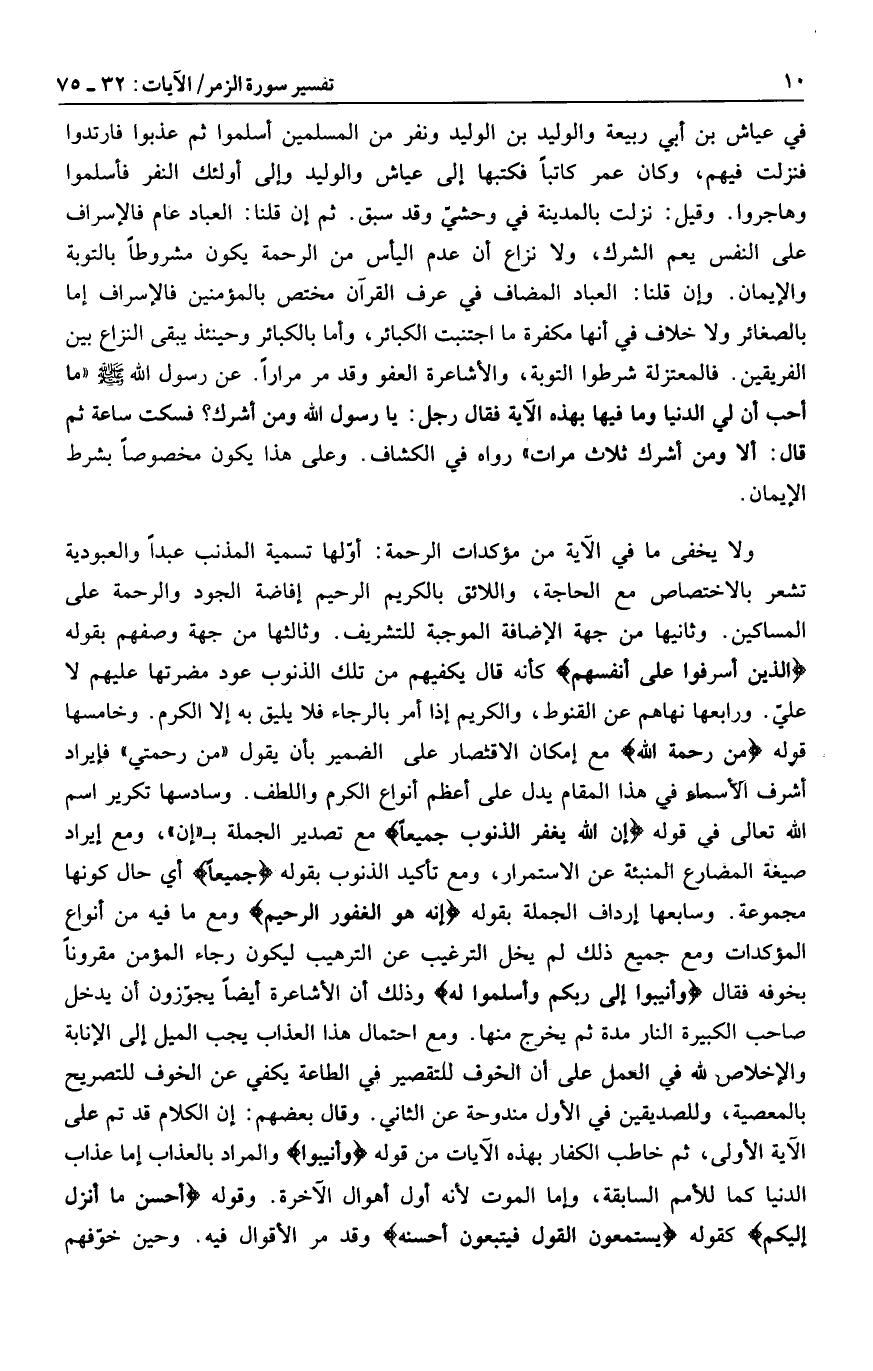
كتاب تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (اسم الجزء: 6)
في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم عذبوا فارتدوا فنزلت فيهم، وكان عمر كاتبا فكتبها إلى عياش والوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا. وقيل: نزلت بالمدينة في وحشيّ وقد سبق. ثم إن قلنا: العباد عام فالإسراف على النفس يعم الشرك، ولا نزاع أن عدم اليأس من الرحمة يكون مشروطا بالتوبة والإيمان. وإن قلنا: العباد المضاف في عرف القرآن مختص بالمؤمنين فالإسراف إما بالصغائر ولا خلاف في أنها مكفرة ما اجتنبت الكبائر، وأما بالكبائر وحينئذ يبقى النزاع بين الفريقين. فالمعتزلة شرطوا التوبة، والأشاعرة العفو وقد مر مرارا.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات» رواه في الكشاف.
وعلى هذا يكون مخصوصا بشرط الإيمان.
ولا يخفى ما في الآية من مؤكدات الرحمة: أوّلها تسمية المذنب عبدا والعبودية تشعر بالاختصاص مع الحاجة، واللائق بالكريم الرحيم إفاضة الجود والرحمة على المساكين. وثانيها من جهة الإضافة الموجبة للتشريف. وثالثها من جهة وصفهم بقوله الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ كأنه قال يكفيهم من تلك الذنوب عود مضرتها عليهم لا عليّ. ورابعها نهاهم عن القنوط، والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا الكرم. وخامسها قوله مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مع إمكان الاقتصار على الضمير بأن يقول «من رحمتي» فإيراد أشرف الأسماء في هذا المقام يدل على أعظم أنواع الكرم واللطف. وسادسها تكرير اسم الله تعالى في قوله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً مع تصدير الجملة ب «إن» ، ومع إيراد صيغة المضارع المنبئة عن الاستمرار، ومع تأكيد الذنوب بقوله جَمِيعاً أي حال كونها مجموعة. وسابعها إرداف الجملة بقوله إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ومع ما فيه من أنواع المؤكدات ومع جميع ذلك لم يخل الترغيب عن الترهيب ليكون رجاء المؤمن مقرونا بخوفه فقال وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وذلك أن الأشاعرة أيضا يجوّزون أن يدخل صاحب الكبيرة النار مدة ثم يخرج منها. ومع احتمال هذا العذاب يجب الميل إلى الإنابة والإخلاص لله في العمل على أن الخوف للتقصير في الطاعة يكفي عن الخوف للتصريح بالمعصية، وللصديقين في الأول مندوحة عن الثاني. وقال بعضهم: إن الكلام قد تم على الآية الأولى، ثم خاطب الكفار بهذه الآيات من قوله وَأَنِيبُوا والمراد بالعذاب إما عذاب الدنيا كما للأمم السابقة، وإما الموت لأنه أول أهول الآخرة. وقوله أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ كقوله يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وقد مر الأقوال فيه. وحين خوّفهم