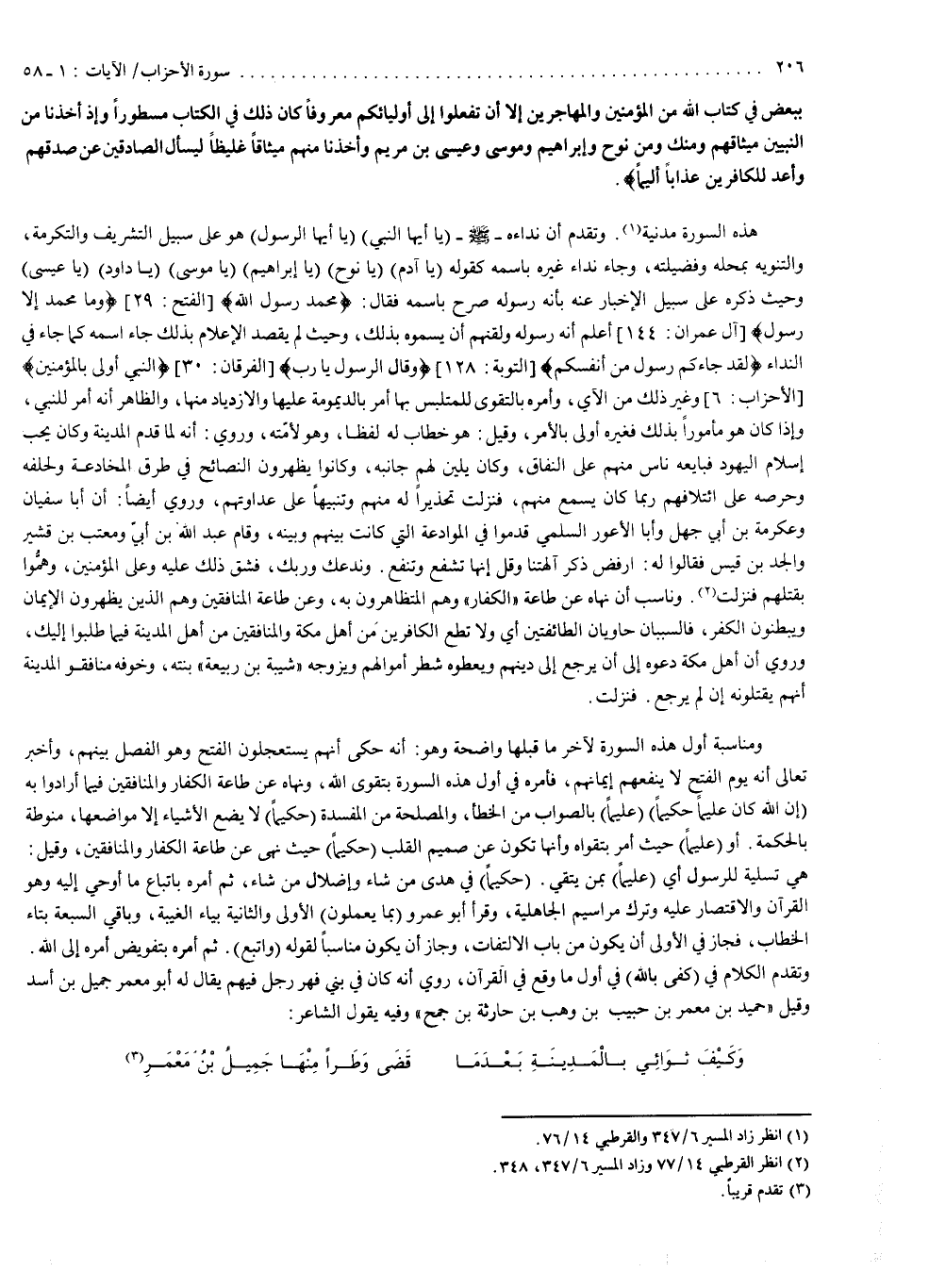
كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 7)
" صفحة رقم 206 "( سقط : ببعض في كتاب الله من المؤمنين والهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياؤكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما )
هذه السورة مدنية . وتقدم أن نداءه / ( صلى الله عليه وسلم ) ) : ) مُّنتَظِرُونَ ياأَيُّهَا النَّبِىّ ( ، ( اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ( ، هو على سبيل التشريف والتكرمة والتنويه بمحله وفضيلته ، وجاء نداء غيره باسمه ، كقوله : ) وَعَلَّمَ ءادَمَ ( ، ( وَنَادَى نُوحٌ ( ، ( ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ( ، ( حَدِيثُ مُوسَى ( ، ( وَقَتَلَ دَاوُودُ ( ، ( وَءاتَيْنَا عِيسَى ). وحيث ذكره على سبيل الأخبار عنه بأنه رسوله ، صرح باسمه فقال : ) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ( ، ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ( ، أعلم أنه رسوله ، ولقنهم أن يسموه بذلك . وحيث لم يقصد الإعلام بذلك ، جاء اسمه كما جاء في النداء : ) لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفُسِكُمْ ( ، ( وَقَالَ الرَّسُولُ يارَبّ رَبّ ( ، ( النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ( ، وغير ذلك من الآي . وأمره بالتقوى للمتلبس بها ، أمر بالديموية عليها والازدياد منها . والظاهر أنه أمر للنبي ، وإذا كان هو مأموراً بذلك ، فغيره أولى بالأمر . وقيل : هو خطاب له لفظاً ، وهو لأمّته .
وروي أنه لما قدم المدينة ، وكان يحب إسلام اليهود ، فبايعه ناس منهم على النفاق ، وكان يلين لهم جانبه ، وكانوا يظهرون النصائح في طرق المخادعة ، ولحلفه وحرصه على ائتلافهم ربما كان يسمع منهم ، فنزلت تحذيراً له منهم وتنبيهاً على عداوتهم . وروي أيضاً أن أبا سفيان ، وعكرمة بن أبي جهل ، وأبا الأعور السلمي قدموا في الموادعة التي كانت بينهم وبينه ، وقام عبد الله بن أبي ، ومعتب بن قشير ، والجد بن قيس فقالوا له : ارفض ذكر آلهتنا وقل : إنها تشفع وتنفع ، وندعك وربك ؛ فشق ذلك عليه وعلى المؤمنين ، وهموا بقتلهم ، فنزلت . وناسب أن نهاه عن طاعة الكفار ، وهم المتظاهرون به ، وعن طاعة المنافقين ، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . فالسببان حاويان الطائفتين ، أي : ولا تطع الكافرين من أهل مكة ، والمنافقين من أهل المدينة ، فيما طلبوا إليك . وروي أن أهل مكة دعوه إلى أن يرجع إلى دينهم ، ويعطوه شطر أموالهم ، ويزوجه شيبة بن ربيعة بنته ؛ وخوفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع ، فنزلت .
ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة ، وهو أنه حكى أنهم يستعجلون الفتح ، وهو الفصل بينهم ، وأخبر تعالى أنه يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم ، فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله ، ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين فيما أرادوا به . ) إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ( : عليماً بالصواب من الخطأ ، والمصلحة من المفسدة ؛ حكيماً لا يضع الأشياء إلا مواضعها منوطة بالحكمة ؛ أو عليماً حيث أمر بتقواه ، وأنها تكون عن صميم القلب ، حكيماً حيث نهى عن طاعة الكفار والمنافقين . وقيل : هي تسلية للرسول ، أي عليماً بمن يتقي ، حكيماً في هدي من شاء وإضلال من شاء . ثم أمره باتباع ما أوحي إليه ، وهو القرآن ، والاقتصار عليه ، وترك مراسيم الجاهلية . وقرأ أبو عمرو : بما يعملون ، الأولى والثانية بياء الغيبة ؛ وباقي السبعة : بتاء الخطاب ، فجاز في الأولى أن يكون من باب الالتفات ، وجاز أن يكون مناسبة لقوله : ) وَاتَّبِعْ ( ، ثم أمره بتفويض أمره إلى الله . وتقدم الكلام في ) كَفَى بِاللَّهِ ( في أول ما وقع في القرآن . روي أنه كان في بني فهر رجل فيهم يقال له : أبو معمر جميل بن أسد ، وقيل : حميد بن معمر بن حبيب بن وهب بن حارثة بن جمح ، وفيه يقول الشاعر : وكيف ثوائي بالمدينة بعدما
قضى وطراً منها جميل بن معمر