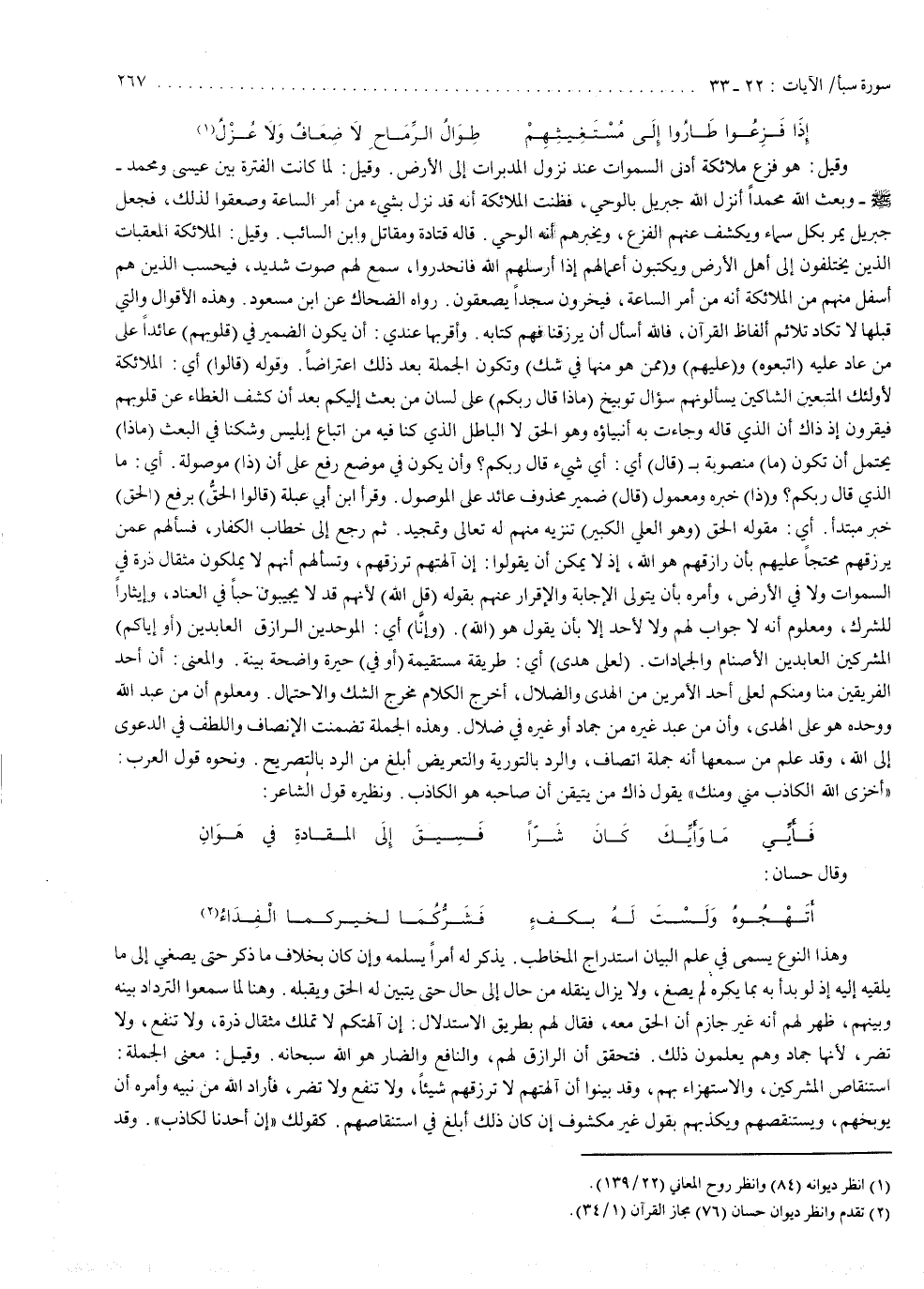
كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 7)
" صفحة رقم 267 "إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم
طوال الرماح لإضعاف ولا عزل
وقيل : هو فزع ملائكة أدنى السموات عند نزول المدبرات إلى الأرض . وقيل : لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ) ، وبعث الله محمداً ، أنزل الله جبريل بالوحي ، فظنت الملائكة أنه قد نزل بشيء من أمر الساعة ، وصعقوا لذلك ، فجعل جبريل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع ويخبرهم أنه الوحي ، قاله قتادة ومقاتل وابن السائب . وقيل : الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض ، ويكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الله فانحدروا ، سمع لهم صوت شديد ، فيحسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة ، فيخرون سجداً يصعقون ، رواه الضحاك عن ابن مسعود .
وهذه الأقوال والتي قبلها لا تكاد تلائم ألفاظ القرآن ، فالله أسأل أن يرزقنا فهم كتابه ، وأقر بها عندي أن يكون الضمير في ) قُلُوبِهِمْ ( عائداً على من عاد عليه اتبعوه وعليهم ، وممن هو منها في شك ، وتكون الجملة بعد ذلك اعتراضاً . وقوله : ) قَالُواْ ( ، أي الملائكة ، لأولئك المتبعين الشاكين يسألونهم سؤال توبيخ : ) مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ( ، على لسان من بعث إليكم بعد أن كشف الغطاء عن قلوبهم ، فيقرون إذ ذاك أن الذي قاله ، وجاءت به أنبياؤه ، وهو الحق ، لا الباطل الذي كنا فيه من اتباع إبليس . وشكنا في البعث ماذا يحتمل أن تكون ما منصوبة بقال ، أي أي شيء قال ربكم ، وأن يكون في موضع رفع على أن ذا موصولة ، أي ما الذي قال ربكم ، وذا خبره ، ومعموله قال ضمير محذوف عائد على الموصول . وقرأ ابن أبي عبلة : قالوا الحق ، برفع الحق ، خبر مبتدأ ، أي مقوله الحق ، ( وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ ( ، تنزيه منهم له تعالى وتمجيد . ثم رجع إلى خطاب الكفار فسألهم عمن يرزقهم ، محتجاً عليهم بأن رازقهم هو الله ، إذ لا يمكن أن يقولوا إن آلهتهم ترزقهم وتسألهم أنهم ) لاَ يَمْلِكُونَ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِى الاْرْضِ ( ، وأمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله : ) قُلِ اللَّهُ ( ، لأنهم قد لا يجيبون حباً في العناد وإيثاراً للشرك . ومعلوم أنه لا جواب لهم ولا لأحد إلا بأن يقول هو الله . ) وَأَنَا ( : أي الموحدين الرازق العابدين ، ( أَوْ إِيَّاكُمْ ( : المشركين العابدين الأصنام والجمادات . ) لَعَلَى هُدًى ( : أي طريقة مستقيمة ، أو في حيرة واضحة بينة . والمعنى : أن أحد الفريقين منا ومنكم لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال ، أخرج الكلام مخرج الشك والاحتمال . ومعلوم أن من عبد الله ووحده هو على الهدى ، وأن من عبد غيره من جماد أو غيره في ضلال . وهذه الجملة تضمنت الإنصاف واللطف في الدعوى إلى الله ، وقد علم من سمعها أنه جملة اتصاف ، والرد بالتورية والتعريض أبلغ من الرد بالتصريح ، ونحوه قول العرب : أخزى الله الكاذب مني ومنك ، يقول ذاك من يتيقن أن صاحبه هو الكاذب ، ونظيره قوله الشاعر : فأنيي ماوأيك كان شرا
فسيق إلى المقادة في هوان
وقال حسان : أتهجوه ولست له بكفؤ
فشركما لخيركما الفداء
وهذا النوع يسمى في علم البيان : استدراج المخاطب . يذكر له أمراً يسلمه ، وإن كان بخلاف ما ذكر حتى يصغي إليه إلى ما يلقيه إليه ، إذ لو بدأ به بما يكره لم يصغ ، ولا يزال ينقله من حال إلى حال حتى يتبين له الحق ويقبله . وهنا لما سمعوا الترداد بينه وبينهم ، ظهر لهم أنه غير جازم أن الحق معه ، فقال لهم بطريق الاستدلال : إن آلهتكم لا تملك مثقال ذرة ، ولا تنفع ولا تضر ، لأنها جماد ، وهم يعلمون ذلك ، فتحقق أن الرازق لهم والنافع والضار هو الله سبحانه . وقيل : معنى الجملة استنقاص المشركين والاستهزاء بهم ، وقد بينوا أن آلهتهم لا ترزقهم شيئاً ولا تنفع ولا تضر ، فأراد الله من نبيه ، وأمره أن يوبخهم ويستنقصهم ويكذبهم بقول غير مكشوف ، إن كان ذلك أبلغ في استنقاصهم ، كقولك : إن أحدنا لكاذب ، وقد