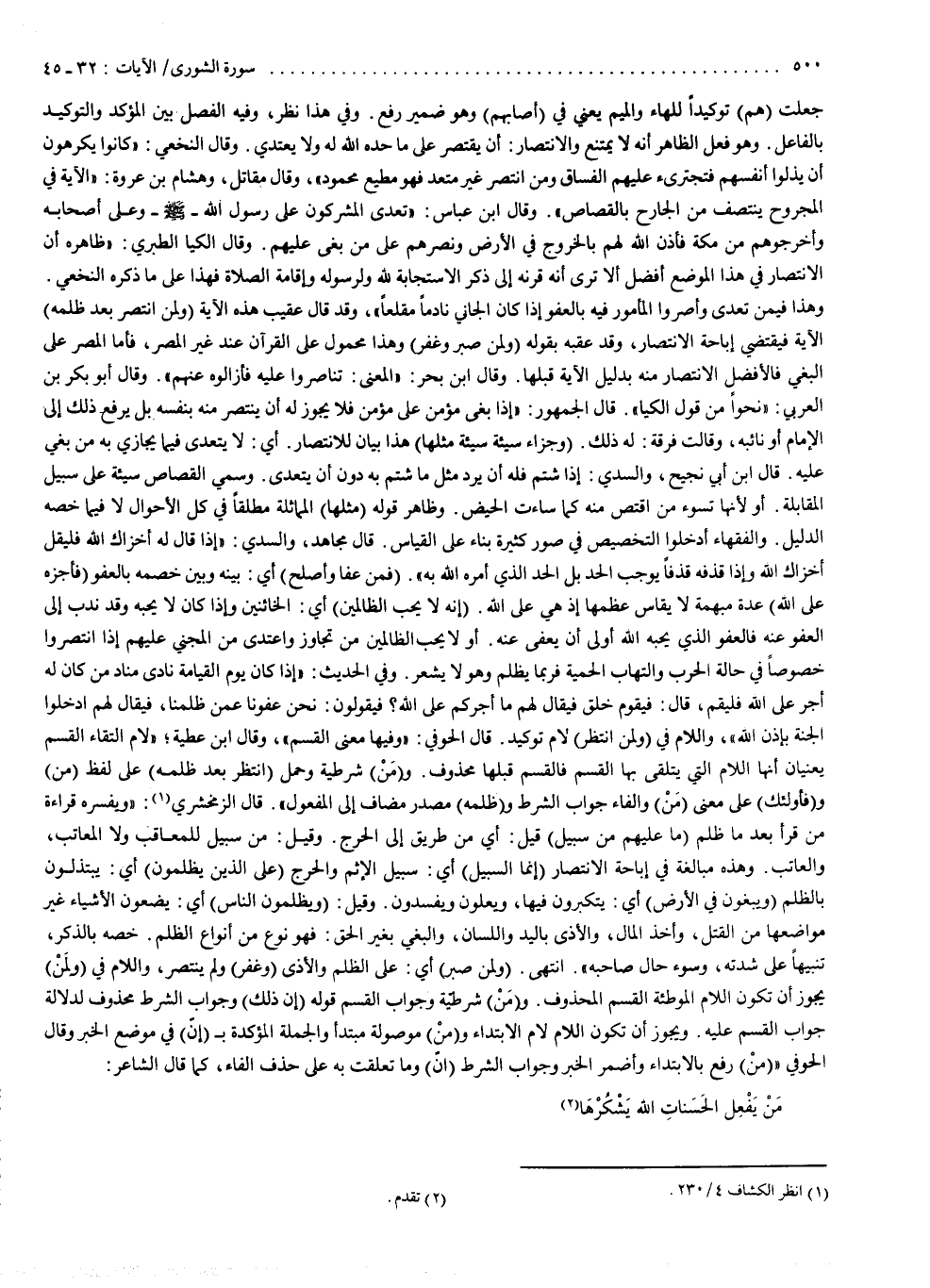
كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 7)
" صفحة رقم 500 "جعلت هم توكيداً للهاء والميم ، يعني في أصابهم ، وهو ضمير رفع ، وفي هذا نظر ، وفيه الفصل بين المؤكد والتوكيد بالفاعل ، وهو فعل الظاهر أنه لا يمتنع ، والانتصار : أن يقتصر على ما حده الله له ولا يتعدى . وقال النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم ، فتجترىء عليهم الفساق ، ومن انتصر غير متعد فهو مطيع محمود . وقال مقاتل ، وهشام عن عروة : الآية في المجروح ينتصف من الجارح بالقصاص . وقال ابن عباس : تعدى المشركون على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) وعلى أصحابه ، وأخرجوهم من مكة ، فأذن الله لهم بالخروج في الأرض ، ونصرهم على من بغى عليهم . وقال الكيا الطبري : ظاهره أن الانتصار في هذا الموضع أفضل ، ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله ولرسوله وإقامة الصلاة ؟ فهذا على ما ذكره النخعي ، وهذا فيمن تعدى وأصر ، والمأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادماً مقلعاً . وقد قال عقيب هذه الآية ) وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ( الآية ، فيقتضي إباحة الانتصار . وقد عقبه بقوله : ) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ( ، وهذا محمول على القرآن عند غير المصر . فأما المصر على البغي ، فالأفضل الانتصار منه بدليل الآية قبلها . وقال ابن بحر : المعنى تناصروا عليه فأزالوه عنهم . وقال أبو بكر بن العربي نحواً من قول الكيا . قال الجمهور : إذا بغى مؤمن على مؤمن ، فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه ، بل يرفع ذلك إلى الإمام أو نائبه . وقالت فرقة : له ذلك .
( وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا ( : هذا بيان للانتصار ، أي لا يتعدى فيما يجازي به من بغى عليه . قال ابن أبي نجييج ، والسدي : إذا شتم ، فله أن يرد مثل ما شتم به دون أن يتعدى ، وسمى القصاص سيئة على سبيل المقابلة ، أو لأنها تسوء من اقتص منه ، كما ساءت الحيض . وظاهر قوله : مثلها المماثلة مطلقاً في كل الأحوال ، لا فيما خصه الدليل . والفقهاء أدخلوا التخصيص في صور كثيرة بناء على القياس . قال مجاهد ، والسدي : إذا قال له أخزاك الله فليقل أخزاك الله ، وإذا قذفه قذفاً يوجب الحد ، بل الحد الذي أمره الله به . ) فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ( : أي بينه وبين خصمه بالعفو ، ( فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ( : عدة مبهمة لا يقاس عظمها ، إذ هي على الله . ) إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( : أي الخائنين ، وإذا كان لا يحبه وقد ندب إلى العفو عنه ، فالعفو الذي يحبه الله أولى أن يعفي عنه ، أو لا يحب الظالمين من تجاوز واعتدى من المجني عليهم ، إذا انتصروا خصوصاً في حالة الحرب والتهاب الحمية ، فربما يظلم وهو لا يشعر . وفي الحديث : ( إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له أجر على الله فليقم ، قال : فيقوم خلق ، فيقال لهم : ما أجركم على الله ؟ فيقولون : نحن عفونا عمن ظلمنا ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن الله ) . واللام في ) وَلَمَنِ انتَصَرَ ( لام توكيد . قال الحوفي : وفيها معنى القسم . وقال ابن عطية : لام التقاء القسم يعنيان أنها اللام التي يتلقى بها القسم ، فالقسم قبلها محذوف ، ومن شرطية ، وحمل ) انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ( على لفظ من ، وفأولئك على معنى من ، والفاء جواب الشرط ، وظلمه مصدر مضاف إلى المفعول . قال الزمخشري : ويفسره قراءة من قرأ : بعد ما ظلم ما عليهم من سبيل ، قيل : أي من طريق إلى الحرج ؛ وقيل : من سبيل للمعاقب ، ولا المعاقب والعاتب ، وهذه مبالغة في إباحة الانتصار . ) إِنَّمَا السَّبِيلُ ( : أي سبيل الإثم والحرج ، ( عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ( : أي يبتذلون بالظلم ، ( وَيَبْغُونَ فِى الاْرْضِ ( : أي يتكبرون فيها ويعلون ويفسدون . وقيل : ويظلمون الناس : أي يضعون الأشياء غير مواضعها من القتل وأخذ المال والأذى باليد واللسان . والبغي بغير الحق ، فهو نوع من أنواع الظلم ، خصه بالذكر تنبيهاً على شدته وسوء حال صاحبه . انتهى . ) وَلَمَن صَبَرَ ( : أي على الظلم والأذى ، ( وَغَفَرَ ( ، ولم ينتصر . واللام في ولمن يجوز أن تكون اللام الموطئة القسم المحذوف ، ومن شرطية ، وجواب القسم قوله : ) إِنَّ ذالِكَ ( ، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه . ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء ، ومن موصولة مبتدأ ، والجملة المؤكدة بأن في موضع الخبر . وقال الحوفي : من رفع بالابتداء وأضمر الخبر ، وجواب الشرط إن وما تعلقت به على حذف الفاء ، كما قال الشاعر : من يفعل الحسنات الله يشكرها