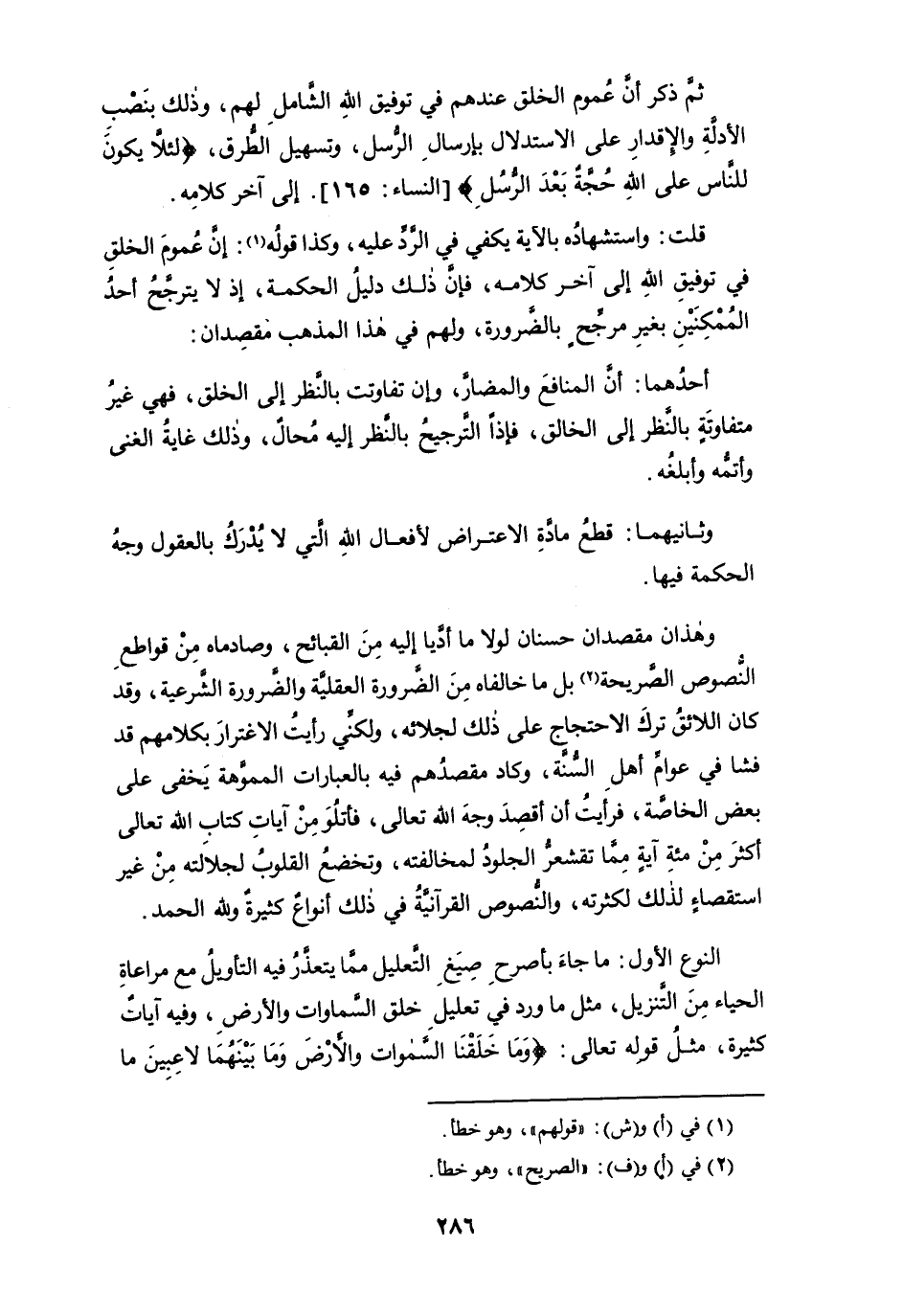
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 7)
ثم ذكر أن عموم الخلق عندهم في توفيق الله الشامل لهم، وذلك بنصب الأدلة والإقدار على الاستدلال بإرسال الرسل، وتسهيل الطرق، {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل} [النساء: 165]. إلى آخر كلامه.قلت: واستشهاده بالآية يكفي في الرد عليه، وكذا قوله (¬1): إن عموم الخلق في توفيق الله إلى آخر كلامه، فإن ذلك دليل الحكمة، إذ لا يترجح أحد الممكنين بغير مرجِّح بالضرورة، ولهم في هذا المذهب مقصدان:
أحدهما: أن المنافع والمضار، وإن تفاوتت بالنظر إلى الخلق، فهي غير متفاوتة بالنظر إلى الخالق، فإذاً الترجيح بالنظر إليه محالٌ، وذلك غاية الغنى وأتمه وأبلغه.
وثانيهما: قطع مادة الاعتراض لأفعال الله التي لا يُدْرَك بالعقول وجه الحكمة فيها.
وهذان مقصدان حسنان لولا ما أدَّيا إليه من القبائح، وصادماه من قواطع النصوص الصريحة (¬2) بل ما خالفاه من الضروره العقلية والضرورة الشرعية، وقد كان اللائق ترك الاحتجاج على ذلك لجلائه، ولكني رأيت الاغترار بكلامهم قد فشا في عوام أهل السنة، وكاد مقصدهم فيه بالعبارات المموَّهة يخفى على بعض الخاصة، فرأيت أن أقصد وجه الله تعالى، فأتلو من آيات كتاب الله تعالى أكثر من مئة آيةٍ مما تقشعر الجلود لمخالفته، وتخضع القلوب لجلالته من غير استقصاءٍ لذلك لكثرته، والنصوص القرآنية في ذلك أنواع كثيرة ولله الحمد.
النوع الأول: ما جاء بأصرح صيغ التعليل مما يتعذر فيه التأويل مع مراعاة الحياء من التنزيل، مثل ما ورد في تعليل خلق السماوات والأرض، وفيه آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا
¬__________
(¬1) في (أ) و (ش): " قولهم "، وهو خطأ.
(¬2) في (أ) و (ف): " الصريح "، وهو خطأ.