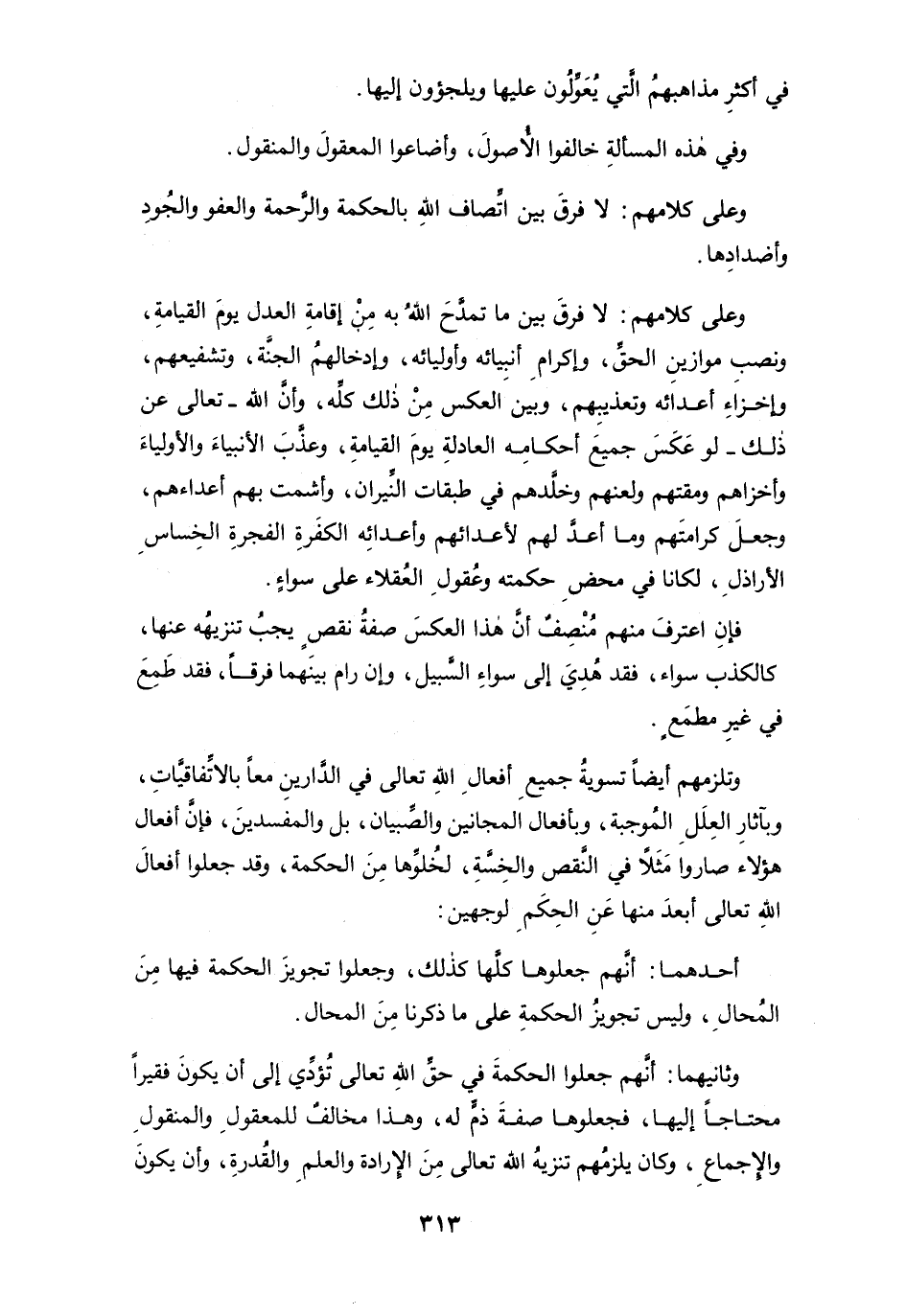
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 7)
في أكثر مذاهبهم التي يُعَوِّلون عليها ويلجؤون إليها.وفي هذه المسألة خالفوا الأصول، وأضاعوا المعقول والمنقول.
وعلى كلامهم: لا فرق بين اتصاف الله بالحكمة والرحمة والعفو والجود وأضدادها.
وعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدَّح الله به من إقامة العدل يوم القيامة، ونصب موازين الحق، وإكرام أنبيائه وأوليائه، وإدخالهم الجنة، وتشفيعهم، وإخزاء أعدائه وتعذيبهم، وبين العكس من ذلك كله، وأن الله -تعالى عن ذلك- لو عكس جميع أحكامه العادلة يوم القيامة، وعذَّب الأنبياء والأولياء وأخزاهم ومقتهم ولعنهم وخلَّدهم في طبقات النِّيران، وأشمت بهم أعداءهم، وجعل كرامتهم وما أعدَّ لهم لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخِساس الأراذل، لكانا في محض حكمته وعقول العقلاء على سواءٍ.
فإن اعترف منهم مُنْصِفٌ أن هذا العكس صفة نقصٍ يجب تنزيهه عنها، كالكذب سواء، فقد هُدِيَ إلى سواء السبيل، وإن رام بينهما فرقاً، فقد طَمِعَ في غير مطمعٍ.
وتلزمهم أيضاً تسوية جميع أفعال الله تعالى في الدارين معاً بالاتِّفاقيَّات، وبآثار العلل الموجبة، وبأفعال المجانين والصِّبيان، بل والمفسدين، فإن أفعال هؤلاء صاروا مثلاً في النقص والخِسَّةِ، لخُلوِّها من الحكمة، وقد جعلوا أفعال الله تعالى أبعد منها عن الحِكَمِ لوجهين:
أحدهما: أنهم جعلوها كلِّها كذلك، وجعلوا تجويز الحكمة فيها من المُحال، وليس تجويز الحكمة على ما ذكرنا من المحال.
وثانيهما: أنهم جعلوا الحكمة في حق الله تعالى تؤدِّي إلى أن يكون فقيراً محتاجاً إليها، فجعلوها صفة ذمٍّ له، وهذا مخالفٌ للمعقول والمنقول والإجماع، وكان يلزمهم تنزيه الله تعالى من الإرادة والعلم والقدرة، وأن يكون