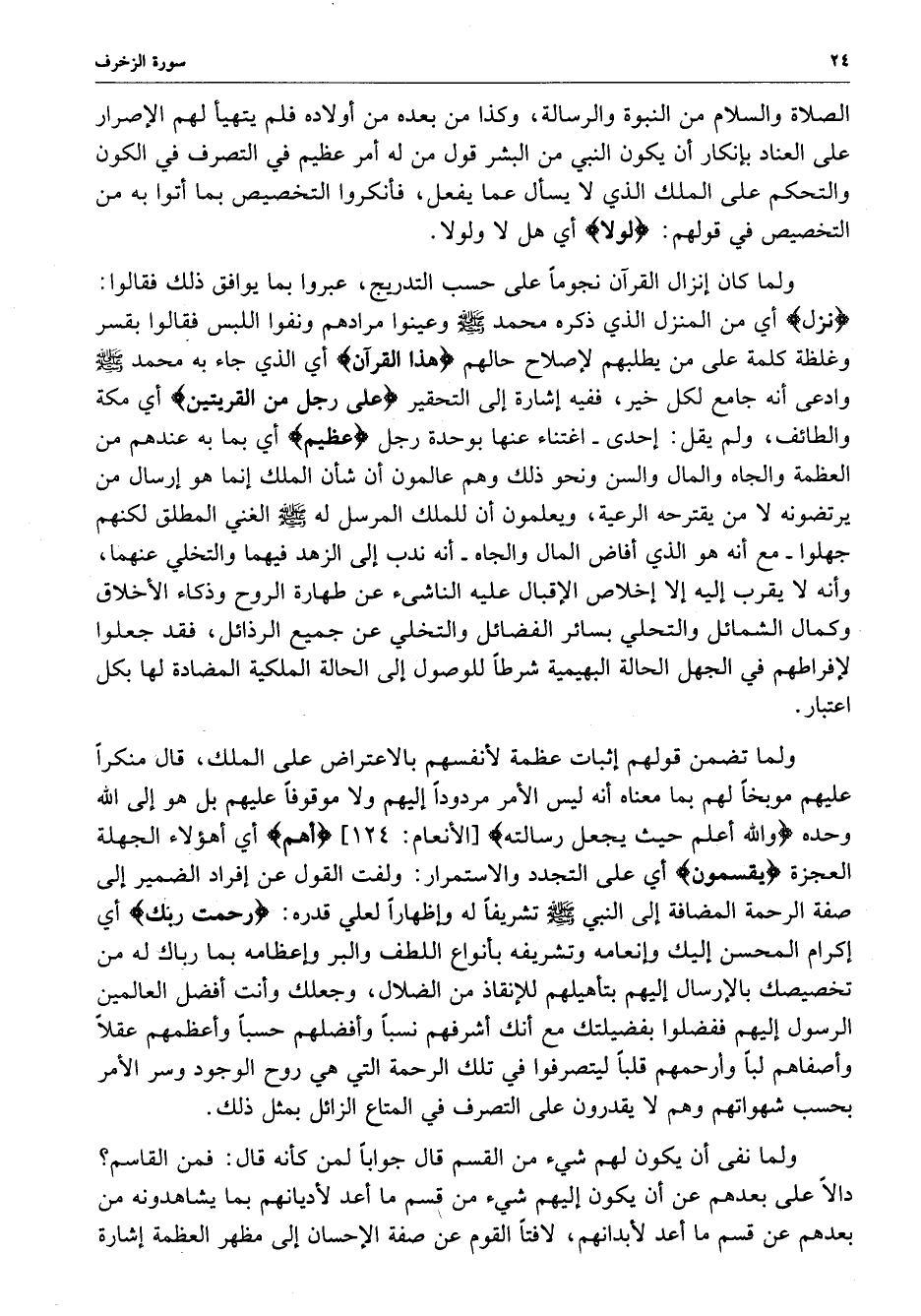
كتاب نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور - العلمية (اسم الجزء: 7)
صفحة رقم 24الصلاة والسلام قبل أن يبدلوه ومن أمر موسى وعيسى عليهما الصلاة والسالم من التوحيد ، زادوا على تلك الغفلة التي أدى إليها البطر بالنعمة ما هو شر من ذلك وهو التكذيب بأن ) قالوا ( مكابرة وعناداً وحسناً وبغياً من غير وقفة ولا تأمل : ( هذا ( مشيرين إلى الحق الذي يطابقه الواقع ، فلا شيء أثبت منه وهو القرآن وغيره مما أتى به من دلائل العرفان ) سحر ) أي خيال لا حقيقة له ، ولما كان الحال مقتضياً من غير شك ولا وقفة لمعرفتهم لما جاء به وإذعانهم له قالوا مؤكدين لمدافعه ما ثبت في النفوس من ذلك : ( وإنا به كافرون ) أي عريقون في ستره بخصوصه حتى لا يعرفه أحد ولا يكون له تابع .
ولما أخبر عن طعنهم في القرآن أتبعه الإخبار عن طعنهم فيمن جاء به تغطية لأمره عملاً بأخبارهم في ختام ما قبلها عن أنفسهم بالكفر زيادة وإمعاناً فيما كانت النعم أدتهم إليه من البطر فقال : ( وقالوا ( لما قهرهم ما ذكروا به مما يعرفونه من أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النبوة والرسالة ، وكذا من بعده من أولاده فلم تيهيأ لهم الإصرار على العناد بإنكار أن يكون النبي من البشر قول من له أمر عظيم في التصرف في الكون والتحكم على الملك الذي لا يسأل عما يفعل ، فأنكروا التخصيص بما أتوا به من التخصيص في قولهم : ( لولا ) أي هل لا ولولا .
ولما كان إنزال القرآن نجوماً على حسب التدريج ، عبروا بما يوافق ذلك فقالوا : ( نزل ) أي من المنوزل الذي ذكره محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وعينوا مرادهم ونفوا اللبس فقالوا بقسر وغلظة كلمة على من يطلبهم لإصلاح حالهم ) هذا القرآن ) أي الذي جاء به محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وادعى أنه جامع لكل خير ، ففيه إشارة إلى التحقير ) على رجل من القريتين ) أي مكة والطائف ، ولم يقل : إحدى - اغتناء عنها بوحدة رجل ) عظيم ) أي بما به عندهم من العظمة والجاه والمال والسن ونحو ذلك وهم عالمون أن شأن الملك إنما هو إرسال من يرتضونه لا من يقترحه الرعية ، ويعلمون أن للملك المرسل له ( صلى الله عليه وسلم ) الغني المطلق لكنهم جهلوا - مع أنه هو الذي أفاض المال والجاه - أنه ندب إلى الزهد فيهما والتخلي عنهما ، وأنه لا يقرب إليه إلا إخلاص الإقبال عليه الناشئ عن طهارة الروح وذكاء الأخلاق وكمال الشمائل والتحلي بسائر الفضائل والتخلي عن جميع الرذائل ، فقد جعلوا لإفراطهم في الجهل الحالة البهيمية شرطاً للوصول إلى الحالة الملكية المضادة لها بكل اعتبار .
ولما تضمن قولهم إثبات عظمة لأنفسهم بالاعتراض على الملك ، قال منكراً عليهم موبخاً لهم بما معناه أنه ليس الأمر مردوداً إليهم ولا موقوفاً عليهم بل هو إلى الله وحده
77 ( ) والله أعلم حيث يجعل رسالته ( ) 7
[ الأنعام : 124 ] ) أهم ) أي أهؤلاء الجهلة العجزة ) يقسمون ) أي على التجدد والاستمرار : ولفت القول عن إفراد الضمير إلى صفة الرحمة المضافة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تشريفاً له وإظهاراً لعلي قدره : ( رحمت ربك ) أي إكرام المحسن إليك وإنعامه وتشريفه بأنواع اللطف والبر وإعظامه بما رباك له من تخصيصك بالإرسال إليهم بتأهيلهم للإنقاذ من الضلال ، وجعلك وأنت ألفضل العالمين الرسول إليهم ففضلوا بفضيلتك مع أنك أشرفهم نسباً وأفضلهم حسباً وأعظمهم عقلاً وأصفاهم لباً وأرحمهم قلباً ليتصرفوا في تلك الرحمة التي هي روح الوجود وسر الأمر بحسب شهواتهم وهم لا يقدرون على التصرف المتاع الزائل بمثل ذلك .
ولما نفى أن يكون لهم شيء من القسم قال جواباً لمن كأنه قال : فمن القاسم ؟ دالاً على بعدهم عن أن يكون إليهم شيء ن قسم ما أعد لأديانهم بما يشاهدونه من بعدهم عن قسم ما أعد لأبدانهم ، لافتاً القوم عن صفة الإحسان إلى مظهر العظمة إشارة