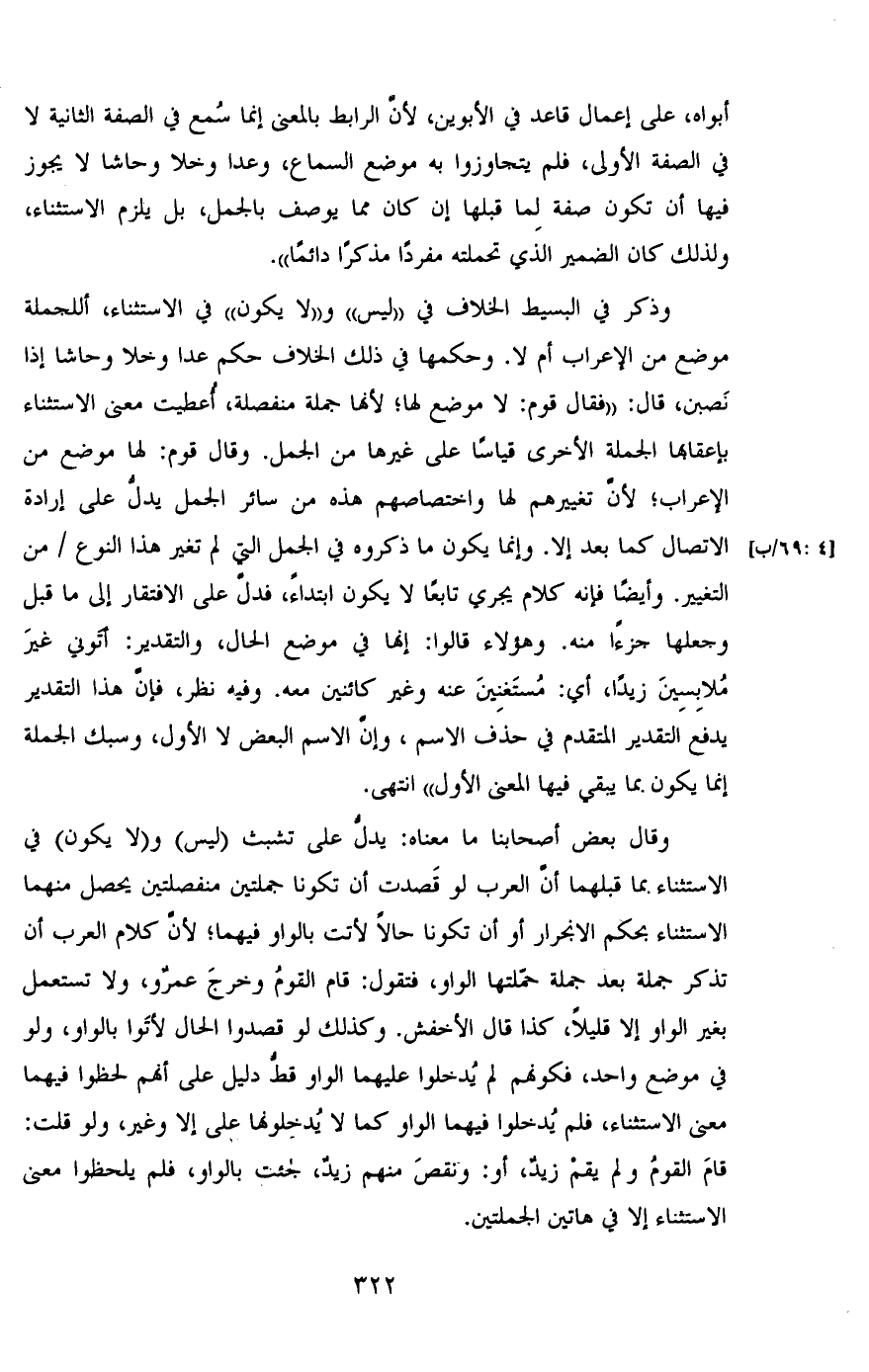
كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 8)
أبواه، على إعمال قاعد في الأبوين، لأن الرابط بالمعنى إنما سُمع في الصفة الثانية لا في الصفة الأولى، فلم يتجاوزوا به موضع السماع، وعدا وخلا وحاشا لا يجوز فيها أن تكون صفة لما قبلها إن كان مما يوصف بالجمل، بل يلزم الاستثناء، ولذلك كان الضمير الذي تحملته مفردًا مذكرًا دائمًا".وذكر في البسيط الخلاف في "ليس" و"لا يكون" في الاستثناء، الجملة موضع من الإعراب أم لا. وحكمها في ذلك الخلاف حكم عدا وخلا وحاشا إذا نصبن، قال: "فقال قوم: لا موضع لها؛ لأنها جملة منفصلة، أُعطيت معنى الاستثناء بإعقابها الجملة الأخرى قياسًا على غيرها من الجمل. وقال قوم: لها موضع من الإعراب؛ لأن تغييرهم لها واختصاصهم هذه من سائر الجمل يدل على إرادة الاتصال كما بعد إلا. وإنما يكون ما كروه في الجمل التي لم تغير هذا النوع / [٤: ٩٦/ ب] من التغيير. وأيضًا فإنه كلام يجري تابعًا لا يكون ابتداءً، فدل على الافتقار إلى ما قبل وجعلها جزءًا منه. وهؤلاء قالوا: إنها في موضع الحال، والتقدير: أتوني غير مُلابسين زيدًا، أي: مستغنين عنه وغير كائنين معه. وفيه نظر، فإن هذا التقدير يدفع التقدير المتقدم في حذف الاسم، وإن الاسم البعض لا الأول، وسبك الجملة إنما يكون بما يبقي فيها المعنى الأول" انتهى.
وقال بعض أصحابنا ما معناه: يدل على تشبث (ليس) و (لا يكون) في الاستثناء بما قبلهما أن العرب لو قصدت أن تكونا جملتين منفصلتين يحصل منهما الاستثناء بحكم الانجرار أو أن تكونا حالًا لأتت بالواو فيهما؛ لأن كلام العرب أن تذكر جملة بعد جملة حملتها الواو، فتقول: قام القوم وخرج عمروٌ، ولا تستعمل بغير الواو إلا قليلًا، كذا قال الأخفش. وكذلك لو قصدوا الحال لأتوا بالواو، ولو في موضع واحد، فكونهم لم يُدخلوا عليهما الواو قط دليل على أنهم لحظوا فيهما معنى الاستثناء، فلم يُدخلوا فيهما الواو كما لا يُدخلونها على إلا وغير، ولو قلت: قام القوم ولم يقم زيدٌ، أو: ونقص منهم زيدٌ، لجئت بالواو، فلم يلحظوا معنى الاستثناء إلا في هاتين الجملتين.