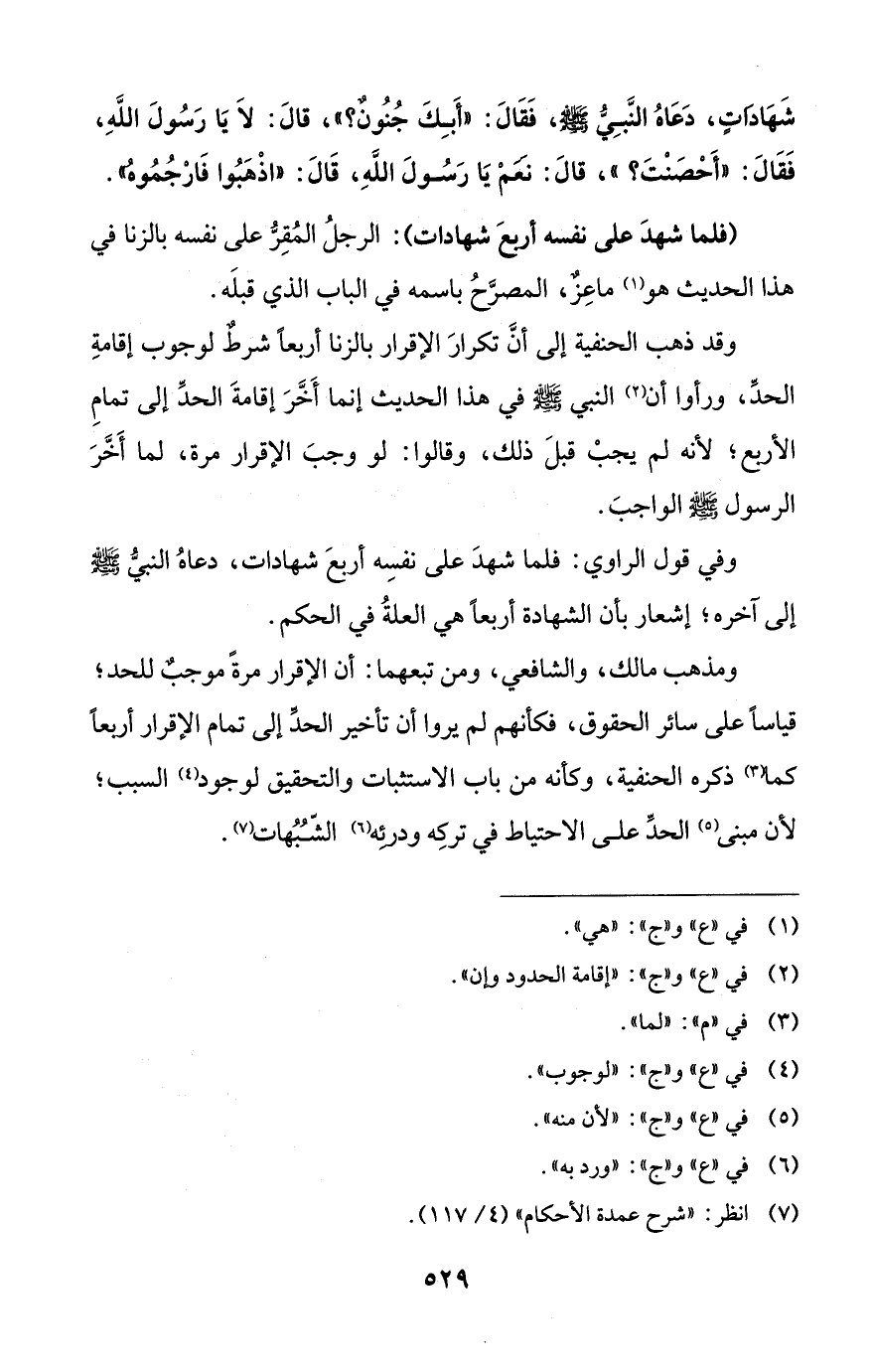
كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)
شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "أَحْصَنْتَ؟ "، قالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ".(فلما شهدَ على نفسه أربعَ شهادات): الرجلُ المُقِرُّ على نفسه بالزنا في هذا الحديث هو (¬1) ماعِزٌ، المصرَّحُ باسمه في الباب الذي قبلَه.
وقد ذهب الحنفية إلى أنَّ تكرارَ الإقرار بالزنا أربعاً شرطٌ لوجوب إقامةِ الحدِّ، ورأوا أن (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إنما أَخَّرَ إقامةَ الحدَّ إلى تمامِ الأربع؛ لأنه لم يجبْ قبلَ ذلك، وقالوا: لو وجبَ الإقرار مرة، لما أَخَّرَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الواجبَ.
وفي قول الراوي: فلما شهدَ على نفسِه أربعَ شهادات، دعاهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره؛ إشعار بأن الشهادة أربعاً هي العلةُ في الحكم.
ومذهب مالك، والشافعي، ومن تبعهما: أن الإقرار مرةً موجبٌ للحد؛ قياساً على سائر الحقوق، فكأنهم لم يروا أن تأخير الحدِّ إلى تمام الإقرار أربعاً كما (¬3) ذكره الحنفية، وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود (¬4) السبب؛ لأن مبنى (¬5) الحدِّ على الاحتياط في تركِه ودرئِه (¬6) الشُّبُهات (¬7).
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "هي".
(¬2) في "ع" و"ج": "إقامة الحدود وإن".
(¬3) في "م": "لما".
(¬4) في "ع" و"ج": "لوجوب".
(¬5) في "ع" و"ج": "لأن منه".
(¬6) في "ع" و"ج": "ورد به".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (4/ 117).