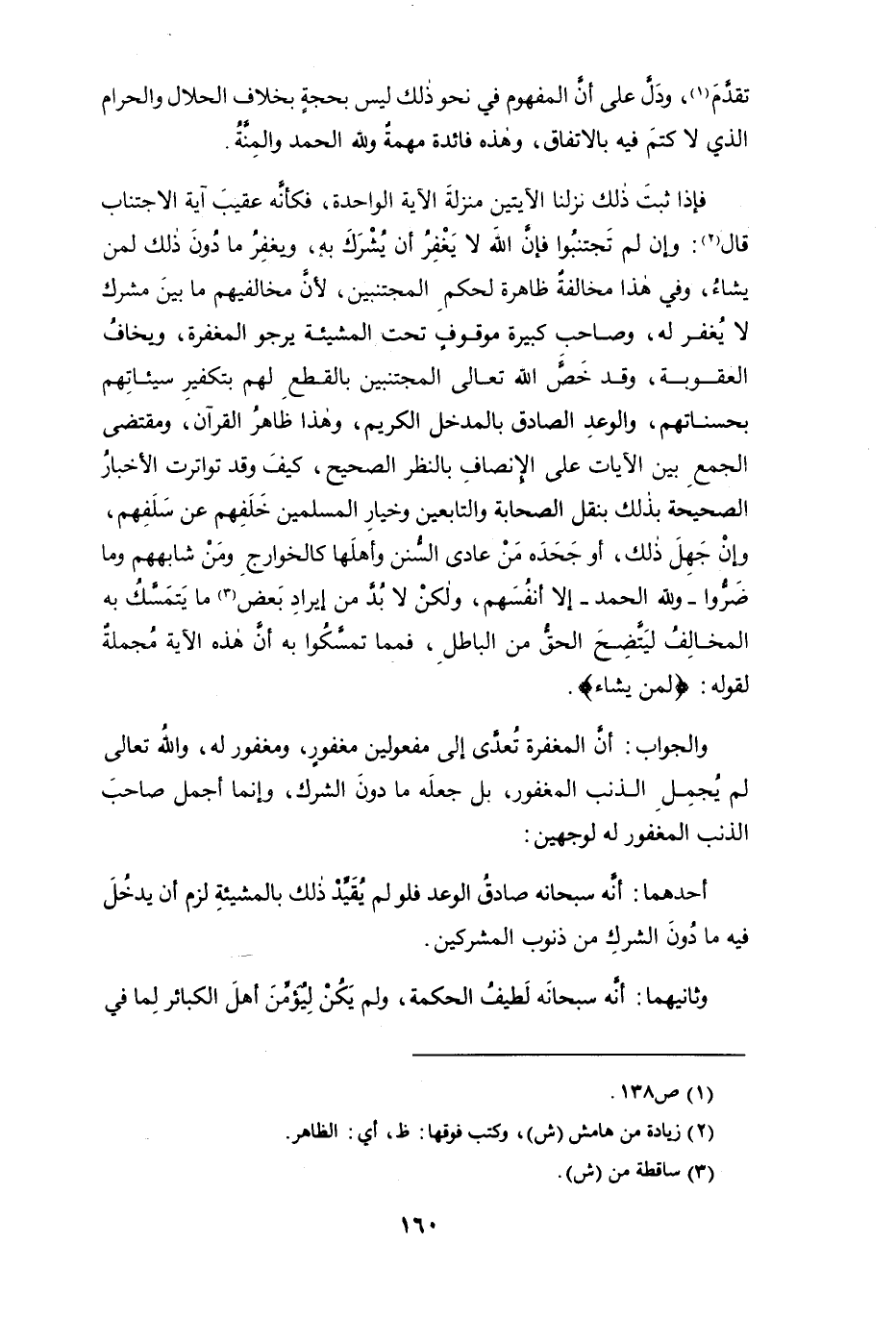
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 9)
تقدم (¬1)، ودل على أن المفهوم في نحو ذلك ليس بحجةٍ بخلاف الحلال والحرام الذي لا كتم فيه بالاتفاق، وهذه فائدة مهمةٌ ولله الحمد والمِنَّةُ.فإذا ثبت ذلك نزلنا الآيتين منزلة الآية الواحدة، فكأنه عقيب آية الاجتناب قال (¬2): وإن لم تجتنبوا فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي هذا مخالفةٌ ظاهرة لحكم المجتنبين، لأن مخالفيهم ما بين مشرك لا يُغفر له، وصاحب كبيرة موقوفٍ تحت المشيئة يرجو المغفرة، ويخاف العقوبة، وقد خصَّ الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم بحسناتهم، والوعد الصادق بالمدخل الكريم، وهذا ظاهر القرآن، ومقتضى الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح، كيف وقد تواترت الأخبارُ الصحيحة بذلك بنقل الصحابة والتابعين وخيار المسلمين خَلَفِهم عن سلفهم، وإن جَهِلَ ذلك، أو جَحَدَه من عادى السُّنن وأهلها كالخوارج ومن شابههم وما ضَرُّوا -ولله الحمد- إلاَّ أنفُسَهم، ولكن لا بد من إيراد بعض (¬3) ما يتمسك به المخالف ليتضح الحقُّ من الباطل، فمما تمسكوا به أن هذه الآية مجملةٌ لقوله: {لمن يشاء}.
والجواب: أن المغفرة تُعدَّى إلى مفعولين مغفورٍ، ومغفور له، والله تعالى لم يُجمِلِ الذنب المغفور، بل جعله ما دون الشرك، وإنما أجمل صاحب الذنب المغفور له لوجهين:
أحدهما: أنه سبحانه صادق الوعد فلو لم يُقَيِّدْ ذلك بالمشيئة لزم أن يدخل فيه ما دون الشرك من ذنوب المشركين.
وثانيهما: أنه سبحانه لطيفُ الحكمة، ولم يكن لِيُؤَمِّنَ أهلَ الكبائر لما في
¬__________
(¬1) ص 138.
(¬2) زياده من هامش (ش)، وكتب فوقها: ظ، أي: الظاهر.
(¬3) ساقطة من (ش).