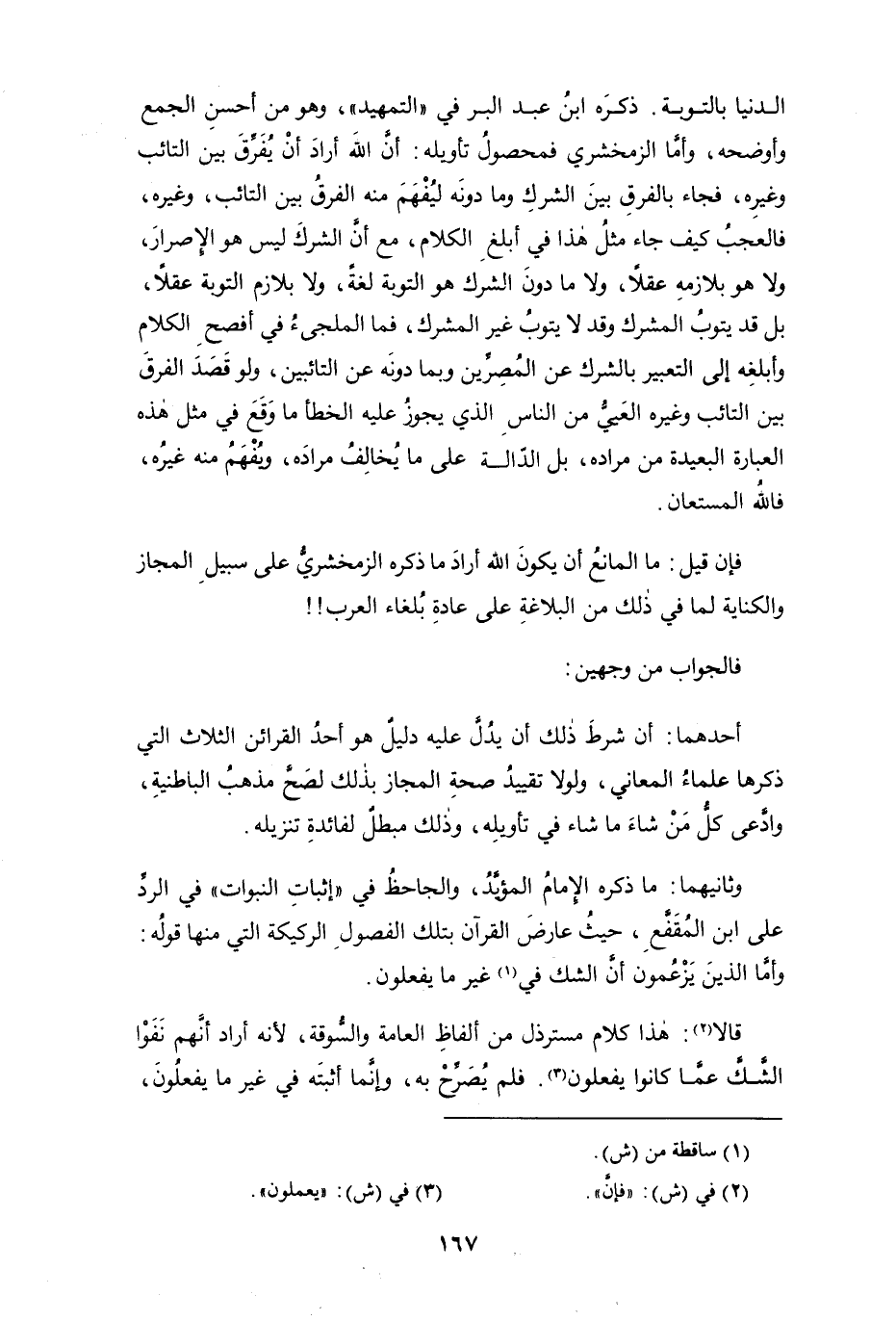
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 9)
الدنيا بالتوبة. ذكره ابن عبد البر في " التمهيد "، وهو من أحسن الجمع وأوضحه، وأما الزمخشري فمحصول تأويله: أن الله أراد أن يُفَرِّقَ بين التائب وغيره، فجاء بالفرق بين الشرك وما دونه ليُفْهَمَ منه الفرق بين التائب، وغيره، فالعجبُ كيف جاء مثلُ هذا في أبلغ الكلام، مع أن الشرك ليس هو الإصرار، ولا هو بلازمهِ عقلاً، ولا ما دون الشرك هو التوبة لغةً، ولا بلازم التوبة عقلاً، بل قد يتوب المشرك وقد لا يتوب غير المشرك، فما الملجىءُ في أفصح الكلام وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُصِرِّين وبما دونه عن التائبين، ولو قصد الفرقَ بين التائب وغيره العَييُّ من الناس الذي يجوز عليه الخطأ ما وقع في مثل هذه العبارة البعيدة من مراده، بل الدَّالة على ما يُخالِفٌ مراده، ويُفْهَمُ منه غيره، فالله المستعان.فإن قيل: ما المانعُ أن يكون الله أراد ما ذكره الزمخشري على سبيلِ المجاز والكناية لما في ذلك من البلاغة على عادةِ بُلغاء العرب!!
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن شرط ذلك أن يدل عليه دليلٌ هو أحدُ القرائن الثلاث التي ذكرها علماء المعاني، ولولا تقييد صحة المجاز بذلك لصحَّ مذهب الباطنية، وادعى كل من شاء ما شاء في تأويله، وذلك مبطلٌ لفائدة تنزيله.
وثانيهما: ما ذكره الإمام المؤيَّدُ، والجاحظ في " إثبات النبوات " في الرد على ابن المُقَفَّع، حيث عارضَ القرآن بتلك الفصول الركيكة التي منها قوله: وأما الذين يزعمون أن الشك في (¬1) غير ما يفعلون.
قالا (¬2): هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسُّوقة، لأنه أراد أنهم نَفَوْا الشكَّ عما كانوا يفعلون (¬3). فلم يُصَرِّحْ به، وإنما أثبته في غير ما يفعلون،
¬__________
(¬1) ساقطة من (ش).
(¬2) في (ش): " فإن ".
(¬3) في (ش): " يعملون ".