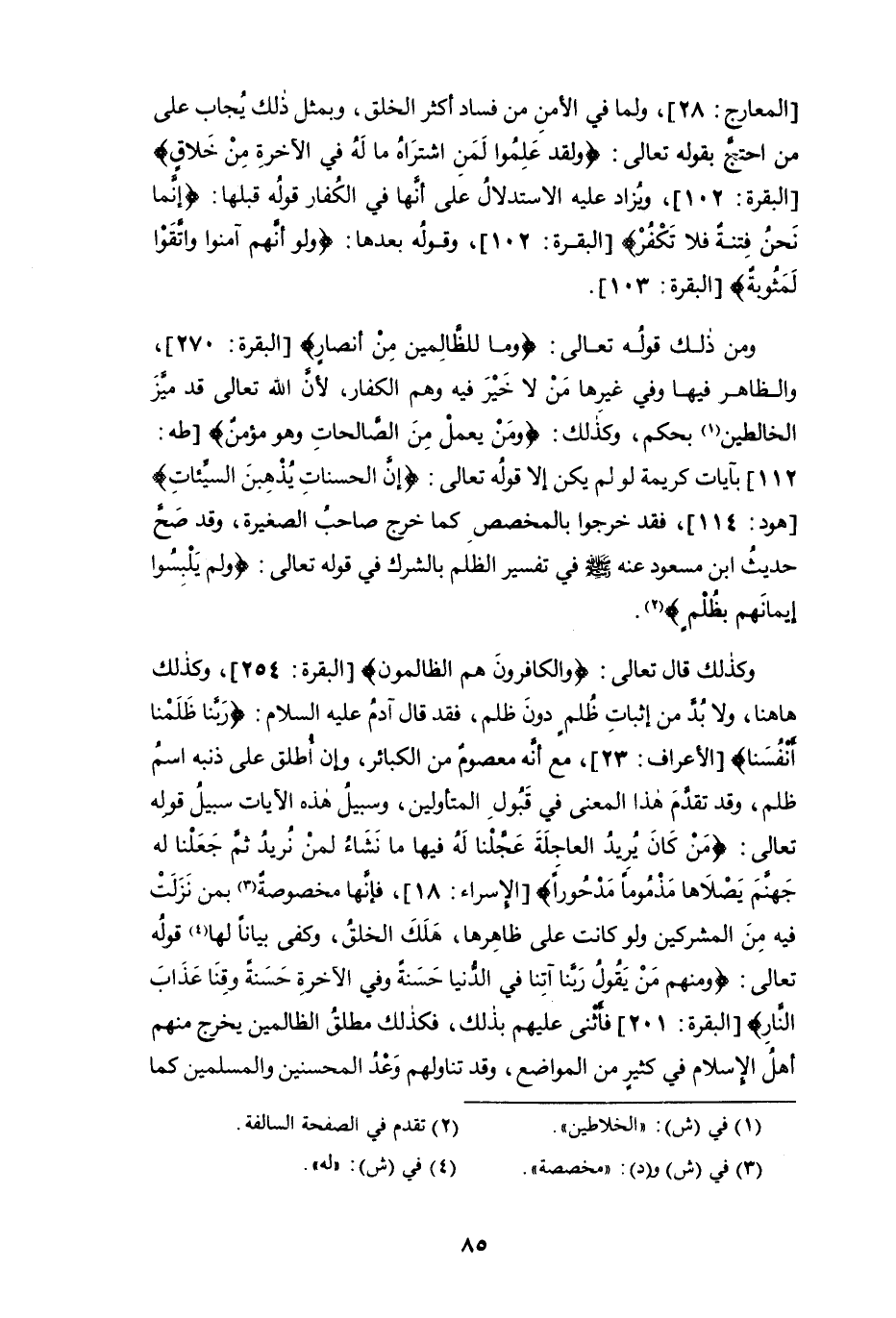
كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 9)
[المعارج: 28]، ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق، وبمثل ذلك يُجاب على من احتجَّ بقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: 102]، ويُزاد عليه الاستدلال على أنها في الكفار قوله قبلها: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر} [البقرة: 102]، وقوله بعدها: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَة} [البقرة: 103].ومن ذلك قوله تعالى: {وما للظالمين من أنصارٍ} [البقرة: 270]، والظاهر فيها وفي غيرها من لا خير فيه وهم الكفار، لأنَّ الله تعالى قد ميَّزَ الخالطين (¬1) بحكم، وكذلك: {ومَنْ يعملْ مِنَ الصالحات وهو مؤمنٌ} [طه: 112] بآيات كريمة لو لم يكن إلاَّ قوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]، فقد خرجوا بالمخصص كما خرج صاحب الصغيرة، وقد صح حديث ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى: {ولم يلبسوا إيمانَهم بظُلْمٍ} (¬2). وكذلك قال تعالى: {والكافرون هم الظالمون} [البقرة: 254]، وكذلك ها هنا، ولا بُدَّ من إثبات ظلمٍ دون ظلم، فقد قال آدم عليه السلام: {ربَّنا ظلمنا أنفسنا} [الأعراف: 23]، مع أنه معصومٌ من الكبائر، وإن أُطلق على ذنبه اسم ظلم، وقد تقدَّمَ هذا المعنى في قبول المتأولين، وسبيل هذه الآيات سبيلُ قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا} [الإسراء: 18]، فإنها مخصوصةٌ (¬3) بمن نزلت فيه من المشركين ولو كانت على ظاهرها، هَلَكَ الخلق، وكفى بياناً لها (¬4) قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] فأثنى عليهم بذلك، فكذلك مطلق الظالمين يخرج منهم أهل الإسلام في كثيرٍ من المواضع، وقد تناولهم وَعْدُ المحسنين والمسلمين كما
¬__________
(¬1) في (ش): " الخلاطين ".
(¬2) تقدم في الصفحة السالفة.
(¬3) في (ش) و (د): " مخصصة ".
(¬4) في (ش): " له ".