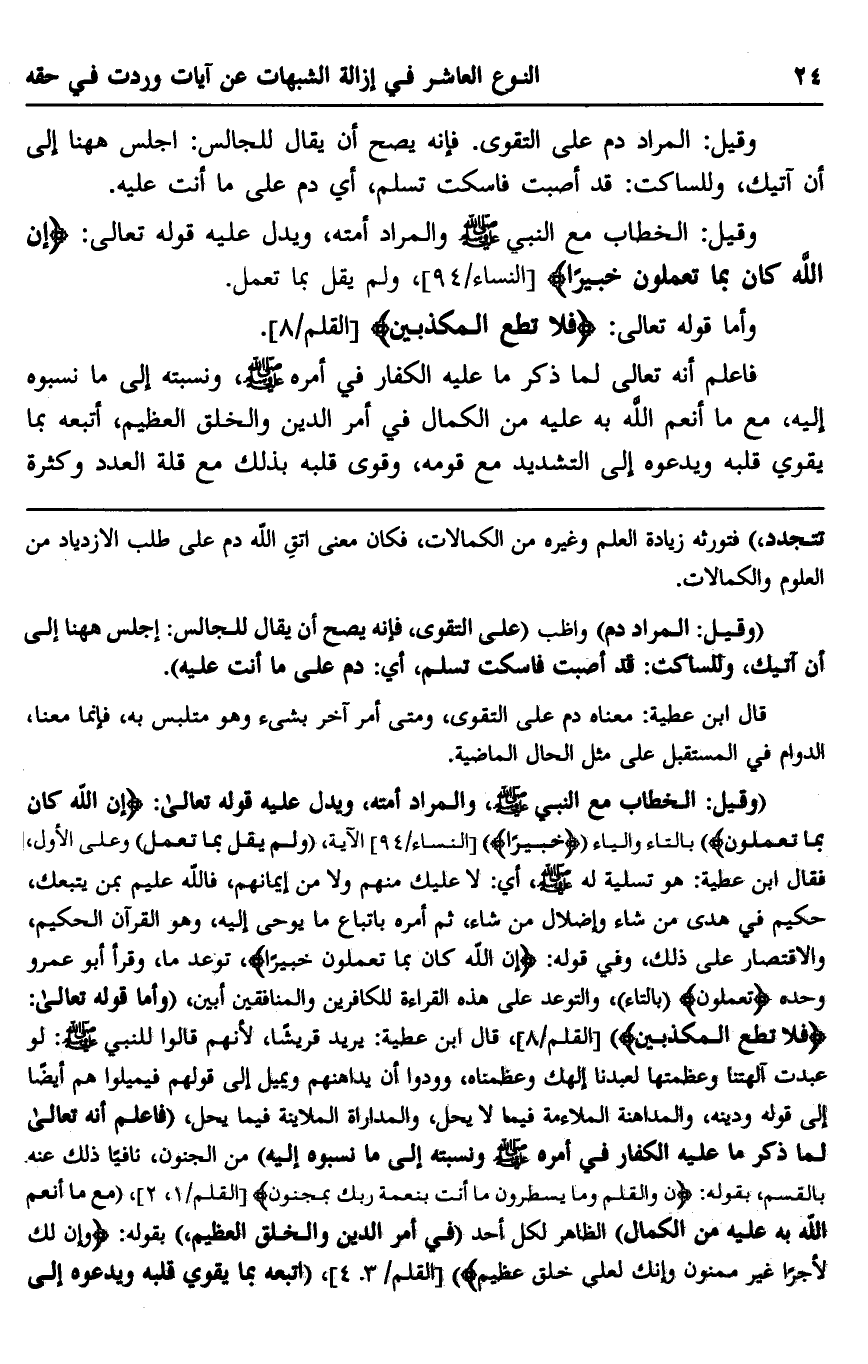
كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 9)
وقيل: المراد دم على التقوى. فإنه يصح أن يقال للجالس: أجلس ههنا إلى أن آتيك، وللساكت: قد أصبت فاسكت تسلم، أي دم على ما أنت عليه.وقيل: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ويدل عليه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 94] ولم يقل بما تعمل.
وأما قوله تعالى: {فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 8] .
فاعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار في أمره صلى الله عليه وسلم، ونسبته إلى ما نسبوه إليه، مع ما أنعم الله به عليه من الكمال في أمر الدين والخلق العظيم، أتبعه بما يقوي قلبه ويدعوه إلى التشديد مع قومه، وقوي قلبه بذلك مع قلة العدد وكثرة
__________
تتجدد" فلتورثه زيادة العلم وغيره من الكمالات، فكان معنى اتقِ الله دم على طلب الازدياد من العلوم والكمالات.
"وقيل: المراد دم" واظب "على التقوى، فإنه يصح أن يقال للجالس: إجلس ههنا إلى أن آتيك، وللساكت: قد أصبت فاسكت تسلم، أي: دم على ما أنت عليه".
قال ابن عطية: معناه دم على التقوى، ومتى أمر آخر بشيء وهو ملتبس به، فإنما منا، الدوام في المستقبل على مثل الحال الماضية.
"وقيل: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ويدل عليه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ} بالتاء والياء {خَبِيرًا} [النساء: 94] الآية، "ولم يقل بما تعمل" وعلى الأول، فقال ابن عطية: هو تسلية له صلى الله عليه وسلم، أي: لا عليك منهم ولا من إيمانهم، فالله عليم بمن يتبعك، حكيم في هدى من شاء وإضلال من شاء، ثم أمره باتباع ما يوحى إليه، وهو القرآن الحكيم، والاقتصار على ذلك وفي قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} ، توعد ما، وقرأ أبو عمرو وحده {تَعْمَلُونَ} "بالتاء"، والتوعد على هذه القراءة للكافرين والمنافقين أبين، وأما قوله تعالى: {فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 8] ، قال ابن عطية: يريد قريشًا، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو عبدت آلهتنا وعظمتها لعبدنا إلهك وعظمناه، وودوا أن يداهنهم ويميل إلى قولهم فليميلوا هم أيضًا إلى قوله ودينه، والمداهنة الملاءمة فيما لا يحل، والمداراة الملاينة فيما يحل "فاعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار في أمره صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى ما نسبوه إليه" من الجنون، نافيًا ذلك عنه بالقسم، بقوله: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ} [القلم: 1، 2] ، "مع ما أنعم الله به عليه من الكمال" الظاهر لكل أحد "في أمر الدين والخلق العظيم"، بقوله: {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 3، 4] ، "ابتعه بما يقوي قلبه ويدعوه إلى